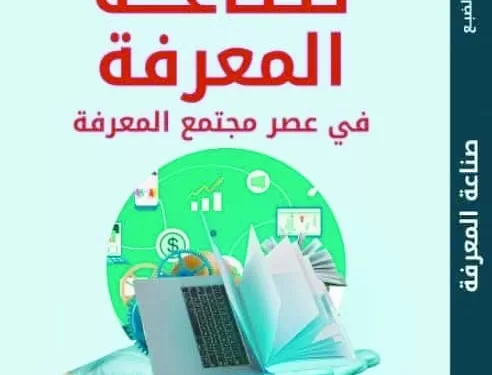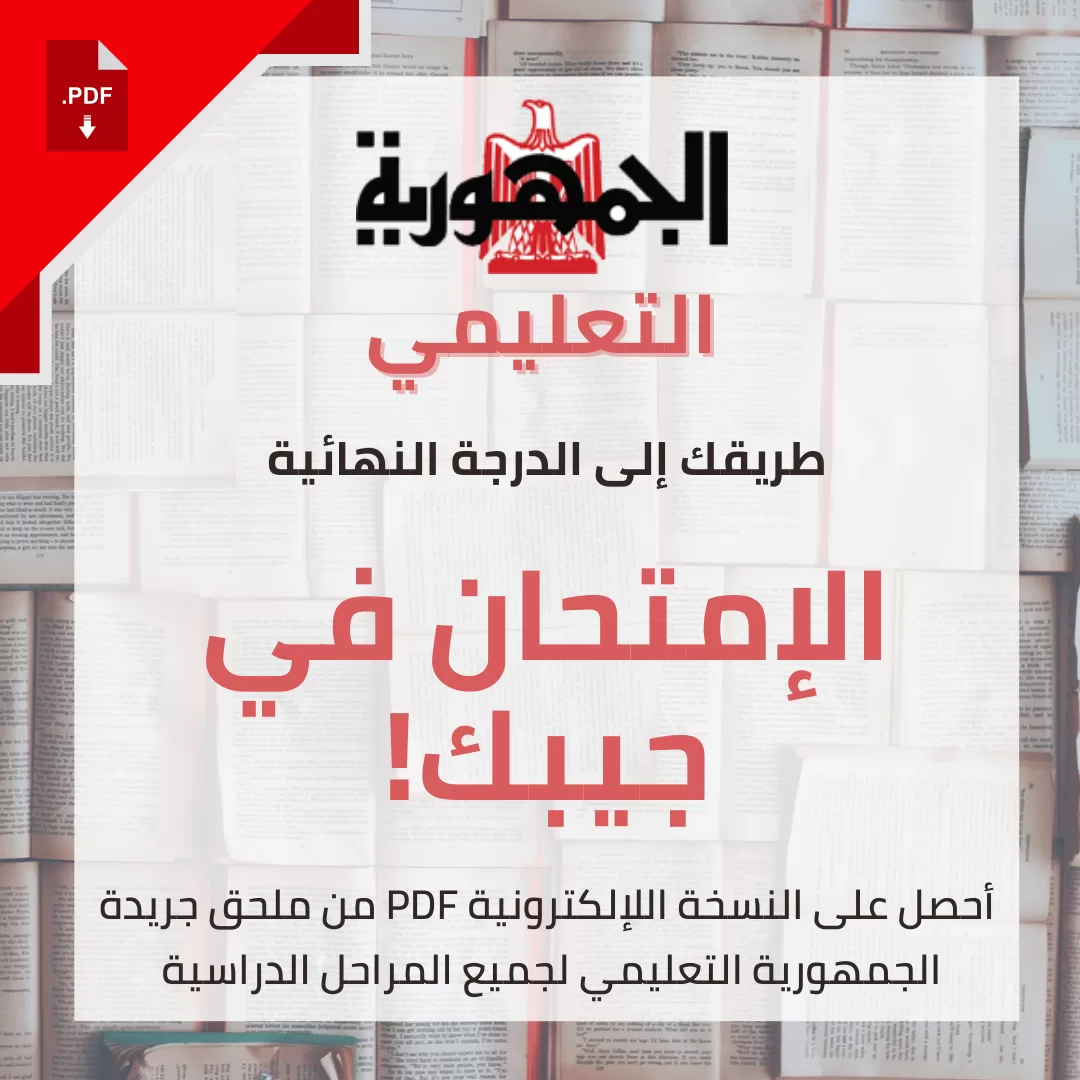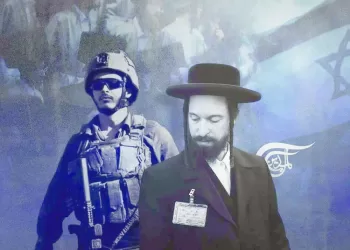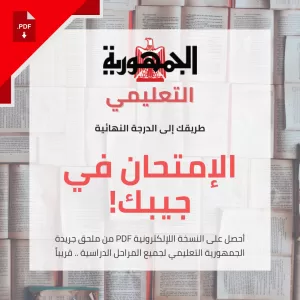تزخر الساحة الثقافية بوجه عام فى مصر بعدد كبير من الأسماء البارزة من الأكاديميين والباحثين لكن يظل اسم الناقد أ. د محمود الضبع له وقع خاص ومساحة مختلفة لما يقدمه دائما من خصوصية فى طرح رؤاه ومن سبق لجيله فى اتجاه المستقبل والقفز بوعى إلى الأمام يعمل الضبع أستاذا للنقد الأدبى الحديث، وترأس مؤخرا عمادة كلية الآداب جامعة قناة السويس، وكان قد تولى من قبل عددا من المناصب منها رئيس «الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق « و»نائب رئيس هيئة الكتاب « ومدير التحرير والنشر بالمركز القومى للترجمة وقد صدر له عدد من الكتب الهامة نذكر منها: «مساءلة العقل العربى» و«الثقافة والهوية والتكنولوجيا» ، شارك بالعضوية فى الكثير من لجان تحكيم جوائز أدبية كبرى فيما حصل على عدة جوائز وتكريمات منها جائزة «طه حسين فى النقد الأدبى».
> هل لدينا الآن ما يمكن اعتباره قوة ناعمة جديدة فى الأدب؟
> > الآداب والفنون فى حد ذاتها قوة ناعمة، تستطيع القيام بأدوار لا تستطيعها القوى الصلبة، وبالتالى فما دام لدينا نتاج أدبي، إذا ستظل هناك قوى ناعمة تمارس دورها، أما عن مسألة الجدة من عدمه، فذلك يرتبط بالقضية والموضوع والمعنى فى حد ذاته، ومن واقع اطلاعى على المشهد المصرى إجمالا، سواء بالقراءة الطوعية التى تخضع للاختيار الحر ويمكن التوقف عن الاستمرار فيها إذا لم يكن العمل جيدا، أو القراءة الإجبارية التى تخضع لاعتبارات التحكيم وكتابة التقارير من أجل الجوائز أو النشر وخلافه.. من خلال هذا الاطلاع يمكن التأكيد على أن الكتابة الإبداعية المصرية لديها ما يستحق التقدير والإشادة حتى بعد الانفجار الذى تشهده الكتابة العربية إجمالا.
> من واقع اهتمامك بالهوية الثقافية، هل ترى إننا نستطيع فعلا الحفاظ على هويتنا فى ظل العولمة والمتغيرات التى نواجهها؟
> >الهوية موضوع معقد، دراستى له بدأت أواخر التسعينات وأوائل الألفية الثالثة، وعلى الرغم من الكتب والدراسات والمقالات التى قدمتها فيه، إلا أنه يزداد تشابكا كلما تعمقت فيه، لكن فى الإجمال يمكن القول بأنه على الرغم من مخاطر العولمة فى تأثيراتها السلبية على الهوية، إلا أن الهوية المصرية ستظل صامدة أطول من أى هوية أخرى فى المنطقة وذلك يعود لتعدد تفاصيلها ومنمنماتها من جهة، ولانتشارها عبر أقاليم مصر وقراها البعيدة عن المركز من جهة ثانية، ولصلابة بعض مفرداتها من جهة ثالثة، وأخيرا لتنوعها شديد الثراء تاريخيا واجتماعيا ودينيا وعلى مستوى الصناعات الثقافية والحرفية واليدوية إلى آخره.
> من خلال رؤيتك هل يميل الشباب للانفتاح على ثقافات أخرى حد الذوبان بها أم متمسك بتراثه وهويته؟
> >العالم بأكمله يعانى من السيولة التى فرضتها صيغ التكنولوجيا المعاصرة على الحياة، هذه السيولة هى المتسبب الأول فى صور الذوبان التى يعيشها العالم، وبالنسبة للواقع المصرى فإن ذوبان الشباب فى الهوية العولمية أمر متحقق بقوة، غير أنه نظرا للتنوع الشديد فى أبعاد هويتنا المصرية، لذا فإنه ما يزال أمامنا الكثير مما يمكن الحفاظ عليه، لكن بشرط أساسى لا يمكن الاستغناء عنه أو التفاوض فيه، وهو وضع سياسة ثقافية واضحة المعالم والأهداف، تدمج بين التعليم والثقافة والوعى فى مكون واحد.
> مناهج وسياسات التعليم الجديدة، كيف أثرت على اقسام كلية الآداب، وهل هناك أقسام سوف تتأثر من ناحية إقبال الطلاب عليها؟
> >تشهد كليات الآداب إجمالا تحولا فى أقسامها التعليمية نتيجة لتحولها إلى نظم البرامج والدبلومات المهنية والمتخصصة (إلى جانب النظم القديمة)، وهو ما أوجد تخصصات متطورة مثل الترجمة الفورية فى الإنجليزية والفرنسية، واللغويات التطبيقية، والنظم الجغرافية والاستشعار عن بعد، إضافة للبرامج البينية (التى تجمع تخصصات مختلفة)، وكل ذلك أحدث تحولات أدت لتباين الإقبال على الأقسام، والإعراض نسبيا عن الأقسام القديمة.
> فى الماضى تخرج عظماء مثل طه حسين من كليات الآداب، أين دور هذه الكليات الآن فى إعداد نماذج ثقافية كبيرة؟
> >علينا أن ننتبه أن مفهوم النموذج الثقافى قد اختلفت جذريا، فبعد أن كانت الحياة تخضع للنمط الواحد والنظرية الواحدة والنموذج الواحد، جاءت فلسفات التفكيك والعولمة وأخيرا السيولة، لتفتت كل أحادية صلبة وتهدم مفهوم البطل والعظيم الذى يصنع شيئا ذا قيمة للمجتمع، وتعتمد بدلا عنه مفهوم النجومية والترند وغيرها مما يخضع لسلطة تلقى المجتمع وهيمنة «نظام التفاهة» كما أطلق عليه آلان دونو، وبالتالى لم تعد الحياة الآن تبحث عن النموذج الثقافى والمفكر والفيلسوف، وإنما تبحث عن النجم الذى يستطيع أن يصنع الترند ويجمع حوله ملايين البشر دون أن يقول شيئا ذا قيمة على الإطلاق..
هنا ستضيع كل النماذج المتميزة والجادة من الخريجين فى زحام كل ذلك، لكن لن ينتفى وجودهم، لأننا إذا حللنا الواقع الثقافى سنجد كثيرا ممن يستحقون التقدير والاحترام.
> وهل تحتاج المناهج للتطوير لتواكب المتغيرات؟
> >بكل وضوح تحتاج مناهج التعليم الجامعى وقبل الجامعى فى كل البلدان العربية للتطوير، وذلك لأسباب متعددة، أولها يعود لظهور علوم جديدة وحقول معرفية جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل حقول: العلوم والتخصصات البينية، والدراسات الثقافية، وتكنولوجيا المعرفة، وتكنولوجيا العلوم والتخصصات، حيث أصبح الآن لكل علم التكنولوجيا الخاصة به، مثل تكنولوجيا المواد وتكنولوجيا الطاقة وتكنولوجيا المعرفة.. إلخ.
ومن جهة ثانية لأن مفهوم العلم والمعرفة ذاته يتعرض لتطور دائم ومستمر ومتسارع، إلى الدرجة التى جعلت تصنيف المعرفة ذاته يتغير، من تصنيف ديوى العشرى الذى ظل مستمرا لعشرات القرون، إلى تصنيفات أوجدتها تكنولوجيا المعلومات والمعرفة وصناعة المعرفة الآن.
ومن جهة ثالثة، لأن سوق العمل تغيرت ملامحه وأبعاده ومعطياته، ولعل تقرير البنك الدولى عن العمل منذ 2019 كان بعنوان «الطبيعة المتغيرة للعمل»، والذى نص على أن «البلدان النامية ستحتاج إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان قدرتها على أن تنافس فى اقتصاد المستقبل، وأنه سيكون عليها أن تستثمر فى شعوبها بشعور بالغ من الإلحاح والعجلة لاسيما فى مجال الصحة والتعليم».
كل ذلك يؤكد الحقيقة الواضحة بأنه لابد للتعليم العربى أن يعيد صياغة منظومة مناهجه من الأساس.
> كيف ترى تأثير الذكاء الاصطناعى على البحث والرسائل العلمية، وهل قد يؤثر على الإبداع شعرا أو سردا وتأثيره على إنتاج نصوص أصيلة؟
> >هناك مخاطر عديدة تتوعد البحث العلمى والإبداع أمام الذكاء الاصطناعي، لكن أيضا هناك إمكانات لا حصر لها يمكن استثمار هذا الذكاء فيها، ومن أبسطها استخدامه بوصفه مساعدا وليس بوصفه بديلا عن العقل البشري، وهنا ستكمن المعضلة، فكيف يمكننا تدريب مستخدميه من طلابنا وأبنائنا على استخدامه؟ وكيف يمكن تدريبهم على استثماره لمساعدتهم فى البحث وليس فى إنجاز الأعمال نيابة عنهم…
القضية إجمالا يمكن تلخيصها في: ما موقعنا من آليات إنتاج الذكاء الاصطناعي؟ وما حدود إمكاناتنا فى استخدام معطياته؟ وكيف يمكن الدخول بلغتنا العربية ذاتها لمجال البرمجة مما سيسمح لنا بالتعامل مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
> لماذا بقى نجيب محفوظ فى مكانه على الساحة الأدبية عالميا وعربيا فى رأيك؟
> >فى تصورى الشخصى وبدون اللجوء لدبلوماسية الإجابة، أولا: لأنه استند على خلفية فلسفية، إذ إن الآداب والفنون ما لم تكن لها مرجعيات فلسفية (ولو فى خلفياتها البعيدة) فلا ضمان لبقائها واستمرارها، وثانيا: لأنه استطاع التعبير عن مفهوم النماذج البشرية ودواخلها وليس عن الشخصيات فى صورتها الظاهرية كما ترى الرؤى الضيقة، وهو ما يتشابه هنا مع ما يقال حول عالمية ديستويفسكى وكونه استطاع التعبير عن الصراعات النفسية الداخلية للبشر مهما كانت حكاياتهم الخارجية.
وثالثا، لوعيه بصيغ وأشكال التجريب التى كان يمارسها فى السرد، وتنوعها بين السرد التاريخي، وسرد الأحلام، والسرد الفانتازي، والواقعية السحرية، والسرد التجريبي.
ورابعا لضخامة منجزه قياسا لأى روائى أو قاص فى تاريخ السرد العربى المعاصر، وخامسا لدأبه المستمر وجهده الذى لم ينقطع على مدار حياته.
> كيف ترى الجيل الحالى من الروائيين؟
> >هناك مستويات متعددة من الكتابة الآن، وإن كانت فكرة الجيل قد انتهت (تماما كما انتهى مفهوم المدارس الأدبية)، إلا أنه طوال الوقت هناك كتابة مفاجئة على مستوى التجريب والآليات والموضوع والأهم الطريقة التى يتم بها حكى الموضوع أو القصة أو الحكاية..
والأهم أن هذه الكتابة تتداخل فيها روافد عدة أهمها السينما وتأثيرها البصرى وتقنياتها من مشهدية وحركة وقطع متوازى وغيرها مما لا يمكن تغافل تأثيره نقديا فى الكتابة الإبداعية عموما، وإن كنا لا نستطيع إغفال العديد من التجارب الرديئة أيضا والتى سقطت فى فخ ما يمكن تسميته الاستسهال الروائى الذى لا يستطيع التفريق بين مفاهيم الحكى والحكاية ومفاهيم السرد والرواية.
> لماذا تراجع دور النقد الأدبى؟
أسباب عديدة وراء ذلك، منها النقد الأكاديمى ذاته الذى انغلق على نفسه وانفصل عن الواقع، ومنها انتقال وسائل التداول الثقافى من الاعتماد على القراءة فقط (الصيغة الأساسية للنقد) إلى الاعتماد على وسائل الميديا المتعددة.
غير أنه ينبغى الانتباه أن ما تراجع هو النقد الأدبى بصيغته الواحدة متمثلا فى استخدام مدخل أو منهج أو نظرية والتطبيق على نص أدبي، فى حين ظهرت صيغ أخرى للنقد تمثلت في: القراءة الكاشفة، والقراءة التحليلية، والتحليل التأويلي، إضافة إلى صيغ أخرى كثيرة تتناسب وحالة التلقي، بمعنى أن الندوة الأدبية اقتضت مستويات من التداول النقدى (القراءات المتعددة للنص) والتى ستختلف عما يمكن تقديمه من نقد فى صحيفة أو مجلة متخصصة أو دورية علمية وما إلى ذلك.
> وهل أثرت وسائل التواصل الاجتماعى على النقد الأكاديمى خاصة مع انتشار النقد الانطباعى وجروبات القراءة وغيرها؟
قبل أن نتحدث عن تأثير التواصل الاجتماعى علينا أن نناقش أزمة النقد الأكاديمى ذاته متمثلة فى الانغلاق على تعليم النقد وليس ممارسته، والانفصال عن التطور الأدبى الحادث فى المجتمع والاكتفاء بتدريس النظريات والمناهج التى انقضى أمرها، وبالتالى كان البديل هو اللجوء لهذه الأشكال المتداولة التى طرحتها وسائل التواصل الاجتماعي، وفى تصورى أنها شكل من أشكال تفريغ الأشياء من مضمونها كما حدث لكثير من مظاهر الحياة عالميا بفعل هيمنة فلسفة السيولة على كل شىء.