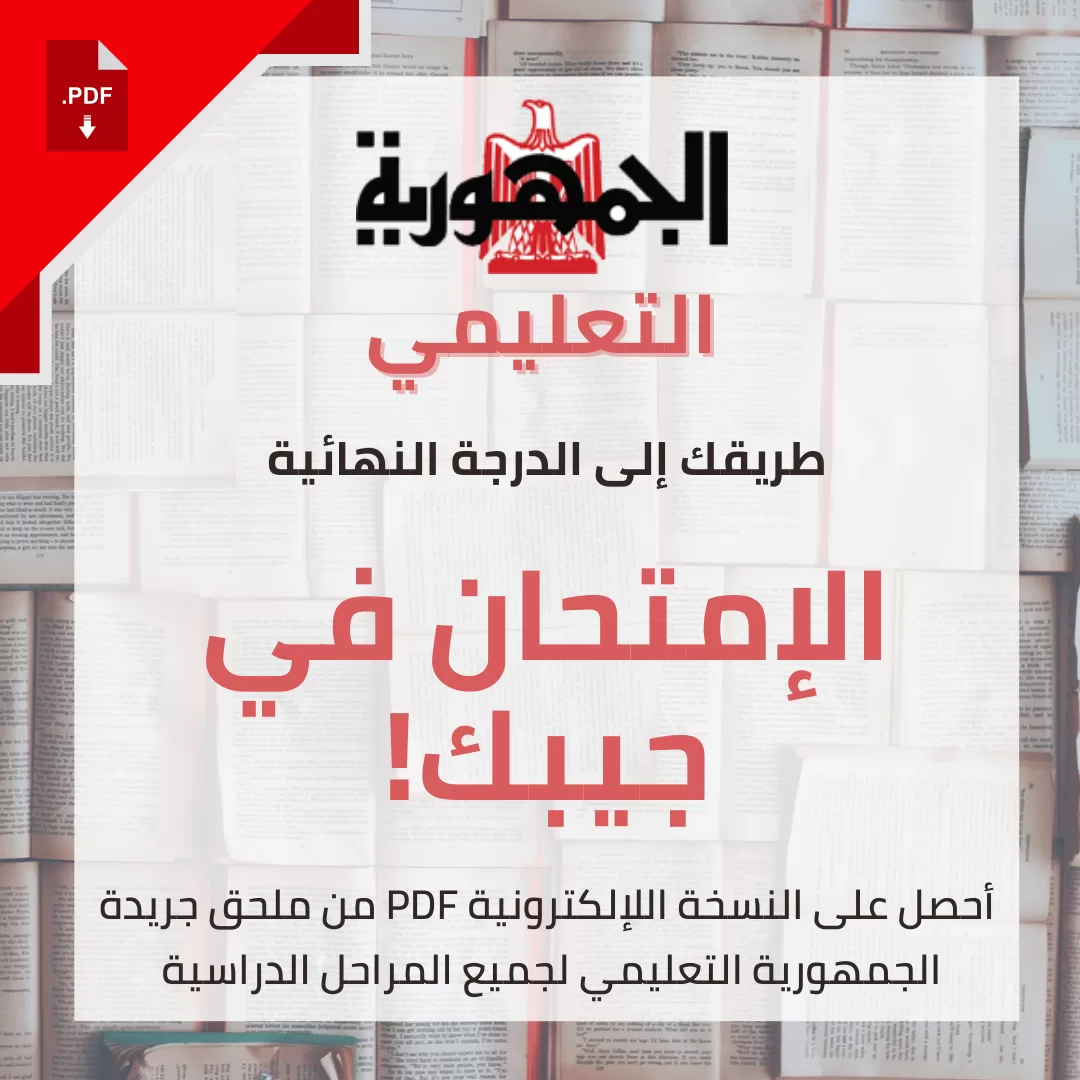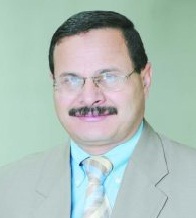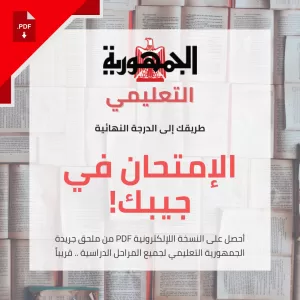تترك الحروب بصماتها على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد اعتبرت حرب أكتوبر 1973 نموذجاً لاقتصاد الحرب، حيث شهد الاقتصاد المصرى حينذاك إجراءات تقشفية تتمثل فى خفض الإنفاق الاستهلاكى وتأجيل تنفيذ المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل، وحشد الدعم الشعبى. ولهذا يعتبر السلاح الاقتصادى أحد الأسلحة التى مكنت الدولة المصرية من الصمود عقب هزيمة 1967 وحتى نصر أكتوبر 1973.الاقتصاد المصرى واجه خسائر فادحة نتيجة لهزيمة 1967، بلغت حوالى 11 مليار جنيه مصرى «أى ما يعادل 25 مليار دولار بسعر الصرف المسجل فى هذه الفترة عند 2.3 دولار»،كما خسرت الدولة نحو 80 ٪ من معداتها العسكرية ، إلى جانب الخسائر المسجلة فى إيرادات قناة السويس، وخسارة آبار البترول فى سيناء، فيما بلغت الخسائر الناجمة عن قصف إسرائيل لمنشآت قناة السويس ما يقرب من مليار جنيه (أى 2.3 مليار دولار). كما فقد الاقتصاد المصرى جزءا مهماً من الإيرادات السياحية تقدر قيمته بحوالى 37 مليار جنيه سنوياً، بالإضافة إلى تدمير 17 منشأة صناعية كبرى، وكنتيجة لتلك الخسائر، كان لا بد وأن تدخل الدولة المصرية مرحلة اقتصاد الحرب خلال الفترة من 1967 حتى 1973، وهو ما تم بالفعل، عبر مجموعة من الآليات المستندة على فكر اقتصادى وطنى مصرى خالص ،فمنذ عام 1966 حتى عام 1973 ارتفع الإنفاق العسكرى المصرى من 481.8 مليون دولار إلى 1.243 مليــار دولار بنسـبة زيـادة تبـلغ حوالى 158.4 ٪، كما ارتفعت نسبة الإنفاق العسكرى من الناتج المحلى الإجمالى من 6.68 ٪ إلى 13.51 ٪.كما اتبعت الدولة سياسة اقتصادية انكماشية، وذلك عبر تطبيق ثلاث أدوات رئيسية، تمثلت فى رفع أسعار السلع الكمالية وفرض الضرائب غير المباشرة، وكذلك خفض الدخول بزيادة أو فرص ضرائب مباشرة جديدة إلى جانب الحد من الترقيات فى القطاع الحكومى، وأخيراً فى خفض الاستثمار المحلى الإجمالى عدا الموارد الادخارية المتاحة.وهو ما صب فى نجاح الدولة المصرية فى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الطارئة بغرض الحفاظ على رصيد الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية خلال الفترة من 1967 إلى 1973، وذلك من خلال إعادة النظر فى خطط الاستيراد والتصدير لمعالجة العجز فى الميزان التجارى، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، وتطبيق ما يُعرف بـاسم «سياسة الإحلال محل الواردات» الرامية لإقامة قاعدة صناعية متكاملة، والوفاء باحتياجات السوق المحلية فى فترات الحروب والكساد، وخفض مستويات العجز فى الميزان التجارى وتقليل فاتورة الاستيراد نتيجة لإحلال السلع الصناعية المحلية محل مثيلتها المستوردة، وخلق فرص عمل جديدة. السياسات الاقتصادية السابقة التى انتهجتها الدولة المصرية بعد هزيمة 1967، انتهجتها النمور الآسيوية فى مواجهة التحديات والأزمات التى تعرضت لها فى تسعينيات القرن الماضى عبر سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستدامة والتنوع الاقتصادى، ومن أبرزها الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار: تعزيز البحث والتطوير فى مجالات الذكاء الاصطناعى والتقنيات الخضراء لدعم القطاعات المستقبلية، وتنويع مصادر النمو، وكما هو معروف، تركز نظريات «النمو ذاتى المركز» endogenous growth على عوامل أهم من رأس المال المادى والعمل، كالتركيز على التراكم المعرفى ورأس المال البشرى.وهكذا فإن عناصر القوة فى تجربة دول جنوب شرق آسيا هى عناصر حقيقية، ولم تهتز بحدوث الأزمات المالية الناتجة عن الانفتاح المبكر على أسواق المال والدخول فى عمليات اندماج مالى دون توافر الخبرة الطويلة المتاحة لبعض الدول الرأسمالية المتقدمة ذات الباع الطويل فى هذا المجال.
وقد نجم عن هذا الانفتاح عمليات ضغط متواصلة على هذه الدول، بالإضافة إلى الانخراط المبكر فى عمليات الخصخصة، والأخطر كان استشراء الفساد المالى، لذا سادت حمى المضاربات إلى القطاعات العقارية كما يحدث الآن فى بعض الدول العربية حين انتقل الاستثمار من قطاعات الإنتاج السلعى إلى قطاع المضاربات العقارية والمالية.وللحديث بقية إن شاء الله.