تواصل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال المجلس الأعلى للجامعات، جهودها لتعزيز وتطوير دور الجامعات المصرية فى منظومة البحث العلمى.
وقد شمل هذا التطوير مناحٍ متعددة، من أبرزها تحديث آليات تشكيل اللجان العلمية للترقيات، وتطوير معايير اختيار المحكّمين، والتحول من التقييم الورقى التقليدى إلى التقييم الإلكترونى بما يضمن سرعة ودقة وشفافية أكبر فى العملية، وهو ما عزز النزاهة والموضوعية، ومهّد الطريق أمام تمكين الجامعات المصرية من المنافسة فى التصنيفات الدولية.
غير أن جوهر القضية يتجاوز مجرد تطوير إجراءات الترقية، إذ يمثل تطوير آليات عمل هذه اللجان نقطة البداية الحقيقية لإعادة توجيه البحث العلمى كله نحو القيمة المضافة والتنمية المستدامة.
مؤشرات رقمية تكشف التحدى
تشير الإحصاءات إلى أن مصر شهدت تحسناً ملموساً فى السنوات الأخيرة. فقد ارتفع عدد الباحثين العاملين فى أنشطة البحث والتطوير من نحو 631 باحثاً لكل مليون نسمة عام 2015 إلى حوالي 845 باحثاً لكل مليون نسمة في 2023. كما بلغ الإنفاق على البحث العلمى فى 2023 نحو 1.03% من الناتج المحلى الإجمالى. وفى مجال النشر الدولى، بلغ عدد الأبحاث المصرية المنشورة في قواعد البيانات الدولية أكثر من 44 ألفاً بحث عام 2024، بينما كان عدد تلك الأبحاث أقل من 18 ألفاً عام 2015. أما فى مؤشر الابتكار العالمى فقد احتلت مصر المركز 86 من بين 133 اقتصاداً فى 2024، متقدمة من المركز 89 فى 2022.
هذه الأرقام تعكس صورة مزدوجة: من ناحية، هناك تقدم لا يمكن إنكاره، ومن ناحية أخرى يبقى السؤال: كيف يمكن تحويل هذه الجهود إلى قوة أكبر تحقق أثراً ملموساً فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
الأبحاث… من الكم والكيف إلى خريطة ذات أولويات وطنية
ورغم ما تحققه الجامعات المصرية من زيادة فى كم الأبحاث المنشورة دولياً، يبقى التحدى الأكبر فى كيف الأبحاث، أى نوعيتها وقيمتها الحقيقية. فالقيمة المضافة لا تقاس بعدد الأبحاث وحده، وإنما بمدى قابليتها للتحول إلى سياسات أو مشروعات أو ابتكارات تخدم المجتمع والدولة.
وقد ساهمت الجامعات المصرية فى السنوات الأخيرة فى التوسع الملموس فى مكافآت النشر الدولى، وهو ما انعكس إيجاباً على التصنيفات العالمية. غير أن المرحلة القادمة تستدعى التفكير فى نظام موازٍ من الحوافز الموجهة للأبحاث ذات المردود التنموى المباشر، لتشجيع الباحثين على ربط إنتاجهم العلمى بحاجات المجتمع وأولوياته.
من جانب آخر تظل مسألة الأبحاث المستخرجة من الرسائل العلمية إشكالية تحتاج إلى حسم. فالإشراف الأكاديمى على الرسائل جهد علمى كبير، لكنه لا يمكن أن يُعَدَّ إنتاجاً أصيلاً لعضو هيئة التدريس، لأن هذه الأبحاث هى فى جوهرها ثمرة جهد الطلاب وليس عضو هيئة التدريس. ومن المفارقات اللافتة أن قواعد الترقية تمنع عضو هيئة التدريس من استخدام الأبحاث المنشورة من رسالته العلمية السابقة (ماجستير أو دكتوراه) ضمن أبحاث الترقية، باعتبار أن ذلك لا يعد إنتاجاً جديداً، ومع ذلك تسمح بأن يتقدم ببحث منشور مأخوذ من رسالة أحد طلابه الذين أشرف عليهم! فإذا كان الهدف هو التأكيد على الأصالة والابتكار، فالأولى أن يمتد هذا المبدأ ليشمل أيضاً الأبحاث الناتجة عن إشرافه على الطلاب، لأنها فى حقيقتها ثمرة جهد الطالب الباحث وليس المشرف. من شأن وضع ضوابط حاسمة فى هذا الشأن يضمن أن تكون الأبحاث المقدمة للترقية تعبيراً صادقاً عن إبداع عضو هيئة التدريس نفسه، ويعزز من القيمة المضافة العلمية والبحثية للعملية ككل.
أيضاً يظل غياب البوصلة البحثية وافتقاد الأولويات القومية من أبرز التحديات، إذ كثيراً ما يختار الباحثون موضوعاتهم بدافع شخصى أو لمجرد استيفاء متطلبات الترقية، دون ارتباط واضح بخطط التنمية. والحل هو وضع خريطة بحثية وطنية تحدد أولويات استراتيجية فى كل تخصص، وتوجه الباحثين نحو قضايا ذات أثر حقيقى فى الاقتصاد والمجتمع.
الأبحاث البينية… قيمة مضافة للتنمية
تزداد أهمية الأبحاث البينية اليوم، حيث يجتمع أكثر من تخصص فى بحث واحد لمعالجة قضايا معقدة مثل دمج الطب مع علوم البيانات أو الاقتصاد مع الذكاء الاصطناعى. هذا النوع من الأبحاث أصبح توجهاً عالمياً لأنه الأكثر قدرة على خلق قيمة مضافة ودعم التنمية. ومن المهم أن تشجع اللجان العلمية هذا الاتجاه من خلال منحه وزناً نسبياً أكبر في التقييم، وتشكيل لجان مشتركة تضم خبراء من أكثر من تخصص، بما يواكب توجهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نحو تعزيز البحث التطبيقى المرتبط باحتياجات المجتمع.
التحكيم… كفاءة وسرعة وشفافية
آلية تقييم الأبحاث داخل لجان الترقيات تحتاج إلى إعادة نظر. فالنظام الحالى يعتمد على إرسال كل بحث إلى ثلاثة محكّمين بشكل دائم، بينما المعمول به عالمياً أن يتم التقييم عبر محكّمين اثنين فقط، مع اللجوء إلى الثالث فى حالة اختلاف التقييمات بشكل كبير وهي حالات نادرة الحدوث. وفى ظل ما نعانيه من قلة عدد المحكّمين وبطء الإجراءات، يصبح هذا النظام إهداراً للموارد، إذ إن ما يقرب من 33% من طاقة التحكيم قد يذهب سدى تحوطاً لحالات لا تتجاوز 5%. اعتماد النموذج الدولى سيختصر الوقت ويُوفر الجهد دون المساس بالموضوعية.
ومن المهم كذلك مراجعة معايير التقييم. فبينما تُخصص حالياً 40 نقطة للأصالة والابتكار عند تقييم الأبحاث المقدمة للجان العلمية، لا يحصل عنصر “قابلية التطبيق” إلا على 10 نقاط فقط، رغم أنه الأشد ارتباطاً بالقيمة المضافة والتنمية. ومن ثم فإن إعادة توزيع الأوزان لتمنح التطبيق العملى وزناً أكبر، مع تطوير مسميات المعايير الأخرى الموجودة فى استمارة التقييم الحالية لتشمل بوضوح أبعاداً أخرى مثل الارتباط بخطط التنمية الوطنية والقيمة المجتمعية للأبحاث، سيجعل التقييم أكثر اتساقاً مع أهداف الدولة.
تشكيل اللجان… خبرة دولية ومحلية
ينبغي أن تضم اللجان العلمية فى المقام الأول أعضاء لهم سجل قوى فى النشر الدولى، مع الاستفادة أيضاً من الخبرات المحلية للأساتذة الذين راكموا خبرة طويلة فى الإشراف الأكاديمى والعمل الجامعى. إن الجمع بين الخبرة الدولية والمحلية يضمن توازناً أكبر فى التقييم، ويحقق المواءمة بين متطلبات التصنيفات العالمية واحتياجات البيئة المصرية.
كما أن اقتصار المحكّمين على درجة “أستاذ” لم يعد منطقياً فى ظل اعتماد كبريات المجلات العلمية الدولية على باحثين نشطين يمتلكون سجلاً دولياً متميزاً، بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية. إلى جانب ذلك، فإن إشراك خبراء غير مصريين في التحكيم، كما تفعل الدوريات العالمية، يضيف موضوعية أكبر ويعزز انفتاح البحث العلمى المصرى على العالم.
التطوير التنظيمى… تدوير وتجديد ومرونة
بقاء بعض الأعضاء فى لجان الترقيات لسنوات طويلة يجعلها تبدو وكأنها مغلقة على عدد محدود من الأسماء. إن التدوير الدورى للأعضاء ضرورة لإتاحة الفرصة أمام دماء جديدة، ولإكساب الجدد خبرات عملية في إدارة التقييم. وجود سقف زمنى للمشاركة يعزز التنوع والشفافية، ويمنع الجمود. ومن الجوانب التى تستحق النظر أيضاً أن يتم تقصير مدة الأربع سنوات الحالية إلى ثلاث سنوات بما يسمح بمرونة وتجديد أسرع لمعايير التقييم.
أما المدة البينية للترقية، فالإبقاء على الخمس سنوات يتيح وقتاً كافياً لإنتاج أبحاث أصيلة وذات قيمة، بينما قد يحول التقليص إلى سباق لإنجاز الحد الأدنى. ويمكن تبني صيغة مرنة تسمح بالتقدم المبكر للباحث المتميز الذي يحقق إنتاجاً مرتبطاً بأولويات الدولة، مع الحفاظ على قاعدة الخمس سنوات كإطار عام يضمن الجودة والتراكم العلمى.
ما قبل وما بعد الترقية… من إنتاج أصيل إلى مردود تنموى
لا تقتصر التحديات على مرحلة الترقية فحسب، بل تبدأ قبلها وتستمر بعدها. فمن ناحية، يواجه الباحث فى مصر صعوبة كبيرة فى الحصول على البيانات الدقيقة والحديثة، خاصة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتطبيقية، مقارنة بما هو متاح فى العديد من الدول. وإذا كنا جادين فى تحويل البحث العلمى إلى أداة للتنمية، فإن الحل يكمن فى إنشاء منصات قومية مفتوحة للبيانات وتشجيع الهيئات المختلفة على إتاحة قواعدها البحثية للباحثين.
ومن ناحية أخرى، لا ينبغي أن يتوقف دور البحث عند لحظة الحصول على الدرجة العلمية. فالمطلوب أن تمتد العملية عبر آليات عملية، مثل إنشاء بنك قومىى للأبحاث يربطها بالوزارات والهيئات المختلفة، وتفعيل مكاتب نقل التكنولوجيا داخل الجامعات، وتشجيع تحويل الأفكار البحثية إلى براءات اختراع أو شركات ناشئة. ومن اللافت أن مصر سجلت فى 2024 نحو 1860 طلب براءة اختراعٍ، لكن نسبة المصريين لم تتجاوز 31.5% من الإجمالى. وهذه الأرقام تؤكد أن ربط البحث العلمى قبل الترقية بالبيانات الدقيقة، واستثماره بعد الترقية عبر آليات واضحة، هو الطريق لضمان أن يتحول من إنجاز أكاديمى إلى مردود تنموى حقيقى.
الخاتمة
إن ما تحقق حتى الآن فى تطوير عمل اللجان العلمية للترقيات يمثل نقلة نوعية ويستحق التقدير، لكنه أيضاً مجرد بداية لمسار أطول وأعمق. فحين تصبح الأبحاث المقدمة للترقية أكثر أصالة ومرتبطة بخريطة بحثية وطنية، وحين تُتاح للباحثين بيانات دقيقة وحديثة تساعدهم على إنتاج علمى رصين، وحين تمتد العملية بعد الترقية لتشمل آليات واضحة لاستثمار مخرجات الأبحاث فى الاقتصاد والمجتمع، عندها فقط تتحول اللجان العلمية من كونها غاية للترقيات إلى قاطرة للقيمة المضافة والتنمية المستدامة، وتصبح كل ورقة بحثية لبنة فى بناء مستقبل مصر.




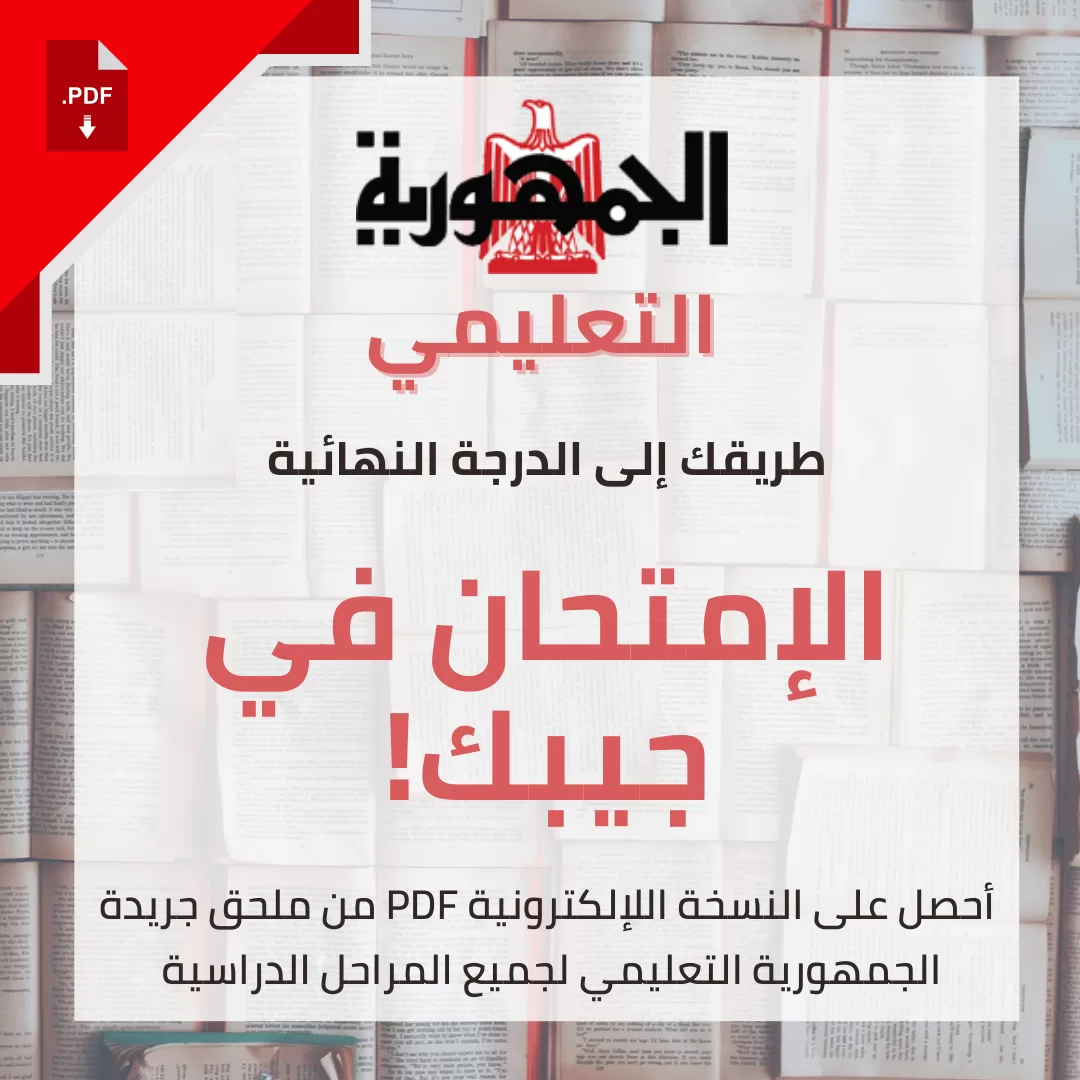
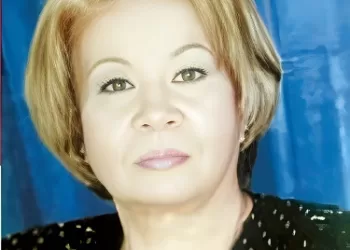



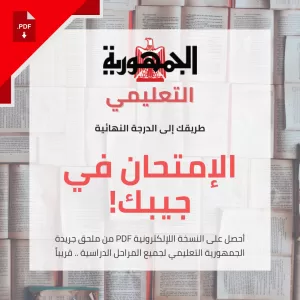




معالي أ.د/ هيام وهبه
أسعد الله أوقاتكم بكل خير
شكراً على مقالكم الرصين الذي يضع اليد على جوهر قضية البحث العلمي في مصر.. نعم المشكلة ليست في عدد الأبحاث المنشورة فقط؛ بل في نوعيتها وقيمتها المضافة للتنمية.
لقد قدمتم في مقالكم رؤية عملية لتطوير عمل اللجان العلمية للترقيات وربط الأبحاث بالأولويات الوطنية، مع الدعوة لتوسيع الأبحاث البينية وإتاحة قواعد بيانات حديثة، بما يحول البحث العلمي من مجرد إنتاج أكاديمي إلى رافعة حقيقية للتنمية المستدامة.
كما ان المقال – في رأيي المتواضع – يقدم معالجة علمية وموضوعية لقضية تطوير منظومة البحث العلمي في الجامعات المصرية، عبر تناول محاور متعددة تشمل تحديث آليات عمل اللجان العلمية، مراجعة معايير التقييم، وضبط العلاقة بين الإنتاج العلمي للأستاذ الجامعي والإشراف على الرسائل، كما يلفت النظر إلى أهمية الانتقال من الكم إلى الكيف، من خلال خريطة بحثية وطنية تحدد أولويات استراتيجية، وتشجيع الأبحاث البينية المرتبطة باحتياجات التنمية.
كما يطرح مقالكم رؤى عملية مثل اعتماد نموذج تقييم أكثر كفاءة وشفافية، إشراك خبراء دوليين، تدوير عضوية اللجان، وإنشاء منصات قومية للبيانات ومكاتب لنقل التكنولوجيا. هذه المقترحات إن نُفذت بجدية، يمكن أن تحول البحث العلمي من هدف شخصي للترقيات إلى أداة استراتيجية تدعم الاقتصاد والمجتمع المصري، وتسهم في تعزيز مكانة مصر في مؤشرات المعرفة والابتكار عالمياً.
بكل كلمات الشكر والتقدير والاحترام نشكركم على هذا المقال الرصين
أ./ احمد محمود المصري
أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة
عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف
أستاذ زائر بالاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية
🌹🙏
معالي أ.د/ هيام وهبة
استاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة
عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين
تحية طيبة وبعد،،
مقالكم الرصين يطرح رؤية إصلاحية مهمة لتطوير منظومة البحث العلمي ولجان الترقيات، خاصة فيما يتعلق بضرورة تشجيع الأبحاث البينية وربطها باحتياجات المجتمع، وهو اتجاه عالمي يتطلب وضع معايير تقييم خاصة تراعي طبيعتها التطبيقية.
كما أن الدعوة إلى ترشيد آليات التحكيم وتقليل عدد المحكمين لتسريع الإجراءات دون المساس بالموضوعية مقترح وجيه، لكن من الضروري أن يصاحبه إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمحكمين وربطها بمؤشرات أداء تضمن الجودة والسرعة.
أما فيما يخص معايير التقييم، فإن زيادة الوزن النسبي لقابلية التطبيق خطوة ضرورية، مع ضرورة تحقيق توازن بين القيمة المحلية والتأثير الدولي للأبحاث.
وفي جانب تشكيل اللجان العلمية، فإن الدمج بين الخبرة الدولية والمحلية يعزز التوازن، مع أهمية تدوير الأعضاء بشكل منظم لضمان التنوع ومنع الجمود، مع الإبقاء على قاعدة الخمس سنوات للترقية مع مرونة استثنائية للباحث المتميز.
وأخيراً، فإن معالجة تحديات ما قبل وما بعد الترقية تتطلب إنشاء منصة قومية للبيانات المفتوحة، وتفعيل آليات ما بعد الترقية مثل بنك قومي للأبحاث ومكاتب نقل التكنولوجيا، بما يحول الإنتاج العلمي إلى مردود تنموي حقيقي.
خالص الأمنيات لمعاليكم بدوام التوفيق والرقي
وسلم قلمكم الرصين ودمتم لنا..