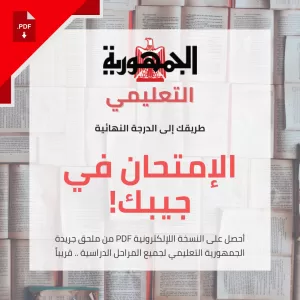بقلم / محمد وردي
-ابن بيه أحد أهم رموز العقل الأخلاقي والحكمة الإنسانية في التاريخ المعاصر
-خطاب الشيخ المجدد لا يندرج في إطار الفلسفات الوضعية أو الدينية التقليدية
-فكر ابن بيه مؤسس على أصل نوراني رحماني سابق للتنوير بالحداثة الغربية
-الخطاب ينبني على قيم كونية لا تختلف فيها العقول وتحتضنها النواميس الإنسانية
محمد وردي
التأمل في خطاب الشيخ عبدالله بن بيه يحيلنا إلى آفاق واسعة من ضروب التفكير أو سياقات التنوير والأنسنة. ولكنني سأتوقف عند أربعة ملامح:
الملمح الأول:
أن خطاب الشيخ ابن بيه لا يندرج في إطار الخطابات الشائعة في فلسفات الحداثة، التي دأبت على مخاطبة العقل والجسد وإعلاء الذاتية مع ديكارت. وهو ما اعتبره ماكس فيبر، إزاحة للوعي الأسطوري، أو “نزع السحر عن العالم”، أي أزاحة للدين والقيم. ولكن “الكوجيطو” الديكارتي “أنا أفكر إذن أنا موجود”، واستطراداً “أنا موجود لوحدي”، أنشأ في الواقع والحقيقة أسطورة العقل بدلاً من أسطورة الدين والقيم أو المُثل. فتراجعت “قيمة الروح التي لم تعد وسيلة اتصال بين الإنسان والرب؛ مادام أن كل اليقينيات ليس لها مصدر غير الإنسان العاقل نفسه. وبالوصول إلى عصر كانط ظهر أن ذلك الفضاء الرحب الذي كان الإنسان يلتقي فيه بالذات الإلهية صار معزولاً عن كل تدخل إلهي، ونعني فضاء الأخلاق، حيث لم يعد الفعل خيراً إلا إذا اتفق مع الواجب، ولا يكون الواجب فعلاً أخلاقياً إلا إذا كان مصدره العقل” * (1)


العلامة الشيخ الجليل عبد الله بن بيه
العلامة الشيخ الجليل عبد الله بن بيه
وبعد كانط أزاح نيتشة أسطورة العقل من عرشه المتعالي: “لقد مات الإله ونحن قتلناه”، فجعل – حسب هايدغر- من حدود الميتفايزيقا الخمسة التي أعلن بها موت الله: “إرادة القوة، العدمية، العود الأبدي للذاتي، الإنسان الأعلى، العدالة” *(2) أسطورة أخرى من حيث لا يريد. وانتهى ذلك إلى الأنانية الذاتية والقومية مع هيغل، ومضى الأمر مع ماركس – حسب تعبير براتراند راسل – إلى “الامبريالية المتنورة”، التي تقوم بعملية تمدين المتخلفين بدُثار استعماري بشع؛ لم يعرف التاريخ البشري له نظير. وأخيراً مضى قطار الانزياح الأسطوري إلى مآلاته العدمية؛ إذ “مع العود الأبدي للذاتي يصبح الموجود في عوده الآبد وتناسخه الأبدي من دون هدف موجه أو معنى ينتظمه، ومن ثم يصير أفقه الانطولوجي هو العدمية في تمام تحققها. “لهذا فمذهب العود الأبدي للذاتي، لا يمكن أن يفهم، حسب هايدغر، إلا انطلاقاً من تجربة العدمية”. إذ من يستسيغ أن تدور الأشياء في رقصة أبدية مكرورة، وأن تتناسخ من دون معنى وإلى أبد الآبدين؛ إنْ لم يكن تستغرقه العدمية، ويتلبسه العماء”. * (3) هكذا وباتفاق تيار واسع من الفلاسفة بدءاً من هايدغر، مروراً بمدرسة فرانكفورت، وصولاً إلى فوكو ودريدا وليوتار.. وآخرين كثر، سادت المركزية الذاتية المتعالية، وما أنتجته من تمييز عرقي وتفوق ثقافي بغيض.
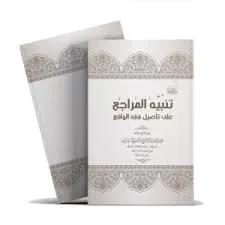
أيضاً لا يندرج خطاب الشيخ المجدد عبدالله بن بيه في إطار الخطابات الدينية التقليدية، القائمة بمعظمها على تأبيد النقل والترداد أو الوعظ والإرشاد أو ما أحب أن اسميها “زجريات الرعب الهتشكوكية” التي يتفنن بها البعض، أو “الحربجية/الفتنوية” التي يزعق بها البعض الآخر ليل نهار في الآونة الأخيرة، وإنما هو خطاب صاغه حكيم عارف بروح الزمان وفلسفة الإنسان، خطاب حاكه حائكُ كلامٍ حاذق بأسرار البيان؛ سواء من حيث الرحابة العقلانية التجديدية أو التنويرية المؤنسنة، المفتوحة على فضاءات دلالية وتأويلية فارهة الثراء، أو من حيث الإيمانية، المطرزة بأسلوبية بديعه، تجعله يبدو وكأنه خطاب وجداني، غير أن بنية الخطاب الدلالية لا تقتصر على مخاطبة المشاعر أو استثارة الانفعالات الإنسانية فقط؛ باعتباره خطاباً إيتقياً أو أخلاقياً بحتاً، وإنما تجمع معها ما أحب أن أسميها “عقلانية إيمانية” مفارقة للسائد في المعرفة الإنسانية المعاصرة، بمعنى أن الخطاب يتوجه إلى العقل؛ بقدر ما يتوجه إلى الروح أو القلب بأسلوبية دافئة (إن صح التعبير)، وهو في ذلك يقتفي الأثر القرآني؛ سواء على مستوى التهيئة النفسية بألفة حميمية مدهشة، أو على مستوى المواءمة أو التناسب مع الإمكانية المُيسرة؛ بمعنى المستطاع الإنساني، أو على مستوى فلسفة “فقه الواقع والتوقع” وتحولات الزمان وإكراهات الإنسان، أي “واجب الوقت”؛ بتعبير فقهي. فالخطاب يمكن أن يتلقاه العقلاني، فيُدهش بخلاصاته النظرية، ويسلم بأدواته النقدية ومنهجيته المنطقية البرهانية، وفي الوقت عينه هو خطاب يمكن أن يتلقاه العالم المتبحر في علوم الدين؛ فيسلم بتأويليته المقاصدية الجديدة، التي تعيد الدين إلى جوهره الرحماني الإنساني الشفيف، أي الجوهر الذي يتقصد تحصيل سعادة الإنسان في العاجلة والآجلة، كما هو الدين في الأصل؛ بمقتضى الخيرية الوجودية، التي قامت عليها فلسفة الخلق؛ من دون سببيات ضرورية أو حتميات طبيعية. كما يمكن أن يتلقاه المتدين البسيط، فيجد به طمأنينة الإيمان، ورحمةَ الرحمان، ودفءَ المحبةِ بالإنسان.
الملمح الثاني:
أن الخطاب لا ينطلقُ من مفهومِ التنويرِ؛ كما قدّمتْهُ الحداثةُ الغربيّةُ، أيْ التنويرِ الذي قامَ على فِكرتَيْ تحريرِ العقلِ والْجسدِ. فالانتصارُ للعقل في التنوير الغربي جاء كردّة فعلٍ طبيعيةٍ على تاريخٍ طويلٍ من وأد العقل، بدأَ معَ تنصُّرِ قسطنطين العظيم، حيث صارَ عهدُهُ “فاتحةً لألفِ عامٍ عاشها الفكر في الأغلال، واستُعبدَ فيها العقلُ استعباداً بيّناً، وتوقفت فيها حركةُ العلمِ والعِرفان”، كما يقولُ جون بيوري، في كتابِ “حرّيّة الفكر”. وقريب منه يقول كوندرسيه (1743-1794) في كتاب “مخطط لوحة تاريخية لألوان تقدم العقل البشري”: إن احتقار العلوم الإنسانية كان إحدى الخصائص المميزة للمسيحية، الذي كان بمثابة انتقام من الفلسفة في أخص ما تختص به وهي الروح النقدية” * (4) كذلك الحالُ بالنسبة لتحرير الجسد، الذي شهدَ مرحلةً مماثلةً منَ القمعِ والاضطهادِ، إذ جرى ترذيلُهُ؛ باعتباره موطنَ الدنسِ أو الخطيئةِ في اللاهوت المسيحي القروسطي. ولذلك انتهتْ فكرةُ الأنسنةِ في الفلسفاتِ الوضعيةِ المعاصرةِ إلى العدمية وتنميطِ الذاتِ الإنسانيةِ وكأنها صورةٌ واحدةٌ في القطيعِ البشريِّ، حيث جرَى أسْرُ الإنسانِ في قالبٍ فيزيولوجيٍّ بيولوجيٍّ/نفسيٍّ، يتقدّمُ فيهِ العقلُ (على النحوِ الذي مضَى إليهِ فلاسفةُ العقلِ)، والغريزةُ (على نحوِ ما ذهبَ إليهِ فرويد ولاكان ويونغ وآخرون) والمركزية الذاتية المتعالية كما أسلفنا. وهكذا راحَ مفهومُ الأنسنةِ في الوعيِ المعاصرِ يحيلُ إلى بُعدٍ حُقوقيٍّ أفقيٍّ على مستوى الأفرادِ والجماعاتِ على السواء؛ تحتَ عنوان حقوق الإنسان (حقوقٌ قانونيةٌ في المساواة أو العدالةِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والسياسيةِ، وحقوقٌ معنويةٌ في الكرامةِ والحرّيّاتِ، أيْ حرّيةِ التعبيرِ والمعتقدِ والممارسةِ الثقافيةِ). أمّا التنويرُ الذي يرومُه خطابُ الشيخِ عبدِ اللهِ بنِ بيّه، فهوَ بالتأكيدِ يتقصّدُ الإنسانَ، ولكنْ ليسَ باعتباره صورةً نمطيةً تستدعي حقوقاً قانونيةً أفقيةً فقط، وإنّما مِن خلالِ إعادةِ النظرِ في الطبيعةِ البشريةِ؛ باعتبارِ أنّ الذاتَ هي كينونةٌ فرديةٌ ومتفرّدةٌ بالدرجةِ الأولَى، وأنّ لَها حقوقاً أفقيةً يتساوَى فيها الْجميعُ، ولكنّ لها حقوقاً أخرى لا يتساوَى فيها الْجميعُ، وتندرجُ هذهِ الحقوقُ في إطارِ ما يمكنُ أنْ نسمّيَهُ مجازاً: “خصوصيّاتٌ أخلاقيةٌ فرديّاً”، و”خصوصياتٌ ثقافيةٌ للجماعات أو المجتمعات”. فمثلاً علَى مستوى الخصوصياتِ الأخلاقيةِ فرديّاً: إذا افترضْنا أنّ الخيرَ هوَ القيامُ بما هو صوابٌ، فكيف نعرِّفُ الصوابَ؟ ثمّ كيف نحدّدُهُ؟ فهل الصوابُ، هو “صوابٌ موضوعيٌّ”، أيْ عِلميٌّ مطلَقٌ، أمْ أنّهُ “صوابٌ نسبيٌّ” معنويّ؟
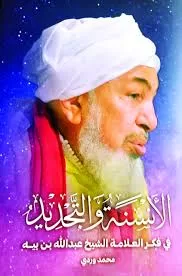
إنّ تعريفَ الصوابِ على المستوى الشخصي، هو ما يحبّذُهُ ضميرُ الشخصِ. ولكنّ الضمائرَ لا تتعادلُ ولا تتساوى في التحبيذِ، فما هوَ محبَّذٌ لدَى شخصٍ ما، قد يكونُ أقلَّ تحبيذاً لدى آخرَ، وربّما لا يكونُ محبَّذاً عندَ ثالثٍ، وقد يكونُ مرفوضاً بالمطلق عند رابعٍ. ولذلكَ؛ لا يضمنُ التحبيذُ الشخصيُّ “الصوابَ الموضوعيَّ”، أيْ الصوابَ الذي يجعلُ الآخرينَ متّفقينَ علَيهِ؛ لأنّ الضمائرَ تختلفُ وتتباينُ من شخص إلى آخرَ؛ بمقدارِ مدركاتِهم للصوابِ، ومدى إيمانِهم بالخيرِ؛ باعتبارِ أنّ الصوابَ هو فعلُ الخيرِ. أمّا فيما يتعلق بحدود الصواب، فهلْ هوَ الصوابُ الشخصيُّ، أيْ الصوابُ بمُقتضَى الضميرِ الشخصيّ، أمْ هو الصوابُ الموضوعيُّ؟ “وفي هذِه الحالةِ يكونُ سؤالُ: ماذا يجبُ أنْ أفعلَ؟ سؤالاً يحتملُ أكثرَ مِن معنىً. فإذا أُخِذتْ كلمةُ “يجبُ”؛ بمعنى الصوابِ الشخصيِّ، فيجبُ عليّ أنْ أتبعَ ما يُمْليهِ ضميرِي، ولكنّها إذ أُخِذتْ بمعنَى الصوابِ الموضوعيِّ، فإنّ تصرُّفي ينبغي أنْ يمرَّ باختبارٍ أقلَّ “شخصيةً”؛ قبلَ أن يحظَى بالتحبيذِ (الْجماعيّ). وإذا اعترفْنا بأنّ الضمائرَ ليسَت كاملةً (كما أسلفْنا)، فسيتعيّنُ علينا أن نبحثَ عن تصوّرٍ “للصوابِ الموضوعيِّ”، يمكنُ بواسطتِهِ الحكمُ على الضمائرِ”.* (5) وهذا أمرٌ غيرُ قابلٍ للتحديدِ؛ بقدرِ ما هو قابلٌ للتعريفِ؛ باعتبارِ أنّ الهدفَ الأساسَ منَ الأخلاقِ هو الحثُّ على السلوكِ الذي يخدمُ مصلحةَ الْجماعةِ وليسَ مصلحةَ الفردِ. فكيفَ نجعلُ سلوكَ الفردِ يخدمُ مصلحةَ الْجماعةِ بالضرورةِ الأخلاقيّةِ؟ هل يمكنُ ذلكَ من خلالِ الأطُرِ الحقوقيةِ الأفقية التي رسمتْها الحداثةُ الراهنةُ عبر عهودِ حقوقِ الإنسانِ، أمْ أنّ الأمرَ يستدعِي مقاربةً أخرى؟

والأمرُ لا يختلفُ بالنسبةِ للْجماعةِ، فمثلاً: ما يصلحُ حقوقيّاً لهذهِ الْجماعةِ قدْ لا يصلحُ لجماعةٍ أُخرى، أو ما هو مقبولٌ في خصوصيةٍ ثقافيةٍ ما، قد يكونُ غيرَ مقبولٍ في خصوصيةٍ أُخرى، وما يمكنُ التغاضي عنهُ في تلكَ الْجماعةِ، قد يدخُلُ في نطاقِ المحرَّماتِ لدَى جماعةٍ ثالثة. ولذلكَ؛ يجبُ مراعاةُ الخصوصيّاتِ الثقافيةِ بالضرورةِ الحقوقيّةِ.
وهذا ما يتقصّدُهُ خطابُ الشيخِ عبدِ اللهِ بنِ بيّه بالضبط؛ من وراء مراجعةِ مفهومِ التنويرِ وقِيَمِ الأنسنةِ في الحداثةِ الراهنةِ عموماً. وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن الخطاب يعيب على الحداثة الراهنة مآخذها أو يجافيها، وإنّما هو يعيدُ صياغتَها على نحوٍ أكملَ وأنبلَ، كما هو شأنُ التفلسفِ من حيثُ إعادةُ أشكلةِ الموضوعِ الإنسانيِّ؛ انطلاقاً من السؤالِ الفلسفيِّ الأزليّ: كيفَ يمكنُ أن يكونَ الإنسانُ كما يجبُ أن يكونَ؟
بهذا المعنَى؛ يتأسّسُ الخطاب على مبادئِ الفضائلِ الكلّيةِ، أو القيمِ الكونيّةِ العُليا الّتي لا تختلفُ فيها العقولُ، والّتي تحتضنُها النواميسُ الدِّينيةُ والأخلاقيةُ كمرجعيّةٍ عُليا؛ في محاولتِهِ لإعادةِ صياغةِ قيمِ العصرِ على نحوٍ أرقَى؛ بالاستفادةِ من خُلاصةِ الحداثةِ؛ سواءٌ علَى المُستوى النظريِّ، أو على المستوى القانونيِّ الحقوقيِّ؛ حسبَما نصّتْ عليها المواثيقُ والعهودُ الدوليّةُ في شرعةِ حقوقِ الإنسانِ؛ إذْ على أقلِّ تقديرٍ، “أنّ التعاملَ انطلاقاً مِن مبدأِ الحقوقِ يقتضي الاقتصارَ على منحِ الآخرِ ما هوَ أصلاً لهُ، أو الكفِّ عن التعدّي عليه، بينما التعاملُ انطلاقاً من الفضائلِ يَحتوي معنَى المُكارمةِ، فهو بذلٌ في غيرِ مقابلٍ، وتنازلٌ للآخرِ عمّا ليسَ لهُ بحقٍ”، كما ينصُّ الخطاب.
أمّا على مُستوَى فرادةِ الذاتِ أو تفرُّدِها، فهي فريدةٌ ولا نظيرَ لها؛ من حيثُ أنّها ذاتٌ مخلوقةٌ على صورةِ اللهِ؛ سواءٌ على مستوى أهليّتِها الأخلاقيةِ، أو على مستوى خيريّتِها الوجوديةِ في أصلِ الخلقِ. إذْ “ليسَ للهِ تعالَى خلقٌ أحسنُ من الإنسانِ، فإنّ اللهَ خلقَهُ حيّاً عالماً، قادراً مُريداً متكلّماً، سميعاً بصيراً، مدبّراً حكيماً.. وهذِه صفاتُ الربِّ سبحانَه، وعنْها عبّرَ بعضُ العُلماءِ، ووقعَ البيانُ بقولِهِ: “إنّ اللهَ خلقَ آدمَ على صورتِهِ”، يعني على صفاتِهِ الّتي قدّمْنا ذِكرَها. وفي روايةٍ: “على صورةِ الرحمنِ”، ومِن أينَ تكونُ للرحمنِ صورةٌ متشخّصةٌ، فلم يبقَ إلّا أن تكوَن معانيَ”، على ما ينقلُ الطبريُّ، عنِ ابنِ العربيِّ في تفسيرِ قولِهِ تعالَى: “لقَدْ خلقْنا الإنسانَ في أحسنِ تقويم”.* (6)
ولذلكَ لا يمكنُ تنميطُ الذاتِ الفرديّةِ في سياقٍ جمعيٍّ، والنظرُ إليها كذاتٍ إنسانيةٍ تستدعي حقوقاً قانونيةً أفقيةً فقطْ؛ لأنّهُ مِنَ الاستحالةِ بمكان أنْ يكونَ هناكَ نظيرٌ لصورةِ اللهِ. وأمّا أنّها متفرّدةٌ، فذلكَ يعودُ إلى مدَى فاعليّتِها الوجوديةِ، الّتي يستحيلُ أن تتشابهَ معَ فاعليةِ الذواتِ الأُخرى؛ مِن حيثُ التفاوتُ أو التباينُ في تَنامِي قُواها الحيويّةِ، وهوَ الأمرُ الّذي يؤسّسُ مدَى فاعليّتِها؛ بل يقرّرُ مدَى خيريّتِها الوجوديّةِ، في سياقِ ما يمكنُ أنْ تصيرَ عليهِ مِن فاعليّةٍ متجدّدةٍ باستمرارٍ؛ معَ تجدُّدِ طبيعةِ الوجودِ، ومقتضياتِ العقلِ، من حيثُ قدرتُه على التعلّمِ الّذي يفرضُ أوتوماتيكياً إمكانياتٍ متباينةً على مستوى تطوّرِ خبراتِ الأفرادِ.
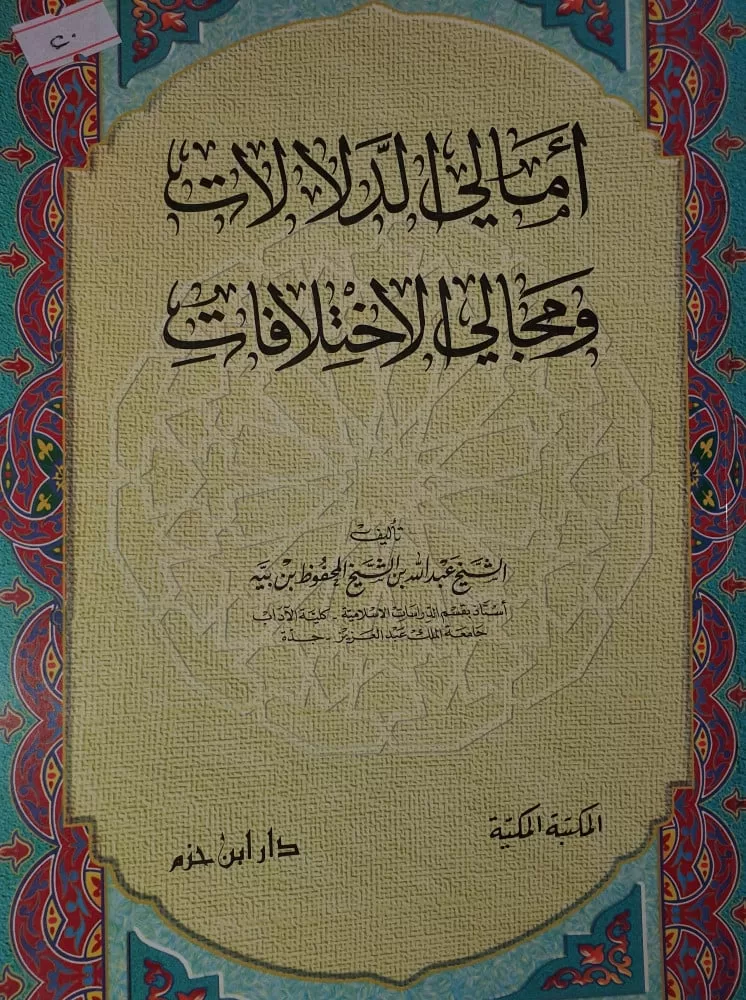
أمّا الدلالاتُ الأعمقُ على تفرّدِ الذاتِ الفرديةِ، فتكمنُ في ردودِ أفعالِها؛ سواءٌ مِن حيثُ الإدراكاتُ أو الاستجابةُ للانفعالاتِ، أو من حيثُ الحاجاتُ والرغباتُ أو نزعةُ الإشباعِ التي بحثها العديدُ من الفلاسفة، وقدموا حولها تفسيرات متباينة؛ حتى بدت وكأنّها متناقضة لدرجة بدت فيها وكأنها لا تعرفُ الإشباعَ أبداً، لا بل صارت أشبهُ بجهنم، تطلب مزيد يليه مزيد؟!
-التنوير في فكر الشيخ ابن بيه يتقصد الإنسان كما أراد له الله أن يكون
-الخطاب يعيد النظر في الطبيعة البشرية وما انتهت إليه من تغريب وعدمية
-فكر الشيخ ابن بيه يراجع قيم الحداثة المعاصرة لتطعيمها بروح إيمانية عقلانية
-الأخلال في شرعة حقوق الإنسان لأن الله غاب عنها فخلت من النواميس الإنسانية
الملمح الثالث:
إن خطابَ الشيخِ ابنِ بيّه لا يقطعُ معَ مُنجزاتِ الحداثةِ الفكريةِ على المستوى الإنسانيِّ، وإنما هو يراجعُها، ويَبني عليها رؤيتَهُ للإنسانِ كما أرادَ له المَولَى عزَّ وجلَّ أن يكونَ، فمثلاً: يقرِّرُ الخطابُ على المستوى الحُقوقيِّ أنّ التطاولَ على المُقدّساتِ والمُعتقداتِ أو إهانةَ الثقافاتِ؛ بما تمثّلُهُ من خصوصياتٍ، لا يمكنُ أنْ يندرجُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ في مفهومِ الحقِّ؛ بتكأةٍ وهميّةٍ كاذبةٍ على الديمقراطيةِ، تحت مسمَّى “حرّيةِ التعبيرِ”؛ لأنّ التطاولَ والإهانةَ هُنا؛ يمسّانِ جوهراً حُقوقيّاً ثابتاً، يُفترضُ أن يتقدّمَ بنودَ شرعةِ حقوقِ الإنسانِ ومجملَ لواحقِها، من خلالِ ملاحظةِ الخصوصياتِ الثقافيةِ وضرورةِ مراعاتِها. لذلكَ يربطُ الخطابُ حرّيةَ التعبيرِ؛ بما يسمّيهِ “المسؤوليةَ الأخلاقيةَ”؛ بمُقتضَى “الواجبِ الأخلاقيّ”. والأمرُ عينُه في موضوعاتِ “الديمقراطيةِ الانتخابيةِ” و”المواطَنةِ الشاملةِ” و”الاعترافِ بالآخرِ” وغيرِها من الموضوعاتِ التي توقّفَ عندَها الخطابُ، وسبق أن عرضناها مفصلة بإسهاب في كتابنا “الأنسنة والتجديد في فكر العلامة الشيخ عبدالله بن بيه” *(7)
ولا يخفى في الخطاب حقيقة أن الأخلالَ بشرعةِ حقوقِ الإنسانِ، سببُهُ الرئيسُ أنّها غاب عنها الله، حيث اتفقت اللجنة التي كانت تصيغ الإعلان العالمي “على استبعاد الله سبحانه وتعالى، واستبعاد الخُلق وما يُشتق منه، كما يقول شارك مالك، الذي كان العضو العربي الوحيد مع رينيه كاسان وجون همفري” (تأطيرية الملتقى الرابع، ص-66)، أي خلا الإعلان مِن أهم نواميسِ الإنسانيةِ، وهي الشرائعُ الدينية والقيم الأخلاقية، فماتتْ فيها مشاعرُ التضامنِ الأخلاقيِّ والتراحُمِ أو التعاطُفِ الإنسانيِّ. وهو ما يستدركُهُ الخطابُ بواقعيّةٍ عقلانيةٍ إيمانيّةٍ رائقة.
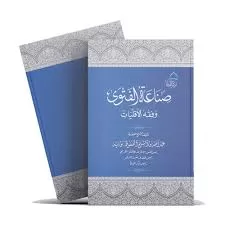
الملمح الرابع:
أنّ خطابَ الشيخِ ابنِ بيّه يقومُ على فلسفةِ “الخيرِ العامِّ”، أيْ خيرِ الإنسانِ للإنسانِ. لذلك نلاحظ أن السلم يتقدم منظومة الخير العام في الخطاب؛ سواءٌ من حيث التنظير في ديباجةِ السِّلمِ في ملتقى “منتدى أبوظبي للسلم” الأول، وتأصيلِهِ في الثقافةِ الإسلاميةِ، وبيانِ ضرورتِهِ الحاقّةِ إنسانياً، أو من حيثُ أن السلم يشكل الحاضنة الأكثر مناسَبة؛ لتحقيق مقاصد الشريعة؛ باعتبارها تختزل فلسفة الحقوق في التشريع الإسلامي. “وإذا كان الأمر كذلك ألا يكون الإذعان لأولوية السلم فريضة شرعية قبل أن تكون اعتباراً بالتجارب الإنسانية واستفادة من الحكمة البشرية؟” (تأطيرية الملتقى الرابع، ص-24).
ويُقَعِّدُ الخطاب هذا التصور؛ في إطار ما أحبُّ أنْ أسمّيها “عمارةَ الأخوّةِ الإنسانيةِ” التي وضع أولى مداميكها عندما “أعلن الحرب على الحرب لتكون النتيجة سلماً على سلم”. وراح يرص بنيانها على قيم الخير العام في محطات عدة، استهلها بإعلان مراكش لحقوق الأقليات عام 2016، وهو من أبرز الدلات على إنسانية وكونية الخطاب. تلت الإعلان “حملة المليار وجبة” عام 2017، ثم “إعلان واشنطن لتحالف القيم” عام 2018، وجرى تتويجها بإطلاق ميثاق حلف الفضول العالمي الجديد؛ بمشاركة قادة الأديان الكبرى في العالم عام 2019، وأعقب ذلك “إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة” عام 2021.
ويُشيِّد الخطاب تصور “عمارةَ الأخوّةِ الإنسانيةِ” على أُسُسٍ ثابتةٍ، تتمثّلُ بترسيخِ وتعزيزِ قيمِ “الإنصافِ” و”التضامنِ” و“بذلِ السلامِ للعالمِ” و”المواطَنةِ الشاملةِ – من الوجود المشترك إلى الوجدان المتشارك“. فيؤسّسُ بذلك وعْياً جديداً، هدفُهُ صناعةُ الخيرِ العامِّ على أكمل ما يكون عليه الأمر؛ باعتبارِ أنّنا بفلسفةِ الخيرِ العامِّ الّتي تجتمعُ حولَها “روحُ ركّابِ السفينةِ الواحدةِ” المستلهمة من المأثور النبوي الشريف للدلالة على ترابط مصير البشرية في سبيل النجاة، يمكنُنا “تجديدُ القيمِ في النفوسِ وتأكيدُ الوعيِ بوحدةِ المصيرِ الإنسانيِّ، والدعوةُ إلى هبّةِ ضميرٍ عالميّةٍ، تُعيدُ لِقيَمِ التضامنِ والتكافُلِ فاعليّتَها، وتقدّمُ مفهوماً جديداً للإنسانيةِ يتجاوزُ المبدأَ المحايدَ لحقوقِ الإنسانِ المتمثّلِ في المساواةِ وعدمِ الاكتراثِ بالاختلافِ؛ ليَرتَقيَ إلى إيجابيةِ قيمِ الفضيلةِ، التي تُشعِرُ الآخرَ بدفءِ المحبّة والأُخوّةِ”.
ويقرر الخطاب أن الخيرَ العامَّ وجوهرُهُ التضامنُ، إنّما “هو مرتبةٌ عُليا تسمُو على مجرّدِ الاعترافِ إلى التعارُفِ، وبِهِ يتمُّ تجاوُزُ ضيقِ الذّواتِ إلى فسحةِ المُشتركِ، وينتقلُ مِن تشرذُمِ الأقلّيّاتِ والهُويّاتِ الحرجةِ إلى وحدةِ الأكثريةِ الْجامعةِ، مجتمعِ الإنسانيةِ الكُبرَى”، أيْ الإنسانيةِ المتآخيةِ في كلِّ زمانٍ أو مكانٍ؛ بغضِّ النظرِ عنِ الانتماءاتِ الثقافيةِ، من حيثُ أن الخير العامَّ، ينتظمُ في إطار الواجب أو “الضمير الأخلاقيِّ”، المغروسِ في أعماقِ الذاتِ الإنسانيةِ؛ بمُقتضَى الخيريّةِ الوجوديةِ الأولى في أساس الخلق، ويجبُ أنْ يترقَّى باستمرارٍ على أُسُس الفضيلة وقيَمِ الرحمةِ، حسبَ دواعي الدين والأخلاق بمققتضى صواب العقل ومعقول المنطق؛ لأنّ العدالةَ السياسيةَ والاقتصاديةَ والاجتماعيةَ، في كلِّ ما انتهَتْ إليهِ الحداثةُ المعاصرةُ؛ لم تَسُدَّ الثُّغراتِ التي تَحولُ دونَ عمارةِ “مفهومِ الأُخوّةِ الإنسانيةِ” في النفوسِ قبلَ النصوصِ. وهو ما نلاحظُ نتائجَهُ من الاحترابِ والعنفِ العدميِّ، المُنفَلِتِ من كلِّ زمامٍ على مستوى العالمِ. وعلى العمومِ؛ إذا كانت العدالةُ الاجتماعيةُ والاقتصاديةُ والسياسيةُ من مهمّاتِ الدولةِ، فالخيرُ العامُّ، بطبيعةِ الحالِ، لم يكُنْ من مهمّاتِ الدولةِ الحديثةِ، كما يلاحظُ جون راولز في كتابِ “نظريّة العدالة”. ما يقتضي تأسيسَ ثقافةِ “الخيرِ العامِّ” في النفوسِ في إطارِ “الضميرِ الأخلاقيّ” أو “الواجبِ الأخلاقيّ”، الذي لا يمكنُ أنْ تلاحظَهُ النصوصُ، وإنْ لاحظَتْهُ فلنْ يأتيَ بالنتائجِ المَرجوّةِ لَهُ؛ لأنّ الفرقَ كبيرٌ بينَ الإلزامِ القانونيِّ القسريِّ، والإلزامِ الأخلاقيّ الطوعيّ. فمِن جهةٍ أُولى: إنّ الإلزامَ القانونيَّ إذا صارَ قهراً فقدَ صفتَهُ الأخلاقيةَ، الّتي لا يمكنُ أنْ تكونَ كما يجبُ أن تكونَ؛ من دونِ الحرّيةِ التلقائيةِ، فضلاً عن التردُّدِ أو الشكّ؛ بمدَى الاستعدادِ الذاتيّ الفرديّ؛ للعمل بالإلزام القانونيِّ طوعاً؛ بجِدٍّ وكَدٍّ يليقانِ بموجباتِهِ. ومن جهةٍ ثانيةٍ: لا أحدَ يأتي خيراً إذا فعلَ ما فعلَ مُجبَراً، وإنْ كان ما فعلَهُ خيراً؛ باعتبارِ أنّ الخيرَ هو فضيلةٌ طوعية عفوية، ولا يمكنُ للفضيلةِ (بهذا المعنى) أن تنطويَ على عسْفٍ أو تضييقٍ. ولذلكَ يتقصّدُ خطابُ الشيخِ تأسيسَ ثقافةِ الخيرِ العامِّ في النفوس قبلَ النصوصِ، من خلالِ تشييدِ “عمارةِ الأُخوّةِ الإنسانيةِ” على قِيَمِ الخيرِ العامِّ، حيث تتأسس جسور التعارف ودوائر التضامن على جملة من المشتركات الإنسانية. فعلى مستوى المعتقدات “أليس جوهر الأديان من حيث الممارسة العملية تزكية النفوس لتُثمر الفضيلة ومحبة الخلْق وحسن المعاملة والتعاون على الخير؟ (…) أليس من الأنفع للبشرية أن تتعاون الأديان في مجال قيم الخير والمحبة والتضامن؟.(…) ومن المشتركات التي تملك الشعوب تنميتها أشكال متنوعة من التبادل الثقافي الذي تغتني به الشخصية الإنسانية على مستوى النظرة إلى العالم والقيم والخبرات الحياتية”. (تأطيرية الملتقى الرابع، ص-27-28).
-الخطاب يؤسس إمكانية اجتماعية عقلانية إيمانية تتيح الفرصة لأن يكون الفرد فاضلا بالضرورة
-الخطاب يقدم سردية دينية تركيبية جديدة وهي من أفضل سرديات الحداثة الراهنة
-فكر الشيخ المجدد يتمايز بغواية وجدانية رهيفة آسرة للعقل والقلب أو الروح
-الشيخ ابن بيه من العظماء الذين يعملون على بناء الحياة بالخير والجمال
ما يعني أن الخطاب يولي عناية جديدة برؤية متجدة لإغناء “الشخصية الإنسانية” بقيم التعايش السعيد والوئام والسلام.
والأمرُ عينُهُ؛ عندما يراجعُ الخطابُ فلسفة الكرامة الإنسانية في الثقافة المعاصرة، حيث يتجاوزُ البُعدين الحقوقيَّ والمعنويَّ، إلى مرتبة أَسمى، عندما يقرر أن “الكرامةَ الإنسانيةَ سابقةً في التصوّر والوجودِ على الكرامةِ الإيمانيةِ”، أي أن كرامة الإنسان قبل كرامة الإيمان؛ باعتبار أنّ الكرامة الإنسانيةَ تتمثّل بكينونة الذات التي سبقت التدين. وهذا يعني أن المحافظة على كرامة الإنسان من شروط الإيمان، وإلا لا معنى للإيمان مع هدر كرامة الإنسان.
إنّ الخطابَ عندَما يشدِّدُ على ضرورةِ مراجعةِ المنظوماتِ الحقوقية الكونيةِ، وبخاصّةٍ منها بعضُ قيمِ الحداثةِ المُعاصرةِ، وضرورة تطعيمِها بروحِ النواميس الإنسانية (إذا صحَّ التعبير)، فهو ينحو منحى التسامي؛ بمعرفة موضوعية عقلانية، تكاد تكون بدهية. فمثلاً عندما يقيّدُ الخطابُ “الحرّيّةَ بالمسؤوليّةِ”، إنّما هو يريدُ إمكانيّةَ المواءَمةِ أو التناسُبِ بينَ الظروفِ الإنسانيةِ واختلافِ الثقافاتِ أو البيئاتِ الثقافيةِ، وإمكانيةَ ترسيخِ مفهومِ المسؤوليّةِ؛ لتحقيقِ فكرةِ الإلزامِ الأخلاقيِّ طوعاً، الّذي يشكّلُ وازِعاً ذاتيّاً؛ ذلكَ لأنّ المسؤوليةَ وإنْ كانت بالجوهر وعيٌ حقوقي، ولكنها بالدرجةِ الأولى هي إحساسٌ ذاتيٌّ، يؤسَّسُ الوعي فيها علَى منطوقِ القيمِ الّتي نعتقدُها أو نؤمنُ بها، وهذهِ القيمُ هي الّتي تَحكُمُ اختياراتِنا وتصوغُ أهدافَنا في الحياةِ. وهو ما لا يمكنُ أن تُعلّمَنا إيّاه القوانينُ كما يجبُ أن تكون.
وهكذا؛ تكون الحريةُ المسؤولةُ؛ المقصودةُ في الخطابِ، إنّما هي إمكانيةٌ يرومُها الخطابُ أو هيَ وسيلةٌ تُرَشِّدُ “حرّيةَ التعبيرِ”، وتُعَقْلِنُ الممارساتِ الاجتماعيةَ فردياً أو جمعياً؛ باعتبارِ أنّ التناسبَ بين الحرّيةِ والمسؤوليةِ والإلزامِ؛ بموجبِ المسؤوليةِ الأخلاقيةِ أو بموجبِ الضميرِ الأخلاقيّ، هو مبدأٌ تمتدُّ جذورُهُ عميقاً في الفلسفةِ القرآنيةِ؛ بعكسِ ما تذهبُ إليهِ الحداثةُ الفلسفيةُ المعاصرة.
وعليه أظن إنّ الخطاب بما يمثّلُهُ مِن عقلانيةٍ إيمانيةٍ رائقة، ورافعةٍ قيميةٍ باذخة، وأنسنةٍ أخلاقيةٍ رشيدةٍ، إنّما هو يشكل سردية جديدة مِن أفضلِ سرديّاتِ الحداثةِ في الفكرِ الإنسانيِّ المعاصرِ. وهذا ما يجعلُ الشيخَ ابنَ بيّه “أحدَ أهمِّ رموزِ العقلِ الأخلاقيِّ والحكمةِ الإنسانيةِ في التاريخِ المُعاصرِ، وبخاصّةٍ في مجالَيْ القِيَمِ الإنسانيةِ المشترَكةِ، وبحوثِ الإنصافِ والسلامِ والتضامنِ”، كما يقول الدكتورِ رضوان السيّد في بحث له بعنوان “وثائق ومبادرات على طريق المواطنة الشاملة”. ولعلّ أقلَّ الدِّلالاتِ على ذلك، هذا القبولُ الواسعُ لخطابِ الشيخِ ابن بيه على مستوى العالم.
هامش:
*(1)-زهير بورهة، الرهانات المعاصرة للنزعة الإنسانية في الفكر الفلسفي الإسلامي، مؤمنون بلا حدود، ط – 2025، ص-7
-*(2) محمد الشيكَر، هايدغر وسؤال الحداثة، إفريقيا الشرق، ط – 2006، هامش 46 ص 82
-*(3) المرجع السابق، ص – 67،
-*(4) مونيس بخضرة (2009): تاريخ الوعي.. مقاربات فلسفية حول ارتقاء الوعي بالواقع – الدار العربية للعلوم ناشرين – منشورات الاختلاف -مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم برنامج “اكتب”- ص176 – ط1.
-*(5) انظر: براتراند راسل، المجتمع البشري، المكتبة الانجلو المصرية – القاهرة، ت، عبد الكريم أحمد، ص – 69-70.
-*(6) سورة التين ،الآية4
-*(7) صدرت طبعته الأولى 2023 عن دار هماليل، أبو ظبي