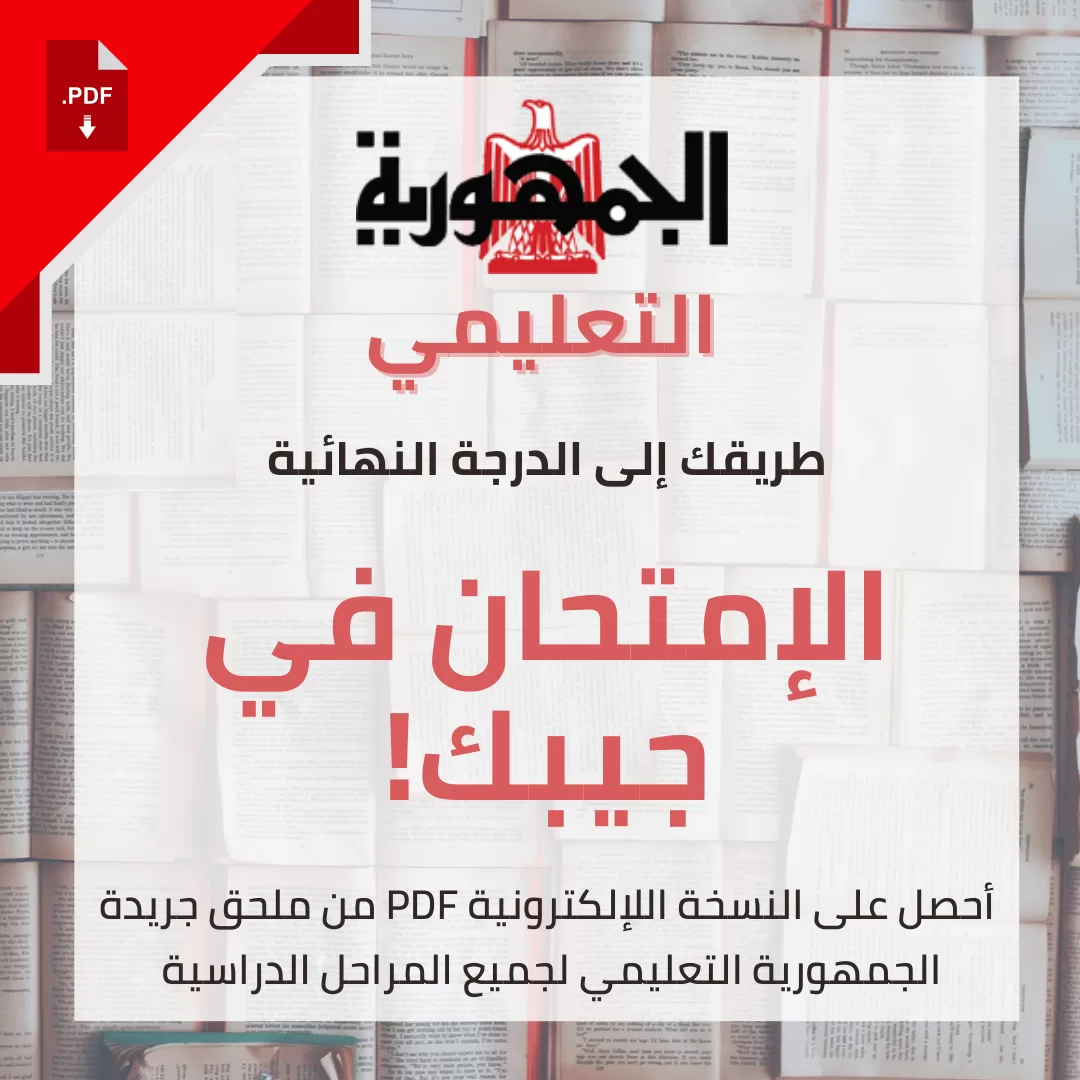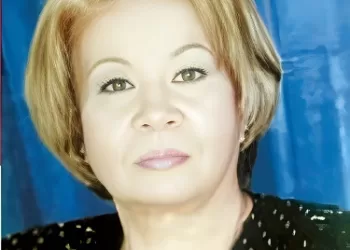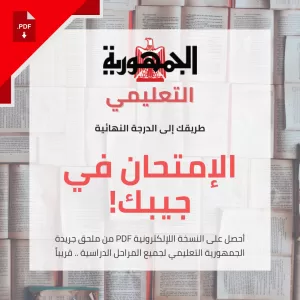التنوير المؤسس في خطاب الشيخ عبدالله بن بيه يعيد ترسيم مبادئ العلاقات الإنسانية في الإسلام
بقلم /فريال إبراهيم
- ” تنوير” عصر النهضة كان انتهازيا وخبيثا وبعيدا عن ” الأنسنة”
- إن الكرامة ليست حقًّا بين حقوق، بل مصدراً تنبع منه كل الحقوق الأخرى
- المشترك الإنساني هو القيم الكونية التي لا تختلف فيها العقول، ولا تتأثر بتغير الزمان، أو محددات المكان، أو نوازع الإنسان
- الحوار من أصل الدين ومن مقتضيات العلاقات البشرية
إن مصطلحي التنوير والأنسنة قد يبدوان وكأنهما (جدلياً) متقاربان بالمعنى؛ من حيث أن الأول يُفترض أن يفضي بداهة إلى الثاني، ولكنهما في الواقع ينطويان على محمولات دلالية متباعدة؛ لأنهما انتهيا طردياً في الحداثة الراهنة إلى نتائج متناقضة تماماً.
إن مفهوم التنوير باعتباره وليد عصر النهضة الأوروبية، إنما هو يحيل إلى الانتقال من عصر الظلام القروسطي إلى نور العقل أو العلم، وتكرس هذا المعنى بعد “ثورة الأنوار الفرنسية”، إلا أنه في واقع الأمر لم يكن بالمعنى المتسامي الذي يليق بمفهوم التنوير، كما يحيل إليه المصطلح على سطح المعنى، وإنما كان انتهازياً خبيثاً، بل وحشياً وبعيداً غاية البعد عن الأنسنة في بعض وجوهه؛ بمعنى أنه كان بمثابة تنوير للغربيين، وهمجي وحشي للآخرين، أي أنهم استعانوا بنور العقل أو العلم لا ليتخلصوا من ظلامهم فحسب؛ وإنما أيضاً ليشحذوا مخالبهم التنويرية (إذا صح التعبير) وغرزها بإنسانية الآخرين (المتخلفين) من خلال سيطرة استعمارية طالت ظلماتها واستطالت؛ حتى حصدت ما بين مئة وخمسين إلى مئتي مليون إنسان في الأميركيتين وأستراليا وآسيا وإفريقيا. وبعد حربين كونيتين، كان من دواعيهما التنويريين للأسف “تصورات للنقاء والاصطفاء العرقي، أسفرت عن واحدة من أفظع صور التطهير العرقي في التاريخ” *(1)
فتجلّت من خلالهما أقبح وجوه التنوير وأبشعها قسوة ومرارة. ومع ذلك صدقنا أن الظلمات أو أعطاب التنوير قد انتهى زمنها، حيث برقت ملامح الأنسنة بشرعة حقوق الإنسان وملحقاتها (حقوقٌ قانونيةٌ في المساواة أو العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحقوقٌ معنويةٌ في الكرامةِ والحريات، أيْ حرية التعبير والمعتقد والممارسة الثقافية). واقتنعت البشرية (وبخاصة أحرار العالم وبوجه أخص أحرار الجنوب) أنها تخلصت للأبد من عصور الظلام البدائية أو الوحشية. ولكن التجربة البشرية أثبتت مرة أخرى، أن قانون القوة أزاح قوة القانون، وقوة المصالح تقدمت على قوة الحق أو العدل، والتقدم العلمي بات في بعض وجوهه نقمة على الإنسانية، وأنتهى الأمر إلى ما لاحظه المفكر محمد وردي في كتابه “من أين ندخل إلى التسامح”* (2)
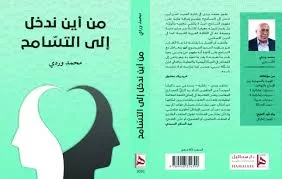
إن التزايد بوتائر التنوير العلمي والتقني، تترافق طردياً مع تزايد وتائر العنف والتوحش، ولن تكون أقل الدلالات على ذلك ما جرى في العقود الثلاث الأخيرة، بدءاً من أفغانستان ومروراً بالعراق ووصولا إلى غزة النازفة منذ نحو عام ونصف، حيث تكشفت أقبح وأبشع وجوه الحضارة الغربية، التي عصفت بكل ما خلدنا إليه من قيم في مخادع التنوير والأنسنة، فأعادتنا إلى بدائيات وحشية وهمجيات بربرية، أطاحت بما تبقى من أوهام وأحلام النخب الإنسانية قاطبة.. في هذا الزمن العصيب، زمن التحديات الكبرى التي تواجه البشرية، زمن “التجاذب بين اليقين والشك والضعف والقوة”، زمن “القلق واليأس والخوف والاغتراب، فضلاً عن العنف والإرهاب” والاحتراب زمن زعزعة المشتركات البشرية وهلهلة النواميس الإنسانية.. في هذا الزمن تَهِلُّ ملامح جديدة “للتنوير والأنسنة” في فكر العلامة الشيخ عبدالله بن بيه؛ كنقطة ضوء في عتمة مدلهمة، كبارقة أمل للإنسانية مختلفة في المبنى والمعنى؛ باعتبارهما تنويراً وأنسنة لا تتأسسان على الانتقال من الظلمات إلى النور، وإنما مؤسستان بالأصل على نور شعَّ وسطع على العالمين برحمانيته الفارهة وإنسانيته الباذخة، فامتلأت الأرض خيراً وعدلاً ونُبلاً، جمالاً وكمالاً؛ رغم أن ذلك النور الأول أضاء ظلاماً سحيقاً في تاريخ البشرية المديد، وليس قروسطياً فحسب. وما يمكن أن يأخذه البعض من مآخذ على التوسع والفتوحات، فهي خارجة عن سياق الأخلاق الإسلامية، ولا ترتبط بالإسلام مبدأ وشريعة وتطبيقا، وإنما ترتبط بسلوك الأشخاص الذين قد يسيئون إلى خلوص المبدأ وأصالته. ومع ذلك هي لا تعادل ذرة في بحر التنوير والأنسنة المزعومين اللذيّن لطخا وجه الحضارة الراهنة، وشوَّها روح الإنسانية في عصر ما بعد الحداثة، حيث غابت القيم، واستعيض عنها بتكنولوجيا من دون روح، وساد العنف، وأصبحت الأنانية سيدة هذا العصر الجديد، وراحت التقنية تقود الإنسان في اتجاهات ليس بمقدور أحد أن يتوقع نهاياتها.
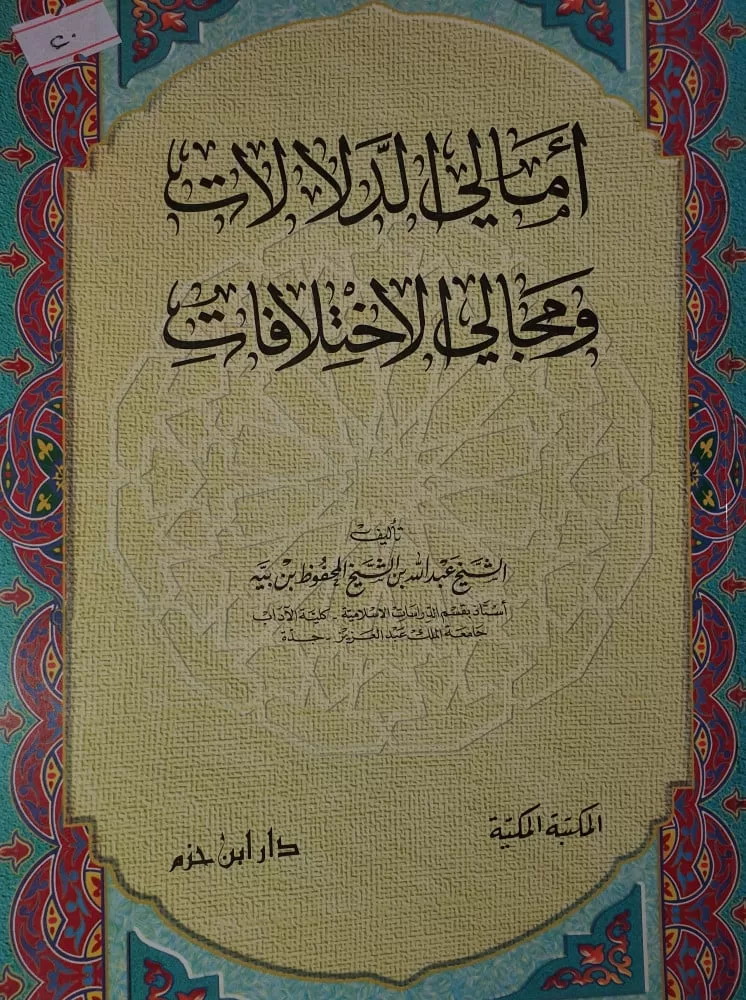
–ملامج جديدة “للتنوير والأنسنة” في فكر العلامة الشيخ عبدالله بن بيه
إن التنوير المؤسس في خطاب الشيخ عبدالله بن بيه على أصل النور الرحماني، يعيد ترسيم مبادئ العلاقات الإنسانية في الإسلام، وتنمية المشتركات البشرية وتعزيز ثقافة الحوار. أما المبادئ فهي أربعة::
أولا: أن الإسلام يعتبر البشر جميعاً إخوة، فيسد الباب أمام الحروب الكثيرة التي عرفها التاريخ الإنساني بسبب الاختلاف العرقي. والإسلام يعترف للبشر بحقهم في الاختلاف، عملاً بقوله تعالى “ولا يزالون مختلفين”*(3).
ثانياً: اعترف الإسلام للآخرين بحقهم في ممارسة دينهم، فسدَّ الباب أمام الحروب الدينية التي كاد التاريخ البشري أن يكون مجرد سجل لها
ثالثاً: اعتبر الإسلام الحوار والإقناع الوسيلة المثلى؛ بمقتضى قوله تعالى “وجادلهم بالتي هي أحسن”
رابعاً: اعتبر الإسلام أصل العلاقة مع الآخرين المسالمة التي تُقدم على بساط البرّ والقسط والإقساط. *(4). والنموذج الفذ لهذه التعددية هو “صحيفة المدينة””
أما تنمية المشتركات وتعزيز ثقافة الحوار، فمؤسسة في الخطاب على حقيقة أن جوهر الأديان؛ من حيث الممارسة العملية، إنما يقوم على تزكية النفوس لتُثمر الفضيلة ومحبة الخلْق أجمعين، وبالتالي من الأنفع للبشرية التعاون في مجال قيم الخير والمحبة والتضامن. فضلاً عن “أشكال متنوعة من التبادل الثقافي الذي تغتني به الشخصية الإنسانية على مستوى النظرة إلى العالم والقيم والخبرات الحياتية“.* (5) ويتجلى هذا الأمر بسُمُوٍّ في تقديم الإسلام الكرامة الإنسانية بوصفها أول مشترك إنساني، حسب قوله تعالى “ولقد كرمنا بني آدم” * (6)، فهي سابقة على الكرامة الإيمانية. وبهذا المعنى يكون “المشترك الإنساني هو القيم الكونية التي لا تختلف فيها العقول، ولا تتأثر بتغير الزمان، أو محددات المكان، أو نوازع الإنسان؛ لأن لها منابت وأصولاً تحفظها من عوادي الدهر وتعسفات البشر”*(7) ، ما يعني أن الخطاب يولي عناية جديدة برؤية متجددة لإغناء أو إثراء “الشخصية الإنسانية” بقيم الوئام والسلام، والتعايش السعيد.
(الحوار واجب ديني)
وأما الحوار في الخطاب فهو “واجب ديني وضرورة إنسانية، وليس أمرا موسميا. الحوار من أصل الدين ومن مقتضيات العلاقات البشرية”، باعتبار أن “أهم قيمة يمكن أن تكون مفتاحاً لحل مشاكل العالم، هي احترام الاختلاف، بل حب الاختلاف بحيث ينظر إليه كإثراء؛ كجمال، كأساس لتكوين المركب الإنساني”. ذلك لأن “التعدد هو سنة كونية وكذلك هو فطرة بشرية، فالناس من فطرتهم أن تخنلف رؤاهم وتصوراتهم ومعتقداتهم ومصالحهم”. “وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ” ويخلص الخطاب إلى أن “التعدد ناموس إلهي، سرى في الأكوان والرؤى والشرائع، ولم يكن الإسلام في يوم من الأيام إلا معترفا بهذا. المبدأ ومعلنا بضرورة احترامه كقيمة راسخة في الأخلاق الإسلامية *(8)

(رؤية عقلانية للأنسنة )
أما الأنسنة في خطاب الشيخ عبدالله بن بيه فهي مؤسسة على رؤية عقلانية إيمانية تجمع بين ما يجب أن يكون عليه الإنسان؛ بمقتضى النظر العقلي، وما يجب أن يكون عليه الإنسان في المنظور القرآني، أي بمقتضى التكليف الشرعي في عمارة الأرض بالخير والجمال. وهي رؤية ثلاثية الأركان ولكنها مترابطة جدلياً من حيث البنيان، “فلا تمام للإيمان من دون حب ولا حب من دون سلام”*(9) ، أي أن كمال الإيمان بالحب، وأن كمال الحب بالسلام، وهذا يعني أن السلام هو سنام محاسن الإيمان. ولذلك هو من أجلِّ المحاسن في الإسلام. وللحب في الخطاب مكانة سامية فهو “قيمة من أعظم القيم وشيمة من أمثل الشيم، فهو وحده الذي يقوي روح التواصل، وينسج لحمة التضامن والتكافل، ويعطي بعداً وجدانياً لعملية التبادل” *(10)
وهذا ما يجعل السلام يرتقي في الخطاب لأن يكون “فريضة باعتباره مقصداً أعلى من مقاصد الشريعة”، التي تقوم على مصالح الإنسان أو “حفظ نظام الأمة”؛ بتعبير الطاهر بن عاشور، التي بضوئها تتحتم ضرورة “إطفاء الحريق وإنقاذ الغريق، وإعادة بناء حصون السلم في النفوس، من خلال إعلان الحرب على الحرب”*(11) ،لكي تقوم قوائم السلام في رحاب المحبة والإيمان حسب دواعي العقل والحكمة، وهما أساس الإسلام وجوهر مبادئه وقيمه.
ويقدم الخطاب ذلك في تأويلية جديدة يجترحها من فلسفة الحق: إذا كانت المطالبة بالحق حقاً فإن البحث عن السلم أحق، وهو بحث لا يلغي أصل الدعوى، ولكنه سيغير وسائلها فما كل عدل أو حق أو إيمان أو طغيان يبرر وسائل أسوأ ونتائج أردأ”؛ باعتبار أن “أولوية السلام على الحقوق الثابتة أو المزعومة، مادية أو معنوية، فردية أو جماعية، دينية أو دنيوية؛ لأن الحقوق فرع عن السلام، فلا ثبوت لفرع دون أصل”*(12)
أما تعريف السلام في الخطاب فهو حالة من السكينة والطمأنينة تسود الأفراد والجماعات، حيث “لا عنف في اللغة، ولا اعتداء في السلوك، ولا ظلم في المعاملة”. ما يعني أن “السلم يُوجد بيئة الحب والسعادة والانتماء إلى الأمة والوطن والانخراط في مصالحه مع الغير، إنه قيم ونعم لا يدركها إلا من ذاق طعم الحرب” *(13).
ويكشف الخطاب أن وسائله في إحياء مبادئ وقيم السلم في الإسلام تقوم على “قراءة النصوص والاستنباط؛ لأنها هي المعضلة، وهي الحل، فالمشكلة في عمقها مشكلة خطاب التجديد الذي من شأنه أن يهيئ أرضية السلام، ولك أن تسميه ما شئت، سمه تجديداً أو مراجعةً، أو ثورة، أو إثارة، أو إحياءً، فخلاصة الأمر كله أنه ينبغي تجديد صياغة الخطاب الديني بإعادته إلى أصوله، وإعادة تركيب المفاهيم الحقيقية الصحيحة لغة وعقلاً ومصلحة ومقاربة إعادة برمجة العقول وتوجيه الإرادة إلى البناء بدل الهدم، والإيجاد بدل العدم، ومقارعة الحجة بالحجة لتحرير العقل بالدين وتبرير الدين بالعقل، فلا تفاوت ولا تناقض” * (14).

ويذهب الخطاب في منحاه الإنسانوي إلى ما لم تصل إليه الفلسفة القانونية في شرعة حقوق الإنسان، عندما يعتبر “أن الكرامة ليست حقًّا بين حقوق، بل مصدراً تنبع منه كل الحقوق الأخرى، وأن حمايتها ليست خياراً سيادياً، بل التزامٌ سياسيٌّ وقانونيٌّ ملزمٌ لمؤسسات الدولة” *(15). وذلك لأن الإطار الحقوقي أو القانوني للكرامة الإنسانية في النظريات والنصوص أو التصورات والأفكار، ليست هي عينها في النفوس، التي تتأسّس عليها الممارسة العملية، وإلا ما كانت الحروب، التي تقوم في الأصل ليس على انتهاك الكرامة وامتهان إنسانية الإنسان فحسب، بل على هتك أقدس أقداسه، ألا وهي الحياة؛ بذرائع ثقافية، دينية وعرقية وسياسية واقتصادية، وأحياناً بذرائع لا أنزل الله بها من سلطان، كما نشاهد ذلك كل يوم. وهذا ما يحيلنا إلى ما يسميه محمد وردي في تأسيس “إمكانية اجتماعية عقلانية إيمانية” واقعية أو عملية *(16)، تقارب موضوع الكرامة الإنسانية، انطلاقا من وعي أكمل وفهم أشمل بالذات الإنسانية المتفردة. وهو الأمر الذي يجعل تأسيسها في النفوس قبل النصوص أمراً ممكناً؛ بضوء وعي موضوعي مستمدٌّ من نور العقل، ليس حول حقيقة جذع “الأخوّة الإنسانية” المؤكد علمياً، كما يقول ميشال سار؛ باعتبارها حاجة إنسانية حاقّة فحسب، وإنما أيضاً باعتبارها رباطاً يعلو على اعتبار الجنس والنوع والتناظر، فيؤسّس تلقائياً “وعياً وجدانياً” سامياً، تنبني عليه محبة راقية ونبيلة، تنبع من القلب والروح، فتزيدنا يقيناً وإيماناً؛ بطبيعة الحياة العادية الممتلئة بالنعم التي ننشدها سواء في الأولى أو الآخرة؛ بكل ما تمثله هذه الحياة من مسرّات وسعادات؛ من حيث كونها نفعية وذاتية وتمثل غاية كلّية في وعي الإنسان. وهو ما يجعل الكرامة الإنسانية في الخطاب سابقة في التصوّر والوجود على الكرامة الإيمانية، التي تتقدّم بداهة على الكرامة العرقية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية؛ بمقتضى الفهم العقلاني لمقاصد الشريعة الإسلامية.
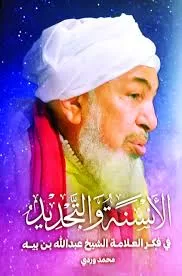
(إعادة هندسة إنسانية الإنسان)
ولا نبالغ إذا قلنا إن هذه المقولة في الخطاب تختزل جوهر ومضمون “الأنسنة” في معظم الثقافات أو الفلسفات المعاصرة؛ باعتبار أن الكرامة الإنسانية في الخطاب مؤسسة على وعي عميق بفلسفة روح الإسلام الرحمانية، فهي عندما تتقدّم على كرامة الإيمان، إنما هي تطمح إلى إعادة هندسة إنسانية الإنسان، كما أرادها له الله تعالى. وهي إعادة ليست ممكنة إلا في إطار روحي وجداني؛ بالمعنى الإيماني. ذلك لأن الكرامة السابقة على الإيمان، تعود في القراءة الدلالية إلى ما يحيله “التقويم والتكريم والتفضيل” الإلهي؛ باعتباره أصل في مبتدأ الخلق أو فاتحة الوجود. ما يترتب على ذلك؛ تقديم الكرامة الإنسانية في حلّ جميع المعادلات الوجودية السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ بفاعلية وجدانية وعقلانية متجدّدة ومستمرة من دون توقف. الأمر الذي يتيح إمكانية تحقق الفاعلية الوجودية للإنسان بالمعنى الحداثي، الذي راح يربط مفهوم الكرامة الإنسانية بالتصورات والأفكار حول طبيعة أو معنى الحياة التي تستحقّ أن نعيشها، ليس على مستوى الحقوق والحريات العامة فحسب، وإنما أيضاً وبشكل خاص على مستوى تعريف مفاهيم الحياة التي نستحق أن نعيشها؛ بالمعنى الفردي، والتخطيط لها ذاتياً؛ من دون تدخل أو إكراه.
ويتوضح الجوهر المؤنسن في الخطاب على مستويين متكاملين، بمعنى أن الأول يكمّل الآخر، والعكس صحيح:
المستوى الأول، يقدم الخطاب كرامة الإنسان على ما عداها؛ حتى على الإيمان؛ على الرغم من التصوّر الأولي الذي يفترض أن يكون الإيمان هو طوق النجاة الأخير للإنسان في مختلف الفلسفات الروحية، إلا أن دلالات الخطاب تروم القول: إن كرامة الإنسان، هي الأصل والمعيار في أنسنة الوجود، كما أرادها الله أن تكون؛ كتعبير عن خلاصة الحضور الإنساني الفاعل في الوجود، الذي يُفترض أن يحاسب الإنسان عليه أو يُثاب؛ باعتبار أنه الكائن الحر الذي يشعر بوجوده الطليق؛ خارج أية قوة سالبة لوجوده الأصيل، وجوده الذي تقرّره حرية الكائن على أي نحو يكون. فمعنى الحرية في مفهوم الكرامة الإنسانية كما في الخطاب، لا يبتعد عن مفهوم الحرية في الفلسفة المعاصرة؛ باعتبارها صفة ماهوية للإنسان، بحيث يستحيل على الكائن أن يكون إنساناً حراً؛ بوعيه بذاته، ووعيه بالآخر، خارج مفهوم الكرامة الإنسانية. فمن أهم معايير الكرامة أن تفعل ما تمليه عليك ذاتك بإرادة حرّة؛ دون خرق حقّ أحد من الناس، أو دون الاعتداء على حقّ أحد؛ سواء أكان الحقّ طبيعياً أو قانونياً، وأن ترفض وتغضب؛ بل تثور حين تُحمل على فعل ما لا تريد، أو حين تُغتصب حقوقك المادية أو المعنوية؛ لأنها تمثلاً هدراً أو استباحة وامتهاناً للكرامة الإنسانية.
المستوى الثاني، عندما يقدّم الخطاب كرامة الإنسان على كرامة الإيمان، فهو لا يصوب على العطب الذي أصاب الفكر الإسلامي المعاصر؛ نتيجة الخطأ أو الجهل في التعامل مع المفاهيم الإسلامية، وسوء تنزيلها على الواقع، واستطراداً يصوب الخطاب على مقاتل العقل في الشخصية العربية والإسلامية، التي وقعت أسيرة النقل والنمطية؛ منذ القرن السابع الهجري، حيث دخلت في أزمة فقهية وفكرية؛ نتيجة ما سمّاه الخطاب “الجمود على المنقولات”.. ليس هذا فحسب، وإنما يصوب الخطاب أيضاً على ضرورة إعادة النظر بالطبيعة البشرية، من منطلق أن الذات الإنسانية فريدة ومتفردة. وهذا يختزل ما أصاب الفكر الإنساني عموماً من تعطيل أو خلل؛ باعتباره ساعد على تنميط الذات البشرية، حيث وقف عاجزاً أمام التحوّلات العولمية التي تستبيح إنسانية الإنسان وتهدر كرامته؛ بل تعيد عبوديته في كل آن وحين؛ بأشكال متعدّدة وذرائع لا أنزل الله بها من سلطان، مثل دواعي الحاجات الزائفة، التي نظنها رئيسة في تحقيق سعادة، تختزلها تمظهرات الرفاهية واللهاث وراءها؛ مهما عزّت التضحيات من أجلها؛ سواء أكانت وقتاً وراحة أم كانت أخلاقاً وديناً. وعلاوة على ذلك، فالخطاب هنا يتجاوز ما انتهت إليه الحداثة الفلسفية، وبخاصة على مستوى تقديم الكرامة الإنسانية في إطار يتجاوز خلاصة فلسفة الغيرية والفئوية والأنوية الضيقة، المنتظمة في الأطر الحقوقية والقانونية الحديثة. فيؤسّس الخطاب الحياة النامية التي تطمئن لها العقول وتهواها النفوس وتميل إليها القلوب، تلك الحياة الممتلئة بالمسرّات والسعادات في العاجلة والآجلة.
هوامش:
1-العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، تأطيرية الملتقى الخامس لمنتدى أبوظبي للسلم، ص-17
2- صدر عام 2020 عن دار هماليل، ولمؤلفه أيضا “دروب الحداثة” و”سرديات عربية” وغيرها
3- هود، الآية 119/118
4-تأطيرية الملتقى الرابع، ص-58-59
5-المرجع السابق، ص-28
6- الإسراء، الآية 70
7-تأطيرية الملتقى الرابع ، ص 62-63
8-راجع: كلمة الشيخ بن بيه في
“حوار الشرق والغرب -نحو عالم متفاهم ومتكامل”، الذي عقد في أبوظبي / 2016
9-تأطيرية الملتقى الأول- ص-25
10- راجع : كلمة الشيخ عبدالله بن بيه في افتتاح “المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية – مخاطر التصنيف والإقصاء”، الذي نظمته “رابطة العالم الإسلامي”، وعقد في مكة المكرمة / 12-13 ديسمبر 2018
11- تأطيرية الملتقى الثاني، ص- 38-39
12- تأطيرية الملتقى الأول، ص/33-32
13- السابق، ص-35
14-السابق، ص-40-41
15-راجع: العلامة الشيخ عبدالله بن بيه – الكرامة الإنسانية بين الحقوق والواجبات
16- كتاب “الأنسنة والتجديد في فكر العلامة الشيخ عبدالله بن بيه” – محمد وردي، ط/ 2023/ دارهماليل”