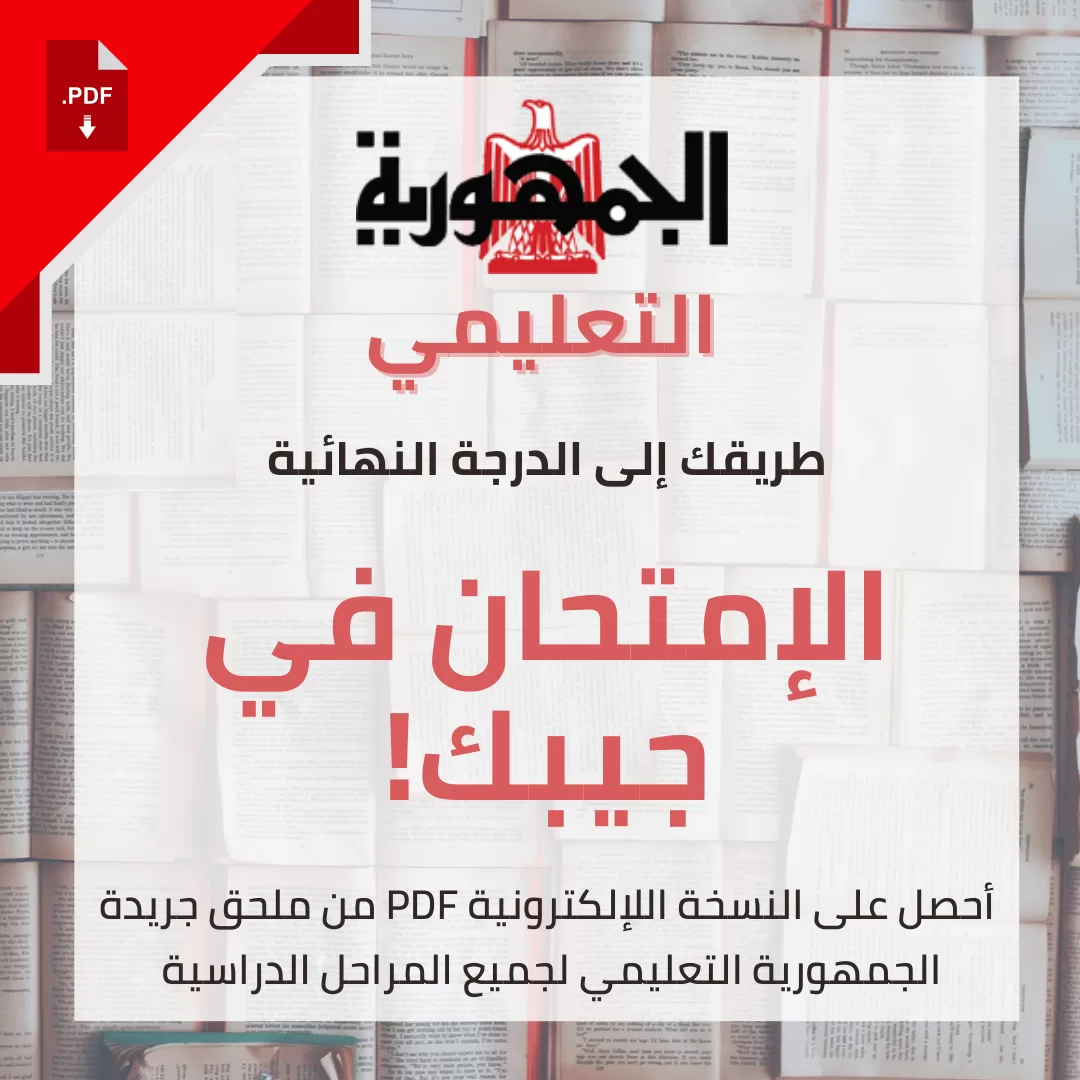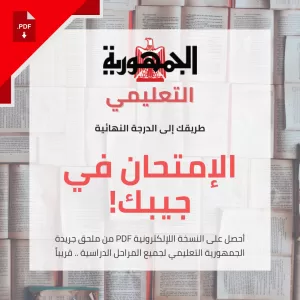لماذا تلجأ إسرائيل لـ«عسكرة» غزة وأخواتها؟
الفكرة الأمنية توأم للمشروع الصهيونى.. السلاح يحسم الأرض والقوة ترسم آخر حدودها
الإعلام جبهة موازية.. روايات مزيفة تعوض نقص الإنجاز العسكرى
تحليل : أحمد بديوى
منذ اللحظة الأولي، أدرك قادة الحركة الصهيونية أنّ مشروعهم المزعوم لا يعتمد على أبعاد توراتية، ولا على حنين رومانسى إلى «أرض الميعاد» كما يروجون.. يقوم المشروع على رؤية نفعية تفهم توازنات القوة العالمية وتتحرك تحت مظلتها.. كانوا على يقين بأنّ الوعود لن تنتزع الأرض، والتعهدات لن تصونها.. السلاح وحده يحسمها، والقوة ترسم آخر حدودها.. لذا، صاغوا الفكرة الأمنية كـ»توأم» لمشروعهم.. جعلوها تسكن قلبه، لا أطرافه.
تحوّلت الحركة من الهامشية فى أوروبا إلى مشروع عالمى مدعوم من قوى استعمارية بعدما رسخ لها فلسفيًا وسياسيًا (موسى هس، ليو بنسكر، تيودور هرتزل، أحاد هعام، وإسرائيل زانغويل)، تنظيميًا ودبلوماسيًا (ماكس نوردو، حاييم وايزمان، ناحوم سوكولوف، دافيد بن غوريون، مناحيم أوسيشكين، زئيف جابوتنسكي، وموشيه شاريت)، ماليًا (إدموند دى روتشيلد، موسى مونتفيوري، وإسحاق روتشيلد)، وسياسيًا (هربرت صموئيل، لويس براندايس، وفيليكس فرانكفورتر).
لم يطرح قادة المشروع المؤسِّس لـ»إسرائيل» الأمنَ كشعار يستهدف طمأنة المستوطنين الجدد إلى «الأرض المنهوبة»، بل جعلوه شرطًا لبقاء الفكرة ذاتها. فالأمن يمهّد طريقهم نحو التهويد، ويحمى المستوطنات، ويمنح مشروعهم مكانةً فى عيون قوى كبرى كانت تبحث عن قاعدة متقدمة لها فى الشرق. لذلك لم يكن غريبًا أن تتشكّل الحركة منذ بداياتها عصاباتٍ ثم جيشًا، معسكرًا كبيرًا قبل أن تكون دويلة معترفًا بها، وإن كانت تفتقد شرعيتها إنسانيًا وأخلاقيًا.
زادت قناعتهم بأن ما يُسمّى بـ»هاجس الأمن» ليس قيدًا يحدّ من المشروع، بل محرّكه الأول، يحكم كل سياسة، من الاستيطان إلى التهجير، ومن التحالفات الدولية إلى الحروب المتكرّرة.. جميعها تندرج تحت هذا العنوان الكبير، حتى إنّ استمرار مشروع الحركة (وفق مخطّطها الرئيسي)، يكمن فى هذه العقيدة التى ترى أنّ الوجود نفسه فعل أمني، وأنّ أيَّ تراخٍ أو تراجع أمام البيئة المحيطة يُعَدّ «انتحارًا» سياسيًا وتاريخيًا للإسرائيليين.
حين قامت «إسرائيل» عام 1948، عرفت أنّها محاطة بعالم عربى يرفض وجودها فى المنطقة.. أدركت أنّها تقف على أرض تفتقر إلى العمق الجغرافى الذى يحميها، فلا شرعية تمنحها الاستقرار، ولا بيئة إقليمية توفر لها الاعتراف.. ربطت أسباب بقائها بالقوة وحدها، وجعلت مصيرها قائمًا على تكثيف العدوان كبديل عن الحق الذى تفتقده. ومن هنا سارع قادتها إلى صياغة نظرية أمنية تحوّل القلق إلى خطط، والخوف إلى عقيدة ثابتة.
وضع، ديفيد بن جوريون، الأسس الأولى لـ»العقيدة العسكرية» الإسرائيلية التى تزعزع استقرار المنطقة منذ عقود حتى اليوم.. قامت على 3 ركائز: توجيه ضربات استباقية تمنع تضخم الخطر، نقل المعركة بعيدًا عن حدود إسرائيل الضيقة، ثم حسم الحرب بسرعة خاطفة تحرم الخصوم من استغلالها.. عقيدة، شكّلت إطارًا وجوديًا يحدد طريقة تعامل إسرائيل مع محيطها، ويضع قواعد توازنها مع الأرض التى احتلتها ومع حالة العداء (المشروعة) التى تواجهها.
مع مرور الوقت أظهرت «العقيدة العسكرية» الإسرائيلية المدعومة من قوى دولية معادية قدرتها على التوسع… تفرعت عنها عقيدة الردع النووى التى منحتها «سلاح الظل» لمواجهة أى مغامرة كبري، ثم تبلورت استراتيجيتها «المعركة بين الحروب» التى تستخدم الضربات المتقطعة لشراء الوقت وتأجيل الانفجار الكبير، وظهر مفهوم «كيّ الوعي» لإرغام الخصوم على الاستسلام النفسى قبل العسكري، وهكذا تشكّلت مدرسة أمنية كاملة تعيد إنتاج نفسها.
المجتمع العسكري
منذ تأسيسه لم يكن الجيش الإسرائيلى مؤسسة منفصلة عن المجتمع أو مجرد كيان دفاعى تقليدى عنه، بل كان العمود الفقرى الذى يتغلغل فى الدويلة الناشئة ويعيد صياغة مواطنيها على مقاسه.. التجنيد الإجبارى لا يمثل واجبًا عسكريًا فقط فى إسرائيل، بل طقس عبور يربط الفرد بعصب الدولة، يزرع داخله قناعة بأن وجوده الشخصى مرهون بقدرة جيش (الاحتلال) على الحماية.. وبصهر المهاجرين والغرباء فى بوتقة واحدة تماهت الحدود بين الهوية الفردية والهوية العسكرية.
هذا التداخل أنتج ظاهرة جعلت العسكريين الإسرائيليين يلعبون دورًا مركزيًا فى النخبة السياسية المحلية منذ نشأتها. من بن جوريون، الذى أسس «العقيدة العسكرية»، إلى موشيه ديان، مرورًا بإسحاق رابين، شمعون بيريز، إيهود باراك، وأرييل شارون، جاء كثير من قادة النخبة السياسية من داخل المؤسسة العسكرية نفسها.. قاعدة تحدد المشهد السياسى وتوضح أن «الدولة» لم تُبنَ فى حضن السياسة المدنية، وأن بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة مجرد استثناء.
هذا التماهى بين جيش الاحتلال والمجتمع الإسرائيلى يكشف عن هشاشة أساسية فى المشروع الصهيوني. دويلة تعتمد على القوة المنظمة لضمان استقرارها، تواجه تحديات مستمرة، ومشروع يجد ضمانته أساسًا فى السلاح يدرك أنه مرفوض فى محيطه. هنا تتجلى المفارقة: ما يبدو للعلن مجرد عامل قوة يتحول إلى مؤشر خطِر مفاده أن البقاء مرتبط بالقدرة العسكرية، وأن أى اختلال فى هذه البنية قد يهز أسس المشروع من الجذور.
بيئة متوترة
لم يكتفِ الاحتلال بحصانة جيشه وعتاده، بل بنى عالماً موازياً من الأجهزة الاستخباراتية التى تلتقط الأنفاس قبل أن تتحول إلى فعل.. جهاز «الموساد» يمد أذرعه إلى الخارج، والأمن الداخلى «الشاباك» يطارد الداخل، وشعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» لا تقل سطوة.. شبكة كاملة لا تكتفى بجمع المعلومات بل تصنع بيئة أمنية متوترة تُحكمها الرقابة ويُدار فيها الخوف كأداة سياسية فى إسرائيل.
وسط هذه المعطيات تحول الشعب الفلسطينى إلى «ملف أمني» دائم، هدفٍ ينبغى تفكيكه ومطاردته بلا انقطاع. كل تفاصيل الحياة اليومية تتحول إلى ساحة مواجهة: استراتيجية تحول الإنسان إلى هدف والمجتمع إلى بنك معلومات. الهوس الأمنى الذى يطارد الفلسطينيين لم يحرر الإسرائيليين من خوفهم، بل جعلهم أسرى له؛ إعادة إنتاج لخطاب الطوارئ يغذى شعورًا دائمًا بالتهديد، كأن المشروع لا يستطيع أن يستمر إلا إذا ظل معلقًا على فزاعة الخوف.
لا يقتصر الدور الأمنى على رصد الحركة أو تحجيم المقاومة، فقط، يمتد إلى إعادة تشكيل وعى المجتمع الإسرائيلى نفسه: الإعلام، التعليم، الثقافة، وحتى الخطاب السياسي، كلها خيوط فى شبكة تهدف إلى ترسيخ الهوس الأمنى كحقيقة يومية.. بهذا الشكل، يتحول الخوف من أداة دفاعية إلى حالة مستمرة من الانضباط الذاتى والطاعة المجتمعية، بينما الفلسطينى يظل الهدف، والدولة الراعية للخوف تبقى هى الحاكم المطلق فى كل تفاصيل الحياة.
«الديمقراطية» المزعومة
يحبّ الاحتلال أن يطلّ على العالم بوجه «الديمقراطية الوحيدة!» فى الشرق الأوسط.. يتصرّف كأنّه جزيرة حقوق وحريّات وسط محيط غاضب.. لكن الوجه المزعوم لا يُخفى حقيقة المشروع العسكرى لإسرائيل، بل يضاعف فضائحه.. أى ديمقراطية هذه التى تُبنى على استبعاد الفلسطينيين؟ أى حياة هذه التى يُعاد هندستها ليصبح أصحاب الأرض «رقمًا أمنيًّا» أو «تهديدًا كامنًا»؟ ديمقراطية وهميّة، مصطنعة.. تُفتح أبوابها للمستوطن، وتُغلق فى وجه صاحب الحق.
لا يمكن التغاضى (مهما تواطأ الحلفاء) عن ممارسات فصل عنصرى دقيقة ومدروسة.. السيطرة العسكرية تتقدّم يدًا بيد مع محو الرموز الثقافية والهوية الوطنية.. الجدار الفاصل ليس إسمنتًا، فقط، بل حدود تُعيد تخطيط الذاكرة.. حصار يُفرض على الحلم. والقوانين التى يمرّرها الكنيست، ليست تشريعات إدارية، بل أدوات لترسيخ التمييز رسميًّا، وتحويله إلى واقع يومي.. لم يعد الأمر مضايقات متناثرة. بل طرد من الأرض نفسها.
يزداد المشروع الصهيونى انكشافًا مع كل إخفاق فى إقناع المنطقة والمجتمع الدولى بوجود إسرائيل.. وحين تعجز رواية الاحتلال عن الإقناع، تتقدم القبضة الأمنية المشدودة وصورة الخطر المتضخّم. يترجم الكيان كل أزمة إلى تصعيد.. وكل ارتباك يُعالج بتذكير الداخل بأنهم يعيشون فى خطر أبدي.. الأمن يتحوّل إلى غطاء.. والغطاء يخفى أزمة أعمق: أزمة مشروع لا يجد مكانه إلّا بالقوّة، ولا يستطيع العيش إلّا بتجديد الخوف.
سقوط القوة
فى محطات كبرى كـ1967 و1973 و1982، سعت إسرائيل إلى تكريس صورة «الجيش الحاسم» و»الذى لا يُقهر».. كانت الحروب بمثابة عمليات اختبار؛ الهدف منها تثبيت صورة الكيان كقوة مطلقة تفرض شروطها على المنطقة.. لكن مع كل مواجهة، كان يطلّ جانب آخر من الحقيقة: مجتمع لا يتحمل الاستنزاف الطويل، وجيش يتردد أمام الخسائر البشرية، ودولة تدرك أنّ الداخل قد يهتز بسرعة إذا طال وقت المعارك.
منذ نشأتها، أدركت إسرائيل أنّ أمنها لا يعتمد على مواجهة التهديدات الخارجية، بل على الجبهة الداخلية أيضًا. الجبهة الداخلية ليست مجرد حاضنة، بل هى خط الدفاع الأول الذى يحدد صلابة الردع الخارجي. أى تصدّع فى المجتمع يُترجم فورًا إلى ضعف فى صورة الجيش. أى اهتزاز فى المعنويات يُقرأ فى عواصم المنطقة كنافذة يمكن النفاذ منها. من هنا، كان الربط بين الداخل والخارج جزءًا عضوياً من العقيدة الأمنية، لا تفصيلًا ثانويًا.
لم يتردد الاحتلال فى تسخير الإعلام والرمزية العاطفية لتثبيت تماسكه. قصص «مصنوعة» تبدو للوهلة الأولى مجرد حكايات إنسانية، لكنها فى العمق أدوات مدروسة لإعادة إنتاج العصب الوطني. تُروى القصة بقدر من التراجيديا يكفى لتغطية الفشل العملياتي، وتحويل الهزيمة إلى رواية وجدانية تُلهم الداخل وتستدر تعاطفه. إنها صناعة متعمدة للذاكرة الجماعية، حيث تختلط العاطفة بالأمن.
سلاح الرواية
هكذا يتحوّل الإعلام الإسرائيلى (على تنوع مواقفه، أشكاله ورسائله)، إلى جبهة موازية، لا تقل أهمية عن ترسانة الأسلحة المتقدمة. الرواية تصبح سلاحًا، والدراما الفردية تتحول إلى وسيلة لإخفاء التصدعات الداخلية.. ما يبدو قصة حب فى ظاهرها يخفى فى باطنه محاولة لتعويض نقص فى الإنجاز العسكري، والتغطية على محدودية القدرة أمام خصم يعرف كيف يطيل المواجهة ويكشف ثغرات «الجيش الذى لا يُقهر».
هذا الضعف الكامن دفع إسرائيل فى العقود اللاحقة إلى تغيير قواعد اللعبة.. بدلاً من الحروب التقليدية المفتوحة، وجدت نفسها فى مواجهة خصوم غير تقليديين.. فصائل لا تملك جيوشًا نظامية، ولا أسلحة ثقيلة، لكنها تمتلك عناد الإرادة وأدوات بديلة (أنفاق تمتد تحت الأرض، صواريخ دقيقة تخترق المعادلات، ومجتمع يرى فى الصمود نفسه سلاحًا).. هنا انقلب المشهد، ولم تعد العقيدة القديمة قادرة على توفير الإجابة.
انكشفت المفارقة.. جيش يمتلك ترسانة هائلة من التكنولوجيا والاستخبارات، لكنه يفتقد القدرة على حسم صراع مع مقاومين يتوارون فى الأزقة والأنفاق. وما كان يُقدَّم كضمانة للتفوق الإستراتيجي؟ تحول إلى عبء يفضح محدودية القوة حين تُواجه بإرادة لا تُقاس بموازين الحديد. صورة «الجيش الذى لا يُقهر» باتت مثقوبة.. تلاحقها أسئلة عن مستقبل مشروع يعتمد على الردع، لكنه يعجز عن ترجمة هذا الردع إلى نصر حاسم، فيحاول توظيف «المظلوميات».
خطاب «الضحية»
منذ بداية الفكرة الصهيونية، لم يكن خطاب «الضحية» مجرد مزاعم تاريخية، بل ركيزة سياسية وأخلاقية لتبرير مشروع استيطانى يقوم على الإزاحة والإحلال.. المأساة الأوروبية وُظفت لفتح أبواب فلسطين، والحكاية صيغت بحيث يظهر المستوطن القادم لا كقوة اقتلاع، بل كلجئ يبحث عن ملاذ آمن.. هكذا تحوّلت المظلومية إلى جواز سفر أخلاقي، يُستخدم فى المحافل الدولية لإخفاء حقيقة المشروع ومحو سردية السكان الأصليين.
لكن هذا الخطاب؟ لم يكن معزولاً عن البعد الأمني– العسكري.. على العكس، كان غطاءً دعائيًا يرافق كل توسع وكل اجتياح. إسرائيل تُقدَّم كـ»شعب صغير محاط بأعداء يتربصون بإبادته»، وفى الوقت نفسه تمارس أوسع عمليات التهجير وتبنى ترسانة عسكرية متطورة.. هذه المفارقة ليست صدفة، بل خيار خبيث: تسويق المظلومية فى الخارج لتسهيل توظيف القوة فى الداخل.
ومن هنا يتكشف التناقض الفاضح: استعطاف العالم بلغة الضحية، واستخدام القوة بلا قيود تحت ذريعة البقاء. خطاب المظلومية يمنح الغطاء، والآلة العسكرية تنفذ التوسع. وما بين الوجهين؟ تُطمس الحقيقة: المشروع الذى يرفع راية النجاة لا يمكن أن يستمر إلا عبر ممارسة العنف، وأن «النجاة» نفسها تحوّلت إلى مبرر دائم للحرب.
معركة الصورة
اللافت أن خطاب الاستعطاف؟ لم يُترك للصدفة.. جرى تصميمه بعناية فى مطابخ السياسة والإعلام. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرك أنّ معركة الصورة لا تقل خطورة عن معركة السلاح، وأن الكاميرا أحيانًا ترجح كفة الرواية أكثر مما تفعل الطائرة أو الدبابة.. لهذا، وُضعت إستراتيجية متكاملة لإنتاج مشاهد تختزل الصراع فى صورة عاطفية تُلغى الأسئلة الكبرى وتبقى على سردية «الضحية» حية ومتجددة.
من هنا، يصبح مشهد «مدنى يركض مذعورًا إلى الملاجئ» جزءًا من خطاب الأمن، لا مجرد لقطة عابرة.. الصورة تُبثّ على الشاشات لتقول للعالم إن الإسرائيلى مهدد فى حياته اليومية، وإن دولته لا تملك خيارًا سوى الدفاع عن نفسها.. وهكذا، تتحول اللقطة الإنسانية إلى ذخيرة سياسية، وتُستثمر للحصول على تعاطف يشرع ما يجرى فى الميدان من قصف ودمار.
فى المقابل، يُمحى السياق الأوسع للعدوان.. صورة البيوت المهدمة فى غزة؟ تُغيب. الأمهات اللواتى يفتشن عن أطفال تحت الركام؟ يُسدل الستار. الأسرى الذين يواجهون السجون لا يظهرون.. تُختزل الرواية فى نصفها الإسرائيلى وحده، بينما تُسدل ستائر كثيفة على مأساة الفلسطينيين. إنها عملية إعادة إنتاج متواصلة: تضخيم صورة الضحية الإسرائيلية، وإنكار رواية الفلسطينى باعتباره الدائم خارج الكادر.
الحجم الحقيقي
رغم الضجيج الذى يثيره الاحتلال بسلاحه وإعلامه، إلا أنّ صورته أكبر من حجمه الحقيقي.. ليس هذا «البعبع» الذى رُسم فى المخيلة العربية عقودًا، بل كيان يعيش على قلقه الدائم.. قوته الفائقة؟ مشروطة بقدرة محدودة على الاحتمال، ومردودة تتآكل كلما طالت المعركة أو ارتفعت كلفة الدم.. وما يخشاه قادته أكثر من أى سلاح، أن يتسرب الوهن إلى الداخل، وأن يفقد المجتمع ثقته بتفوق جيشه.
هذا الواقع يفتح ثغرات لم يعد بالإمكان إخفاؤها.. جيش مدجج لا يستطيع أن يحسم مواجهة مع مقاومين يتحركون تحت الأرض أو خلف الجدران، ودولة نووية تضعف أمام صاروخ محلى الصنع يشلّ مطارًا أو مدينة.. الخطاب الأمنى الذى وُلد ليكون مصدر طمأنة؟ تحول إلى اعتراف ضمنى بأن بقاء المشروع مرهون بتجديد الخوف، وأن أى اختلال فى المعادلة يكفى لفضح هشاشته أمام خصومه وحلفائه على السواء.
الاحتلال الإسرائيلى ليس قدراً يتعذر كسره، بل تجربة استيطانية تعيش فى ظل القلق وتتهددها عوامل ضعف متراكمة. ومع كل اختبار جديد، تتسع الفجوة بين صورة القوة وحقيقتها.. والرهان يبقى على قدرة أصحاب الأرض على الصمود والاستنزاف، لأن إرادة القتال التى أثبتت جدواها هى وحدها القادرة على نزع سلاح «الخوف» الذى بنى عليه المشروع نفسه.
المشروع المهدد
إذن، يمكن التوقف عند حقيقة أساسية: المشروع الصهيونى لم يولد كفكرة مدنية، بل كتركيبة عسكرية- أمنية تبحث عن البقاء بالقوة.. الشرعيته السياسية ظلت موضع نزاع، ربط وجوده دائمًا بتفوق عسكرى يُفترض أنّه كفيل بترجيح كفته فى ميزان المنطقة.. السلاح كان اللغة الوحيدة التى يفهمها الكيان، والجيش هو المؤسسة التى تمنحه شكله وهويته.
لكن التفوق لم يكن مطلقًا، بل مشروط ومهدّد.. كلما ارتفعت قدرة المقاومة على الصمود والاستنزاف، انكشف الوجه الآخر للمشروع.. دويلة لا تحتمل طول المعارك، مجتمع يتململ من الخسائر، مؤسسة عسكرية تعجز عن ترجمة قوتها التقنية إلى حسم نهائي.. عندها يسقط القناع الأمني، ليظهر الكيان بوصفه مشروعًا هشًا يعيش فقط بقدر ما يُمارس العنف، لا بقدر ما يُقنع بشرعية وجوده.
من هنا تتبدى المفارقة المريرة: «الأمن» الذى يتم تسويقه كضمانة للبقاء، يتحول فى العمق إلى سلاح ذى حدين.. يمنح الاحتلال فرصة مؤقتة من الاستمرار، لكنه يفضحه أمام العالم ككيان أسير للحرب، لا يعرف الحياة إلا فى ظلها.. إنه مشروع لا يستطيع أن يتنفس من دون القتال.. مستقبله مرهون بدوام الخوف.. مصيره مرتبط بمسار صراع لا يملك مفاتيح إنهائه.