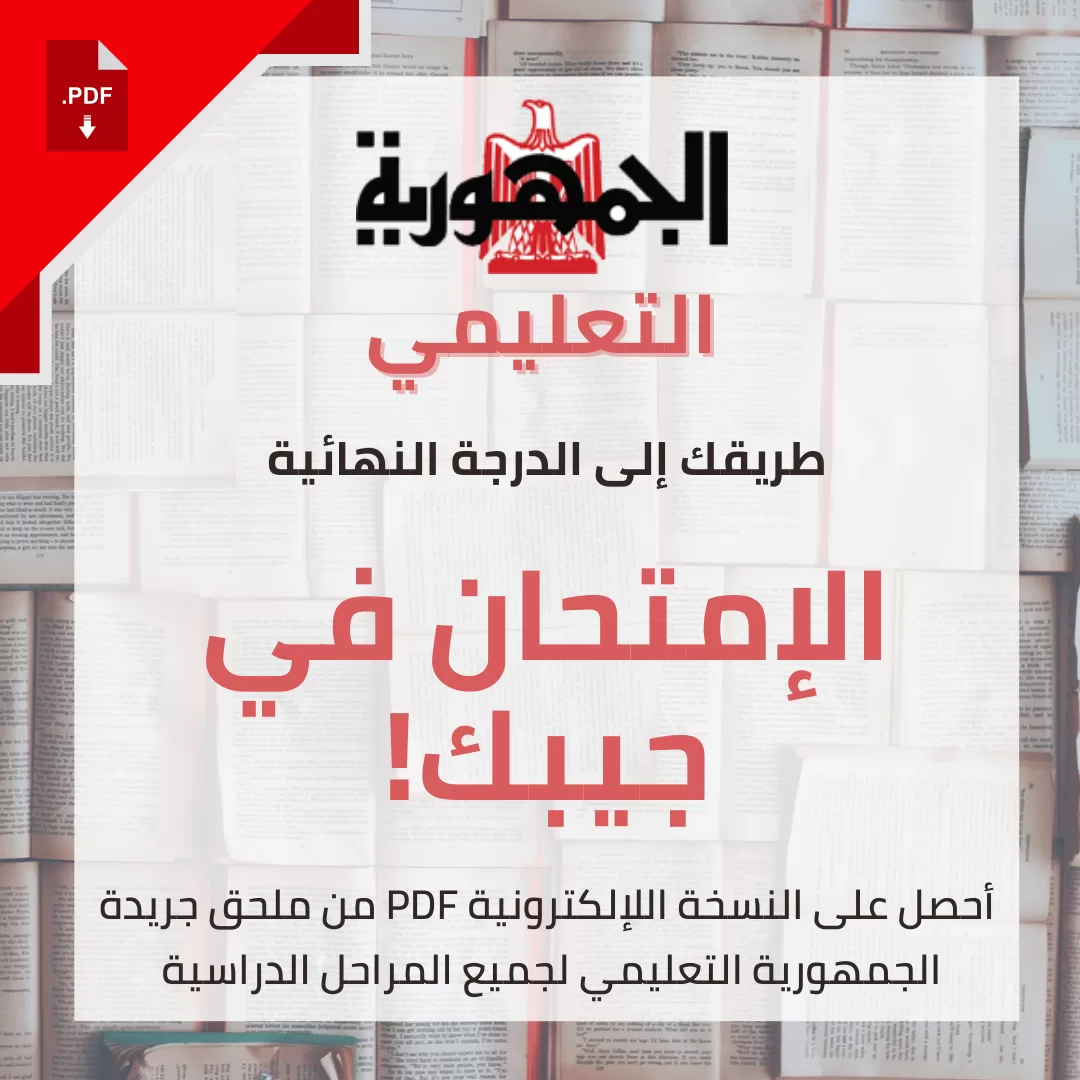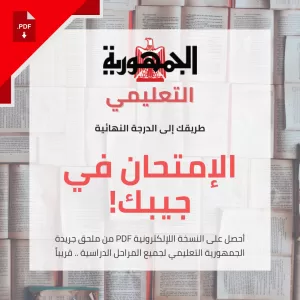محمد وردي
قد يبدو للوهلة الأولى وكأن مصطلح “التنوير الحضاري” من نوافل الكلام؛ باعتبار أنه يحيلنا إلى ما درج عليه الوعي من حيث الإشارة إلى عملية التمدن والحداثة الثقافية (عموماً) التي سادت أوروبا في القرن الثامن عشر، ولكن موضعته من حيث تخصيص الإحالة في خطاب العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، يجعل له (كما نعتقد) مغزى مختلف أو معنى مغاير، إلى درجة يستحق فيها البحث والتفكير أو الاجتهاد والتنظير.
لقد شاع مفهوم الحضارة كحالة ثقافية تسيَّدَ فيها العقل والمنطق والبحث العلمي. وهو ما انتهى إلى ما عرف في الأدبيات السياسية الغربية “إزاحة الوعي الأسطوري في تفسير العالم”، أو ما سماه ماكس فيبر “نزع الطابع السحري عن العالم”، والمقصود بذلك على وجه الدقة، إنما هو إزاحة الدين والأخلاق أو المُثُل العليا جانباً. ولكن الحضارة التي يُفترض أنها علامة على ترقي الإنسان في ظاهره كما في باطنه أو جوهره، قدمت له السيادة على الطبيعة وتحقيق سعادة نسبية ظاهرياً، غير أنها في الواقع أفرغته من الداخل، حيث سادت في مجتمعات الحداثة الراهنة قيماً جديدة، تمثلت بالفردانية الأنوية المطلقة، والمركزية الذاتية المتعالية، والعبثية العدمية. هذا فضلاً عن التغريب والتشيييء أو تسليع الإنسان، والعبودية الطوعية تحت سطوة حاجات وهمية كاذبة؛ بتعبير روبرت ماركوز. وهذا ما تناوله عدد كبير من رموز الفكر الغربي، ولسنا بحاجة للتوقف عند هذه المشكلات لأنها باتت معروفة للجميع. ولكن الجدير بالتوقف عنده أن جميع هذه المقاربات لم تقدم البدائل الممكنة، وإنما اقتصرت الجهود على عرضها مع الدعوات لإعادة النظر في الحداثة عينها، وانتهى ذلك إلى تيارات “ما بعد الحداثة”، ومنها “البنيوية” و “ما بعد التنوير” و “ما بعد التاريخ”.. وغيرها؛ كتعبير نقدي، يرفض ما أنتجته الحداثة من قيم عدمية، راحت تزحف بقوة على روح الإنسان، وتهدد بشطب ما تبقى من إنسيته، التي بدأ مخاضها مع عصر النهضة الأوروبية، وتشكلت ملامحها بعد الثورة الفرنسة أو عصر الأنوار، واكتملت صورتها في النصف الثاني من القرن العشرين، من خلال شرعة حقوق الإنسان وما تلاها من مواثيق وعهود حقوقية وقانونية دولية.
أما التنوير الحضاري في خطاب الشيخ ابن بيه الذي نعنيه، فنظن أنه يتركز على إمكانية تقديم البدائل من خلال ما نحب أن نسميه، وصل ما فصلته الحداثة الراهنة بين العقل والروح، أو بين الله والإنسان. ولا يكون ذلك إلا من خلال إعادة النظر في إعادة بناء إنسية الإنسان في سياق قابلية الكمال الكامنة في فطرة الخلق بالطبيعة البشرية، التي قامت من دون سببيات ضرورية أو حتميات طبيعية. ولذلك يتوقف الخطاب عند جملة من المفاهيم أو القيم الحداثية، مثل ضرورة الموازنة بين “الخصوصيات الثقافية” وفلسفة “الحريات والحقوق” في التشريع والقانون، أو بين “الحرية والمسؤولية”؛ بمقتضى الضمير الأخلاقي. فمثلاً: الإساءة للمعتقدات لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، بتُكأة وهمية كاذبة على حق حرية التعبير!. والأمر عينه، فما يمكن أن تقبله ثقافة ما، ربما لا ترضاه ثقافة أخرى، وقد يكون غير مقبول في ثقافة ثالثة، ومحرم في رابعة. هذا فضلاً عمَّا يسميها الخطاب “رباعية التجاذبات” التي تعصف بالنفس البشرية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البشرية، وهي، “التجاذب بين حفظ النَّفْسِ والمال، ومنطق العلم والسوق، واليقين والشك، والضعف والقوة”؛ كنتيجة لتراجع الشعور بالدين وانكفاء الوازع الأخلاقي، حيث غلبت على السلوك البشري نزعات العنف والاحتراب، التي نشهد تداعياتها كل يوم بأبشع وأقبح الصور وأكثرها ابتذالاً على كل المستويات الوحشية، وليس أقل الدلالات على هذا التصحر الأخلاقي والتردي الإنساني، المقتلة الفلسطينية المتواصلة في غزة والضفة الغربية على مرأى ومسمع العالم منذ واحد وعشرين شهراً ونيف، من دون رمشة جفن أو رفة عين (باعتبار العين مرآة كأول إشارة للتعاطف الإنساني)، وهو الأمر الذي كشف بلادة الحس الأخلاقي في الحداثة الراهنة، وفضح زيف الحضارة الإنسانية عموماً.
(إعادة بناء)
في الواقع؛ نحن أمام نُذُر فشل حضاري، يحطُّ من قيمة الإنسان، فما جدوى أن يغزو الإنسان الفضاء ويبلغ أقصى الكواكب، بينما يظلُّ عاجزا عن التفاهم مع أخيه ونظيره ومثيله، وجاره على كوكب الأرض.
أما الطريق إلى إعادة بناء إنسية الإنسان في مشروع ابن بيه التنويري، فيتجلى من خلال ثلاث مقدمات، تبحث عنسبيل تحرير الإنسان من ضيق الرؤية المحدودة السائدة إلى سعة مفهوم السّلم المستدام، وكيف أجهزت المفاهيم الحداثية المعاصرة (التقدّم، العلموية، الأداتية، أصولية السوق في الإدارة والإنتاج والتوزيع، السيطرة على الطبيعة.. إلخ) على روح الإنسان، وكيف يمكن أن يؤدّي استكشاف طبيعة الإنسان وارتباطها بالمعرفة الميتافيزيقية (التي غابت عن الحداثة الراهنة) إلى رؤية كونية جديدة، تضع حداً للفردانية والتغريب والتشييء وكل النظم المعرفية والتطبيقات العملية (ميكانيزمات الثقافة التي تنتظم فيها ومن خلالها السيرورة الاجتماعية) التي تحول دون الترقي في إنسية الإنسان، وبخاصة عندما تتقدم في الحضارة الراهنة المطلقات المنفلتة من الضبط أو المعايير الموضوعية؛ على المستوى الحقوقي وقيم الحرية والمسؤولية الذاتية في الوعي الإنساني، وهي التي أدت -في الواقع – إلى انهيار الإنسانية في ضمير الإنسان المعاصر؛ بانهيار الروح في أعماقه. فلم تعد لديه قاعدة للروح أو منطلق للاطمئنان لمثل أعلى، وإنما هو القلق والشك والاغتراب، والانغماس في ثقافة “الاستهلاك” التي حصرته في النطاق الضيق للطبيعة البهيمية، فتسيّدت العَدَمية، وتسلّعَت القيم، وانعكس الأمر على معايش الإنسان وأمنه داخل المجتمعات المحلّية والكونية.
إذن؛ ثمة حاجة ماسة إلى إحداث تحوّل في المنظور الكلّي، يزيحُ عن الإنسان الحجُب التي تفصل بينه وبين العوالم الفسيحة الممكنة، عالم الروح، وعالم المعنى والغائية، وعالم التّسامي.
يتأسس التنوير الحضاري في فكر الشيخ عبدالله بن بيه على مبدأ حوار الثقافات. ما يعني أن الخطاب مفتوح على الأفق الإنساني الرحيب، من منطلقات “عقلانية إيمانية”، تُموضع الحوار في سياق التعارف والتسامح الإسلامي الذي يُقَعِّدُ التعايش السعيد في “الأذهان قبل الأعيان”، من خلال استثارة الاستجابة الدينية والأخلاقية في قابلية الكمال في الفطرة البشرية، أو ما سماها ابن رشد “مواصفات الكمال الموجودة في الإنسان” في كتاب “الكشف عن مناهج الأدلة في اعتقاد الملة”. والخطاب بذلك إنما هو يقتفي الأثر القرآني في الإقناع والإمكان بحدود المستطاع الإنساني، وبخاصة من حيث التركيز “على معرفة النّفس أو الذات أوّلاً، وتزكيتها؛ لأن معرفة النّفس أولى درجات الإصلاح، ثم معرفة العالم، ثم معرفة الباري سبحانه وتعالى”. وهي معرفة لا يمكن أن تتحقق على الوجه الأكمل في إطار من الخصام وغياب الوئام. إذن؛ لا بُدَّ من تحقيق السلام، على قاعدة “إعلان الحرب على الحرب لتكون النتيجة سلماً على سلم”. ومن صواب العقل ومعقول المنطق أن يسبق المعرفة، إطفاء الحرائق في المجتمعات الإسلامية أولاً، وكبح التطرف والغلو، وإشاعة ثقافة التسامح والمحبة على بساط الحوار والتعايش والتعاون، من أجل تأسيس انطلاقة عقلانية تُنظف الأذهان من الوعي الزائف وضلال الأوهام حتى يكون البناء المعرفي سليماً. ولذلك انطلقت مقاربة الخطاب من مبدأ تأصيل “السلم” في الإسلام؛ باعتباره مقدماً في مقاصد الشريعة، وفقاً لتأويلية الشيخ المجدد عبدالله من بيه الباذخة، “إذا كانت المطالبة بالحق حق، فإن البحث عن السلم أحق”. وذلك بموازاة تصحيح المفاهيم الإسلامية، التي مثّلت وقود الاحتراب؛ عندما أخرجتها فئة جاهلة “من مقاصدها، ونسفوا كل شروط النظر الفقهي فيها، ولبَّسوا على المُغرّر بهم مضامينها”، فأفضى ذلك “إلى الاقتتال العبثي؛ حتى ولو أُلْبس لبوس التقوى”. وعليه قطع الخطاب “أن الشريعة بمنزلة نص واحد في نظام الاستدلال والاستنباط، فمَن لم يُحط بها علماً، ولم يجمع أطرافها، لم يسعفه أن يفقه معانيها”. وهو ما جعل الشيخ ابن بيه ينهض بوظيفة “واجب الوقت” في سياق فقه “الواقع والتوقع”، وأهمية “التجديد التنويري” في الخطاب الإسلامي، التي لا تغفل عن واقع النسيج الوطني ومقتضيات التعايش مع السياق الدولي. وهو ما يعني أن الخطاب يفتح العقول على حقيقة أن العالم اليوم لا يُعرِّف نفسه بالدين فحسب، وإنما بالثقافة عموماً (والدين في صميمها) والمصالح خصوصاً، إلى جانب التكنولوجيا والتقدم العلمي والمبادلات، وبشكل أخص “المعاهدات” أو الاتفاقيات الدولية. وهو ما يقتضي التأكيد على سنن التعارف وقيم الحوار القرآني؛ لإيقاظ الضمير العالمي من غفلته. ولذلك لا ينفك الخطاب يجدد الدعوة إلى حوار الثقافات، فهو “واجب ديني وضرورة إنسانية، وليس أمراً موسمياً. الحوار من أصل الدين ومن مقتضيات العلاقات البشرية”، باعتبار أن “أهم قيمة يمكن أن تكون مفتاحاً لحل مشاكل العالم، هي احترام الاختلاف، بل حب الاختلاف بحيث ينظر إليه كإثراء؛ كجمال، كأساس لتكوين المركب الإنساني”. ذلك لأن “التعدد هو سنة كونية، وكذلك هو فطرة بشرية، فالناس من فطرتهم أن تخلتف رؤاهم وتصوراتهم ومعتقداتهم ومصالحهم“، “وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ“. ويخلص الخطاب إلى أن “التعدد ناموس إلهي، سرى في الأكوان والرؤى والشرائع، ولم يكن الإسلام في يوم من الأيام إلا معترفا بهذا المبدأ ومعلنا بضرورة احترامه”؛ كقيمة راسخة في الأخلاق الإسلامية. ما يعني أن الحوار واحترام الاختلاف بمنظور الشيخ ابن بيه يؤسس التعاون والتكامل الإيجابي في عملية التنوير الحضاري؛ باعتباره منجزاً بشرياً، يتقصد نفع أو خير الإنسان في كل زمان أو مكان. أما التناحر والتنازع الذي تقول به بعض النخب من “كُهّان الحضارة” فهو “دليل على فشل كل حضارة في أن تُدرك أهمية الاعتراف بحق التنوع”. وإذا كان نيتشه يعتبر “أن الحضارة تمرض كما يمرض الناس، ودواؤها الفلاسفة”، فإن الشيخ ابن بيه يقول: “إن حضارتنا العالمية اليوم مريضة ودواؤها الحوار والتعارف والتعاون”. ذلك لأن “يد المعروف غُنمٌ حيث كانت”، كما تقول الحكمة العربية، ولا بدَّ من التمسك بها متى امتدّتْ ببذل النّدى، وكفِّ الأذى؛ لما لها من تأثير قوي في نشر جو الطمأنينة والأمن بين أفراد المجتمع وفئاته. وفي الواقع يشير تاريخ المجتمعات الإنسانية إلى حقيقة أن أرقى أشكال التقدم والازدهار حصل في الحالة المتمدينة من التفاعل المتبادل والتعاون المتناغم، حيث كانت أكثر إنتاجية، وأكثر ملائمة للنمو الإنساني الأمثل؛ مما يعرف بالحالة الطبيعية للاعتماد الفردي الذاتي أو الاجتماعي والنفسي.
وفي هذا السياق لا يمكن إغفال الوجه الآخر للتنوير الحضاري (بالمعنى الفلسفي) في الخطاب، فهو أكثر وضوحاً وسطوعاً، حيث يتقدم العقل في منطوق الخطاب بشكل لا لبس فيه؛ لأنه لا فصل بين الحكمة والشريعة، فهدفهما واحد، هو حل مشكلة الوجود الإنساني؛ وإن اختلفت طرقهما. وحل هذه المشكلة تختزله فلسفة “مقاصد الشريعة”، والشيخ ابن بيه هو فقيه مقاصدي بامتياز، ويتناغم إلى حدود التماهي مع ابن رشد، وبخاصة في مقولته، “أن الحكمة هي صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة (…)، وهما المصطحبتان بالطبع، المتحابتان بالجوهر والغريزة” (ابن رشد، فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، ت- محمد عمارة، ص- 67). ونجد صدى ذلك في خطاب الشيخ ابن بيه بصورة جلية؛ عندما يدعو إلى ما سماه “تحرير العقل بالدين، وتبرير الدين بالعقل، فلا تفاوت ولا تعارض”، والمعنى بذلك كما يوضحه الشيخ ابن بيه أن الدين والعقل متناغمان؛ بل متكاملان. ولذلك “لا يمكن تعارض نقل صحيح مع عقل صريح، وإلا قُدِّمَ العقل الصريح الصحيح وحمل النقل على التأويل أو عدم الثبوت”. وهذا ما يجعلني أعتقد أن ابن بيه هو الوريث الشرعي لفلسفة ابن رشد، أو وريث ما سميتها في كتابي “الأنسنة والتجديد في فكر العلامة الشيخ عبدالله بن بيه”، الغواية العقلانية الإيمانية الفارهة.
إن التنوير الحضاري في الخطاب يقوم على ثلاثية “موازين النواميس الإنسانية الكلية”، أي “ميزان الشريعة” أو الدين، و”ميزان الحكمة” أو العقل، و”ميزان الفضيلة” أو الأخلاق. ويفصل الخطاب بالأمر: “إذا كانت دائرة الوحي والنصوص هي الحاكمة على الواقع الإنساني؛ فإن هذا الشرع لم يحجر على العقل؛ بل أعطاه مساحة واسعة يُدرك فيها العقل مصالح العباد”، بالبرهان العقلي، والبرهان لا يكون إلا على الحقيقة العلمية؛ بتعبير ابن رشد. ولذلك ينبغي “تحرير العقل من حالة العطالة التي أصبح عليها منذ عهود الانحدار؛ حتى يضطلع بدوره في النزول بالنصوص والمقاصد والفروع والقواعد من سماء التصور إلى أرض التطبيق”؛ لأننا بالعقل الرياضي أو المنطقي، الذي تقوم عليه منهجيات التفسير وآليات الاستنباط الفقهي يمكننا “التعرف على الواقع؛ لحل مشكلة الأجهال الثلاثة: الجهل بالنصوص، والجهل بالمقاصد، والجهل بالواقع والمآلات”. وهو ما يندرج بشكل عام في إطار الفلسفة الرشدية التي ترى “أنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتمَّ، كانت المعرفة بالصانع أتمَّ”؛ سواء أكانت المعرفة تتعلق بفهم النصوص لغة وتأويلاً، أو معرفة مقاصد الشريعة من حيث غاياتها الجوهرية على مستوى الاهتمام بالإنسان وتحقيق سعادته في العاجلة والآجلة.
(شجرة الإرهاب)
لقد تباين خطاب الشيخ عبدالله بن بيه عن الكثير من المفكرين – الغربيين والشرقيين على حد سواء – الذين وسموا الأديان بالعنف وصناعة الحرب، فهؤلاء لم يفرقوا بين الدين أو “الإيمان الصحيح، الذي هو بجوهره مصالحة روحية بين الإنسان والوجود، وبين صناعة التدين التي هي صناعة بشرية أحالت الدين الذي هو في أصله طاقة تصنع السلام، إلى طاقة تُصنع منها القنابل المميتة، المهلكة للحرث والنسل”. ولذلك يقرر الخطاب أنه لا بُدَّ من اجتثاث “شجرة الإرهاب من فروعها، واقتلاعها من جذورها من بستان الأوطان.. لا بُدَّ من إعمال فؤوس الحكمة في جذوعها، وغرس شجرة التسامح والتصالح في ربوعها، فالفكر الرديء لا يطرده إلا الفكر الجيد”، أيٌ كانت مصادره التي يمتح منها معينه، وأيٌ كانت عباءته التي يتدثر بها.
يستلهم الخطاب “حوار الثقافات” من جوهرين:
الأول: يحاكي حديث السفينة من المأثور النبوي الشريف؛ في محاولة تعميق الوعي بوحدة المسار والمصير الإنساني؛ لأن “البشرية الآن في سفينة واحدة على وشك الجنوح، فلا بُدَّ لأهل القيم أن يأخذوا على أيدي الذين يريدون خرق السفينة”؛ عن طريق أسلحة الدمار الشمل، والتغول على الطبيعة، واستنفاد الموارد، واتساع دائرة النزاعات في العالم.
الثاني: تكريس التعارف القرآني والتعايش والتعاون الإيجابي على أسس معرفية وشرعية، تتيح إمكانية حوار الثقافات الذي يُفضي إلى التكامل الحضاري؛ سواء في أفق المواطنة المحلية/الوطنية، أو على مستوى المواطنة الكونية بين مختلف الثقافات. ويندرج هذا الجهد في إطارين أحدهما حقوقي، وهو “إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة”، والآخر إنساني، هو “موسوعة السلم في الإسلام”. وبذلك يقدم الشيخ ابن بيه الخطاب الإسلامي للعالم، كما يليق به من التنوير الكوني؛ باعتباره فرصة جديدة للبشرية، كي تستعيد فيها الإنسانية، روح الوئام والسلام.
إن مقاربة الشيخ عبدالله بن بيه “العقلانية الإيمانية” التنويرية، تتقصد سدّ الفراغ الروحي الذي ملأ الكون، حيث استغرقت البشرية في عالم المادة وتنافست فيه، إلى أن ضاعت الأخلاق وساد الشقاق بين الأمم. لذلك انطلق الشيخ الجليل من موقعه الفكري؛ كشيخ للإنسانيين، يتفاعل مع البشرية بندية رؤوم؛ كنظراء أكفاء له. ذلك لأن “الآخر في رؤية الإسلام ليس عدواً ولا خصماً، بل هو على حد عبارة الإمام عليّ رضي الله عنه، “أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخَلْقِ”، أو كما تقول العرب، “الأخُ بزيادة راء الرحمة والرأفة والرفق”. إنه الأخ الذي يشترك معك في المعتقد أو يجتمع معك في الإنسانية” (أنظر: الشيخ عبدالله بن بيه، حوارات المواطنة الشاملة، أبوظبي 2018). ما يعني أن المغزى التنويري في الخطاب مؤسس على جوهر إسلامي وعمق قرآني؛ باعتبار أن البشرية أخوة، أبوهم آدم عليه السلام؛ سواء تقاربوا أو تنافروا بالمعتقدات، والشيخ الجليل، يشاركهم أحلامهم وتطلعاتهم، يُسعد لأفراحهم، ويشقى لأوجاعهم.

وإذا كانت “الحضارة تمرض كما يمرض الناس، ودواؤها الفلاسفة” كما يقول نيتشه، فإن الشيخ ابن بيه يقول: “إن حضارتنا العالمية اليوم مريضة ودواؤها الحوار والتعارف والتعاون”. ما يستدعي ضرورة “التفكير في التحديات التي تواجه حضارتنا الإنسانية المريضة، وهي تحدّيات يفرض إلحاحها وخطرها، على أطباء الحضارة من الفلاسفة ورجال الدين وأصحاب الفكر، المبادرة إلى الربط الدائم بين التفكير والفعل في آن واحد”. وهذا ما يجعل الشيخ الحكيم ينشغل بتشخيص داء الحضارة وتوصيف أدواءها، ويستنهض همم حكمائها من أجل الإلتفاف الكوني حول فكرة “حوار الثقافات” و”التعارف والتعاون”، التي بها تضمن البشرية مستقبلاً أفضل لها ولأجيالها المقبلة. فالحوار يؤدي إلى التكامل بين الثقافات المعاصرة، وربما التكافل بين البشر، وهو الأمر الذي “ما انفك يُفكر العلامة عبدالله بن بيه فيه ويُنظّر له، ويسعى إلى تطبيقه على أرض الواقع الدولي، هو في معنى مطابق: ترابط المصير وتكامل مصادر تحقيقه وأدواته وأهدافه”، وهو في الوقت عينه بمثابة مقاربة “أصيلة غير دخيلة؛ طالما تستمد عمقها الفلسفي (ونسغها الإيماني)، من هُوية حضارية إسلامية تتسع لتشمل العالم في تعدد أبعاده وتنوع آفاقه”، كما يقول ابن منصور الصحبي في كتاب “حوار الحضارات: أعلامه وآفاقه من خلال النصوص التطبيقية”.
إن سقف التنوير الحضاري في الخطاب إنما هو “الكتاب والسُنَّة”؛ كما عبر العلامة الشيخ عبدالله بن بيه نفسه غير مرة. ويقوم بجوهره على ضرورة الوعي بأهمية حوار الثقافات، والأجدر أن تتلقفه النخب الليبرالية أو العلمانية العربية أولاً. فهو يقدم سردية فلسفية جديدة تليق بالوعد الإنساني في غدِ أفضل ومستقبل أجمل وأنبل. فهل ترتقي النخب العربية إلى مستوى المسؤولية المنوطة بالمثقف العضوي؛ حسب تعبير غرامشي، وتنخرط في هذا الحوار النقدي الفاعل مع مشروع التنوير الحضاري في خطاب العلامة الشيخ عبدالله بن بيه؟ الإجابة برسم كل دعاة رفع لواء العقل، ولا عذر لكل من يظن بنفسه مستنيراً هادياً على طريق الرشاد إلى مستقبل أكثر إشراقاً في الحرية والعدل والمساواة والسعادة. فهذه هي وظيفة العقلاء والحكماء الإنسانيين على مرِّ التاريخ البشري.
يبقى أن نقول في الخاتمة: إن خطاب الشيخ عبدالله بن بيه يتمايز بكلاسيكية لغوية أنيقة؛ سواء على مستوى منهجيات التفكير والتصوير، أو دقة التعبير ورقة التحبير، المطرزة ببلاغة نثرية فارهة، وفتنة “روح الشعرية” الباذخة (إذا صح التعبير). وذلك بالتناغم مع نقّرة السجعات التي لها سحرها الخاص في الأذن العربية، كما في عبارتي “تحرير العقل بالدين” و”تبرير الدين بالعقل”، فهما يتصاديان في رنّة واحدة؛ بجرس من الإيقاعات المموسقة، وكأنها توليفة هارمونية تحاكي سيمفونية الوجود، توليفة بديعة تجعل العبارة تتجاوز تخوم المعنى في النص، من حيث إشباع الذائقة بفائض من معنى المعنى. هذا فضلاً عن الأسلوبية الرائقة التي تجعل له تلك الجذالة المتدفقة بسلاسة ماتعة، تتهادى على إيقاع المحمولات الدلالية والمفهومية المعروفة في الأنساق الفلسفية العرفانية الأثيلة في تاريخ الفكر العربي، خلال العصر الذهبي الخالد في ماضي العرب والمسلمين. هذا هو بتمام الدقة والضبط ما يجعل تلك الغواية “العقلانية الإيمانية” التي أشرنا إليها أكثر من مرة في كتابنا “الأنسنة والتجديد في فكر العلامة الشيخ عبدالله بن بيه”، تستثير المخيلات وتطلق عنان الأفكار أو التصورات في فضاءات جمالية شاسعة. وهي غواية آسرة يصعب الفكاك من سطوتها في الإقناع والإمتاع، الإقناع بالحكمة البرهانية أو اليقينية، والإمتاع بالروحانية أو الوجدانية الأثيرة. والخطاب في ذلك لا يبرح مركزيته من حيث ماهيته الأصولية إلى درجة معانقة اللامتناهي في النظر العقلي، سواء في التقعيد الفقهي أو التأصيل الشرعي. الأمر الذي يجعل الخطاب يتقاطع (بالمعنى الفلسفي) مع مقولات العصر ومنطق الحداثة؛ بإيقاعات إيمانية عقلانية مموسقة، تخاطب الوعي بالقدر عينه الذي تحاكي فيه الروح أو القلب، من غير أن تكون ثيولوجية لاهوتية تقليدية صافية أو جدليات فلسفية عويصة خالصة، هي ذاك المزيج من الخطاب الآسر، الذي يستثير الاستجابة الإنسانية على أحسن ما تكون، من حيث إمكانية تثوير قابلية الكمال في فطرة الخلق.. إنها عقلانية إيمانية متفلتة من شرنقة النمطية السائدة في عقلانيات الحداثة، ومتحررة من مسكة الماضوية؛ سواء أكانت في فضاء المدارات السلفية أو لبوس الحكمة التقليدية.. إنها فلسفة واقعية عملية، ترُجُّ الآنية، وتتفلت من أسار الراهنية، وتضج بالعلامات المستقبلية. هي ومضة انطولوجية، تدعونا للتفكير خارج الحدود التي رسمتها الحداثة، الموسومة بالمركزيات المتعالية والفردانيات الأنوية الضيقة، بعيداً عن أفاقها التغريبية والعبثية أو العدمية؛ بقدر ما هي قريبة من نبض الحياة النامية.. هي لحظة أصيلة يتلاقى فيها الموروث مع المعاصرة، فيتعانق الماضي مع الحاضر برقصة النور الأبدية، التي تشرئب دائماً وأبداً إلى المستقبل. ومع ذلك لم تنل حقها من الاستنبات والتخصيب، ربما ما آن آوانها، أو أنها سابقة لزمانها، وربما لأنها تتخايل في جلباب المخاطرة في هذه اللحظة المعاصرة الموسومة بالرؤية القاصرة، وربما لأنها تشرع أفقاً عصياً على التمثل والاستيعاب، وربما لأنها تؤشر إلى ما لا نريد أن نراه أو نتذكره؛ من قلة حيلتنا وهواننا على أنفسنا؛ قبل هواننا على الناس، وربما لأنها ليست ابنة هذا الزمان، فلا تزال غريبة بغربة غربية، قريبة من غربة ابن رشد في أيامه الأخيرة !؟