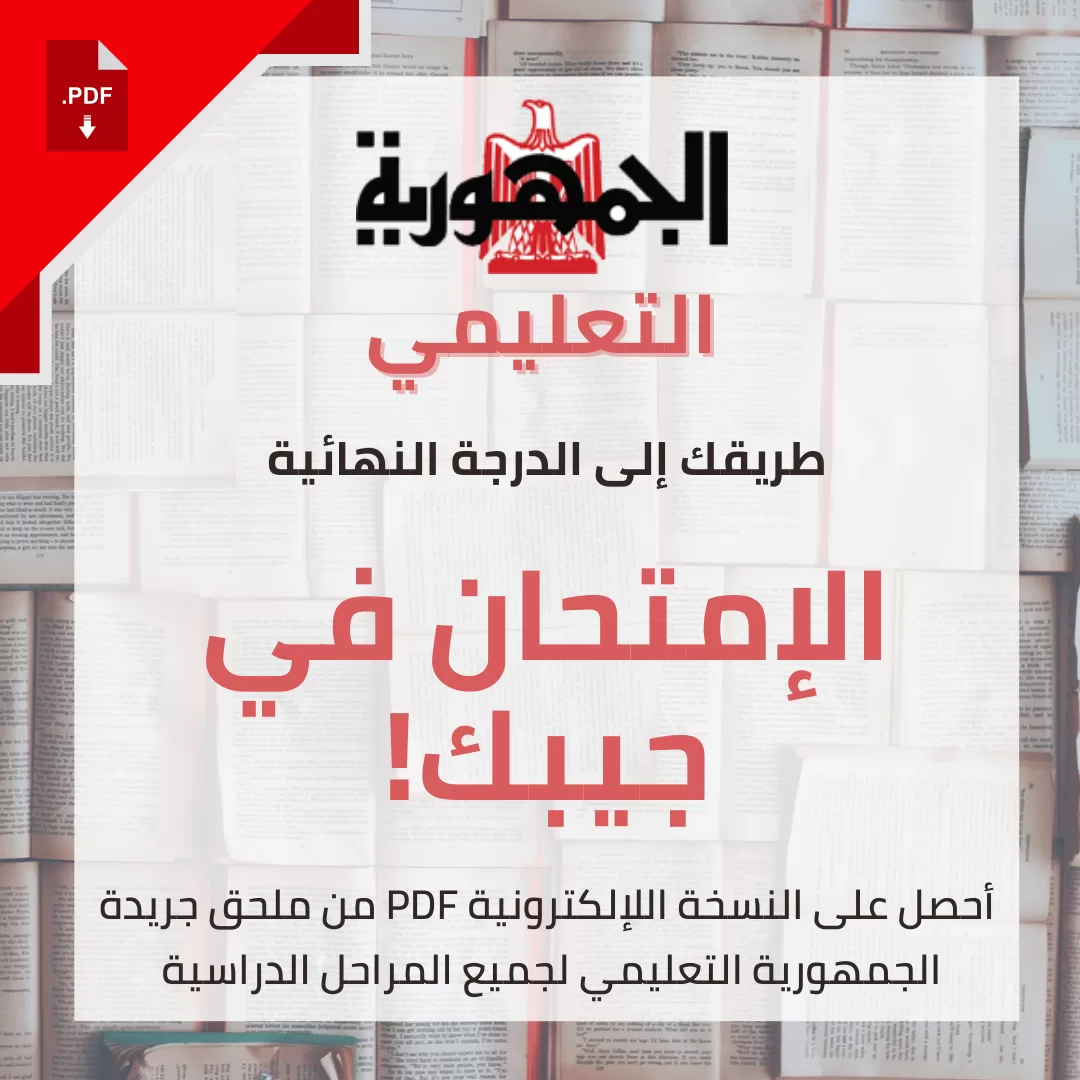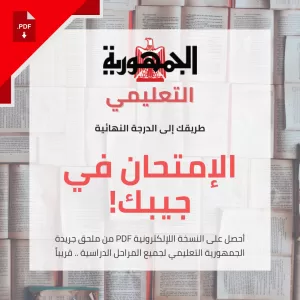يجب بناء وعى دينى علمى وإنسانى حتى لا نترك شبابنا يسقطون فى فخ الجماعات الإرهابية
كثير من الأزمات الفكرية المعاصرة سببها سوء الفهم واختلاط المصطلحات
التعايش مع المختلف أمر اجتماعى .. أما التسامح معه فهو قمة الوعى الأخلاقى والإنسانى
بدأت تتصاعد الخطابات المتطرفة ويتراجع الفكر العقلانى أمام كتائب من العدوان الممنهج على مبادئ التعايش والتسامح والسلام التى جاءت بها شرائع الأديان السماوية، ووسط الظلام الذى يطارد النور يبحث الناس عن طوق الإنقاذ ممثلا فى العلماء الذين يملكون القدرة على قراءة الواقع ومطالعة المستقبل بصورة تدفع الشر المستطير الذى حاول المتطرفون وداعموهم أن يدخلوا من أبوابه إلى تحقيق أطماعهم فى نشر الخراب والدمار والصراع الطائفى.
من هؤلاء المفكر الدكتور محمد عثمان الخشت أستاذ فلسفة الدين ورئيس جامعة القاهرة السابق الذى أنتج أكثر من 100 كتاب وتحقيق وبحث عدة مشاريع فكرية متميزة فى مجالات الفكر الدينى المتجدد وأبرز تلك المشروعات موسوعة الأديان العالمية التى يصفها المفكرون بأنها مشروع معرفى غير تقليدى يتجاوز التوثيق إلى إعادة تأسيس العلاقة بين الإنسان والدين، وتأسيس خطاب دينى عقلانى يجمع بين المنهج العلمى والاجتهاد التأويلي، كما تسعى الموسوعة إلى تقديم معجم شامل ومحايد للأديان والمذاهب يعيد قراءة الظواهر الدينية بمعايير معرفية متجاوزًا الانحيازات المذهبية، والجمود وتأسيس بديل معرفى واقعى يعيد بناء فهمنا للمقدس على أسس عقلانية وإنسانية.
«الجمهورية» ناقشت معه العديد من القضايا فى حوار متعدد الجوانب ولا ينقصه شيء من الصراحة.
> الخطاب الدينى وتجديده أصبح قضية الصباح والمساء منذ بزوغ التيارات المتطرفة.. ما مدى حاجتنا لتجديد الدعاة خطابهم الدينى؟
>> نحن بحاجة إلى خطاب دينى يستند إلى المعرفة الجديدة والمتجددة، وليس مجرد خطاب قائم على التلقين، خطاب يكون حريصا على احترام الآخر، لا على نفيه، وأنا اعتبر تلك القضية هى مركز الدائرة فى منهجى البحثى والفكرى خلال السنوات الأخيرة بعدما استشعرت خطورة المصير من خلال المعطيات التى تابعتها فى تصريحات وكتابات تلك الجماعات المتطرفة المنحرفة، وفى مقدمتها الجماعة الإرهابية، ولهذا قمت بإصدار موسوعة شاملة عن الأديان اعتبرها بمثابة حلقة مركزية فى مشروع تأسيس خطاب دينى جديد، لأننا يجب أن نعترف بأن الخطاب الدينى التقليدى أصبح غير قادر على مواجهة تعقيدات الواقع المعاصر، ولا التعامل مع التعددية الدينية والثقافية فى عالم اليوم، إننا نحتاج تأسيس مفهوم جديد لمعرفة الدين، من تكوينه الداخلى والخارجى فى الوقت نفسه، مفهوم يكون قادرا على استيعاب الظواهر الدينية المختلفة فى العالم دون أحكام مسبقة، والتخلص من الأساطير التى تقضى على الوعى العقلي، وتفكيك التطرف، وبناء وعى دينى علمى وإنسانى حتى لا نترك شبابنا يسقطون فى فخ الجماعة الإرهابية والتطرف والأفكار المناهضة للدولة الوطنية.
> كثيرًا ما تحدثتم عن «التنوع باعتباره سُنَّة كونية» كيف يمكن للمفكرين ترسيخ تلك الفكرية باعتبارها طريقا للتعايش؟
>> الاختلاف والتعددية ليست انحرافًا عن الأصل، بل هى من طبيعة الخلق ذاته، وهذه ليست مجرد فكرة فلسفية بل هى حقيقة قرآنية واضحة: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً»، و«إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا»، لكن كيف نفسر هذه الآيات عمليًا؟ ولذلك حرصت أن تكون موسوعة الأديان العالمية لها دور فى تقديم الأديان والملل والنحل والطوائف والفرق، بصورة إنسانية للتأكيد على التعايش والتنوع.
> لكم رؤية فى تحقيق التسامح الدينى هل جاءت بجديد مختلف؟
>> هناك فرق بين أن «تتعايش مع المختلف» وبين أن تتسامح معه، ففى الأولى نكون أمام اضطرار اجتماعي، أما فى الثانية والتى نعيشها فى مصر فهى تجسد حالة وعى أخلاقى وإنسانى عميق والتسامح أساس إدراك العلاقة بين الأديان، فليس مطلوبًا أن نتشابه فى كل شيء، وهناك حرية كبيرة فى تعدد المعتقدات والعبادات أقرها القرآن بشكل حاسم وصريح ومباشر: «لكم دينكم ولى دين»، وهذا تأسيس مبدأ قرآنى بالغ الأهمية فى إطار التعددية الدينية، فهى من جهة ترفض التوفيق العقائدى والمساومة فى جوهر التوحيد، لكنها من جهة أخرى لا تفرض اعتقادًا بالقوة، ولا تنفى وجود الآخر المخالف، بل تعترف به واقعًا ذا دين مستقل، وتقرّ له بحقه فى اتباع معتقده، «لكم دينكم ولى دين» إعلاناً للتمايز لا للإقصاء، واعترافا بالاختلاف لا لنفيه، فهى لا تأمر بالعداء أو الصراع، وإنما تفصل بين المرجعيات العقدية على أساس الحرية والاحترام المتبادل، ما دامت لا تمسّ حريات الآخرين ولا تفرض رؤيتها بالقسر، وهذه الآية تعتبر من النصوص التأسيسية التى تضع حدودًا واضحة بين التوحيد كقناعة راسخة، والتعددية كواقع إنسانى يجب التعامل معه دون تعصب أو عنف، إن التعددية التى تشير إليها الآية ليست دعوة خلط العقائد أو التساهل فى المبادئ، بل تأكيد أن الإيمان لا يُبنى على المجاملة، وأن احترام حرية الآخرين فى اعتقادهم لا يعنى التنازل عن قناعة الذات، بل العيش المشترك فى ظل الاختلاف، وهو ما يشكل أساسًا إنسانيًا لحياة دينية مدنية.
> لكن البعض يعتبر أن سورة الكافرون تحمل معانى التمييز أو الإقصاء للمخالفين؟
>> إطلاقا.. الإسلام دين لا يعرف التمييز ولا الإقصاء للمخالفين ومن يرد دليلا فالأدلة كثيرة تمتلئ بها السيرة النبوية والأحداث الثابتة التى لا تقبل التشكيك، ولكن الراغبين فى تعكير صفو التسامح الدينى يثيرون التشكيك المرفوض لدرجة أنهم اعتبروا أن قول الله تعالي: «قل يا أيها الكافرون»، أنه نداء لا يحمل سبابًا وتحقيرًا، والحق أنه يحمل توصيفًا موضوعيًا لمن لا يشاركون المسلمين عقيدتهم التوحيدية، فمن الطبيعى أنهم يكفرون بما يخالف معتقداتهم، ونحن نكفر بما يخالف معتقداتنا، فهذا مجرد وصف للظاهرة وليس تحقيرا ولا إقصاء بهذا المعني، وللعلم فإن سورة الكافرون جمعت بين مبدأين متكاملين، وهما: وضوح العقيدة دون مساومة، واحترام وجود المخالف دون عنف أو إقصاء، فهى لا تؤسس لعلاقة عدائية مع الآخرين، بل لعلاقة تفصل بين العقائد، وتترك مساحة للعيش المشترك، فحرية الاعتقاد ليست ثغرة فى التوحيد، بل مبدأ من مبادئه فى ضوء كون الإيمان لا يُفرض قهرا، وإنما يُبنى على القناعة الحرة: «لا إكراه فى الدين» وهذا هو الأصل الذى يجب أن نؤكد عليه فى مواجهة أفكار التطرف وخطاب الكراهية الذى تتبناه الجماعات المتطرفة مثل الإخوان التى نشرت كل هذه الأفكار المدمرة.
> أتقترح على الباحثين فى الفكر الدينى دمج العلوم الطبيعية والإنسانية مع دراسة الأديان؟
>> الباحثون فى مناهج العلوم الدينية والمعرفية عليهم الإفادة من العلوم الأخرى فى فهم الظاهرة الدينية، لأن الدين لا يُفهم فقط من داخل نصوصه، بل يُفهم أيضًا من خلال علم الاجتماع، وعلم النفس، والأنثروبولوجيا، بل حتى من خلال العلوم الطبيعية حين تمسُّ علاقة الإنسان بالكون، وحين تكون هناك وقائع علمية تتعلق بظواهر كونية تكلمت فيها بعض الأديان، وقد تناولت فى العديد من موسوعاتى العلمية وخاصة موسوعة الأديان أسماء: فرويد، ودوركايم، وأوجست كونت، وابن خلدون، وشخصيات فلسفية مثل: «كَانت» وهيجل وأفلاطون والفارابى وابن رشد، وشخصيات علمية لها موقف من الدين مثل: «دارون»ونيوتن وغيرهما.
> كثيرون يسألون عن جدوى المقارنة بين الأديان؟
>> المقارنة وسيلة لفهم ما يجمع ويُفَرِقُّ والهدف هو الوصول إلى ما أسميه «الاتفاق بواسطة التقاطع»، أى الالتقاء على الحد الأدنى الإنسانى المشترك، دون إلغاء الفروق النوعية، مع اليقين بأن التشابهات لا تنفى الخصوصيات، وعلى سبيل المثال: القرآن الكريم مثلاً يحرص على النموذج الكلى فى رواية الأحداث، عكس الكتاب المقدس الذى يغلب عليه الطابع التاريخى التفصيلي، كما أن المقارنة بين الأديان تقدم نموذجًا جديدًا لفهم الأديان، ليس فقط فى ميدان المعرفة، بل فى صناعة الوعى العام، وبناء إنسان متسامح، عقلاني، منفتح على الآخر، ومؤمن بأن الدين يجب أن يكون عامل سلام، لا سلاح نزاع.
> وضع المؤلفات باللغة العربية هل يخدم القضايا المعرفية فى ظل الحرص على خطاب المختلف؟
>> اختيار اللغة العربية فى المؤلفات الفكرية يسهم فى تحرير العقل العربى من التبعية المعرفية والثقافية، فقد آن الأوان أن نمتلك موسوعات رصينة فى الأديان تُكتب من منظور عربى عقلانى نقدي، وليست فقط ترجمات لموسوعات غربية تعيد إنتاج انحيازات حضارية وعقدية، أما مسألة الانتشار، فهى تُعالج لاحقًا عبر الترجمة الدقيقة إلى لغات أخري، بعد أن ينشر العمل بلغته الأم، وهى لغة عظيمة كانت اداة لغوية لحضارة سجلت نفسها فى تاريخ الأمم كحضارة علوم وفلسفات وفنون.
> ما الفرق بين الكتاب الدينى التقليدى والعمل الموسوعى؟
>> الفرق جوهرى، فالكتاب الدينى التقليدى، يقدّم مادة معرفية وفق مرجعية عقدية أو مذهبية محددة، أما الموسوعة فإنها مشروع معرفى متعدد المستويات، يخضع لمعايير صارمة من الدقة، والتوثيق، والتحقق من المعلومات، وتُكتب بطريقة متزنة، لا انفعالية، مع الحرص على ربط كل مادة بسياقها اللغوى والتاريخى الفلسفي، كما أن الموسوعة تُعنى بتحديد التواريخ والتصنيف والنقد الداخلى والخارجي، ما يجعلها مرجعًا لا مجرد نص.
> هل واجهتم صعوبات فى التعامل مع المفاهيم الدينية؟
>> بالطبع، التعامل مع الدين فى المجال العربى ليس مجرد نشاط معرفي، بل هو دائمًا محفوف بالتوترات المخاوف، هناك حساسيات مذهبية، وتاريخ من التكفير والتخوين، وصراع مستمر حول «التمثيل الشرعي» للدين، لكننى أؤمن بأن العمل الموسوعى لا يخضع لهذا الابتزاز، بل عليه أن يتجاوز هذه الحساسيات من خلال العقلانية والاتزان. فالدقة أهم من السلامة الشكلية.
> فى ضوء انتشار عالمى للأفكار الشعبوية والدينية المتشددة، هل ترون ضرورة إعادة تعريف «الهوية الدينية» بما يتجاوز الانتماء الطائفى؟
>> بلا شك، نحن فى حاجة ماسّة إلى إعادة تعريف الهوية الدينية بوصفها هوية إيمانية إنسانية مفتوحة، لا إطارًا طائفيًا مغلقًا، وكثير من الصراعات الحالية تُبنى على فهم ضيق للانتماء الديني، كأنه جبهة مواجهة لا إطار تعايش، وعلينا دعم هدف تحرير الدين من الأَسر الطائفى وإعادته إلى أفقه الروحى والإنساني، ونحن هويتنا تتسم بالتسامح والوسطية ورفض التطرف.
> معاجم المفاهيم الدينية هل تساعد على تجديد الوعى الشعبى؟
>> المصطلحات مفاتيح الفكر، وإذا كانت المفاهيم مشوشة، فإن التفكير كله يدخل طريق الضلال الفكري، وهذا الطريق مليء بالألغام القابلة للانفجار فى أى وقت إذا لم يتم نزع الفتيل منها بصورة عاجلة على يد متخصصين وخبراء فى إبطال مفعول الأفكار المفخخة، وقد بذلت جهدى خلال المؤلفات التى قمت بإعدادها فى مجال التجديد الفكرى على تناول العديد من المفاهيم المتشابكة، ولم أترك مصطلحًا دون تفكيك وتحليل، لأن كثيرًا من الأزمات الفكرية المعاصرة تنبع من سوء فهم الكلمات الأساسية، ولذلك احرص على تتبّع كل مصطلح من جذره اللغوي، واستعماله فى النصوص المقدسة، وتحوّلاته فى التاريخ والمذاهب. وأقارن بين المفهوم فى الديانة الأصلية ونظيره فى الفلسفة أو اللاهوت الغربي، مع توثيق دقيق. هذه العملية تمنح القارئ أدوات للتحرر من التلقين، وتُعيد توجيه فهمه للدين نحو أفق عقلانى ونقدى.
> هل ترون أننا نسير على الدرب الصحيح فى الوصول إلى عقلية إسلامية تؤمن بالتعددية؟
>> بالفعل نسير ولا يمكننا إنكار جهود المجتهدين فى ذلك المجال، لكن دعنا نكن صرحاء فى أننا نسير أحيانا دون رؤية لما يجرى حولنا من تخطيط يعتمد على منهجيات تم إعدادها بدهاء رغبة فى إثارة الشكوك داخل نفوس بسطاء الفكر، ولأن الشك يعتبر طريق البحث فلذلك فإنهم ينطلقون إلى الخطوة التالية فى تغذية شكوك الباحثين بمنهجيات تقوم على الإلحاد والتكفير والتفخيخ المعرفي، ثم ينتقلون إلى الخطوة التالية فى رعاية منجزاتهم بزيادة جرعة التشكيك تدريجيا حتى يصلوا إلى غسيل أدمغة فئات شبابية يؤمنون بمناهج التكفير والتخريب والقتل والتدمير، وفى المقابل فإن المؤسسات الدينية لا يزال خطابها يعتمد على آلية حركية بطيئة وأسلوب تقليدي، ولهذا يجب طرح رؤية جادة يشارك فيها خبراء فى المفاهيم والرؤى السياسية والدينية والإعلامية والتكنولوجية، ويتم إنشاء دورات جادة حتى نملك دعاة لديهم فكر استباقى متطور يحيطون بالتحديات وينظرون إلى الواقع والمآلات المستقبلية، ولننطلق من رؤية الفقه الحنفى الذى كان يسبق عصره بمسائل افتراضية قائمة على مناهج دقيقة تربط بين الواقع والمستقبل، وبالفعل أثبتت الأيام صحة منهجهم، لكن بعدما جرت فى النهر مياه كثيرة صار الدعاة موظفين وليسوا أصحاب رسالة مما جعلهم يؤدون عملهم بصورة روتينية لا إبداع فيها ولا ابتكار ولديهم المبررات كثيرة لسنا فى طريق عرضها أو مناقشتها، لكننا أمام قضية تتعلق بمستقبل دين تتكالب عليه تيارات تريد اختطاف وسطيته واعتداله وتشويه تسامحه واستبدال مناهجه فى التعايش بأنه دعوة صراع وقتل، وكما يقولون: إن تأتِ متأخراً خير من ألا تأتى.