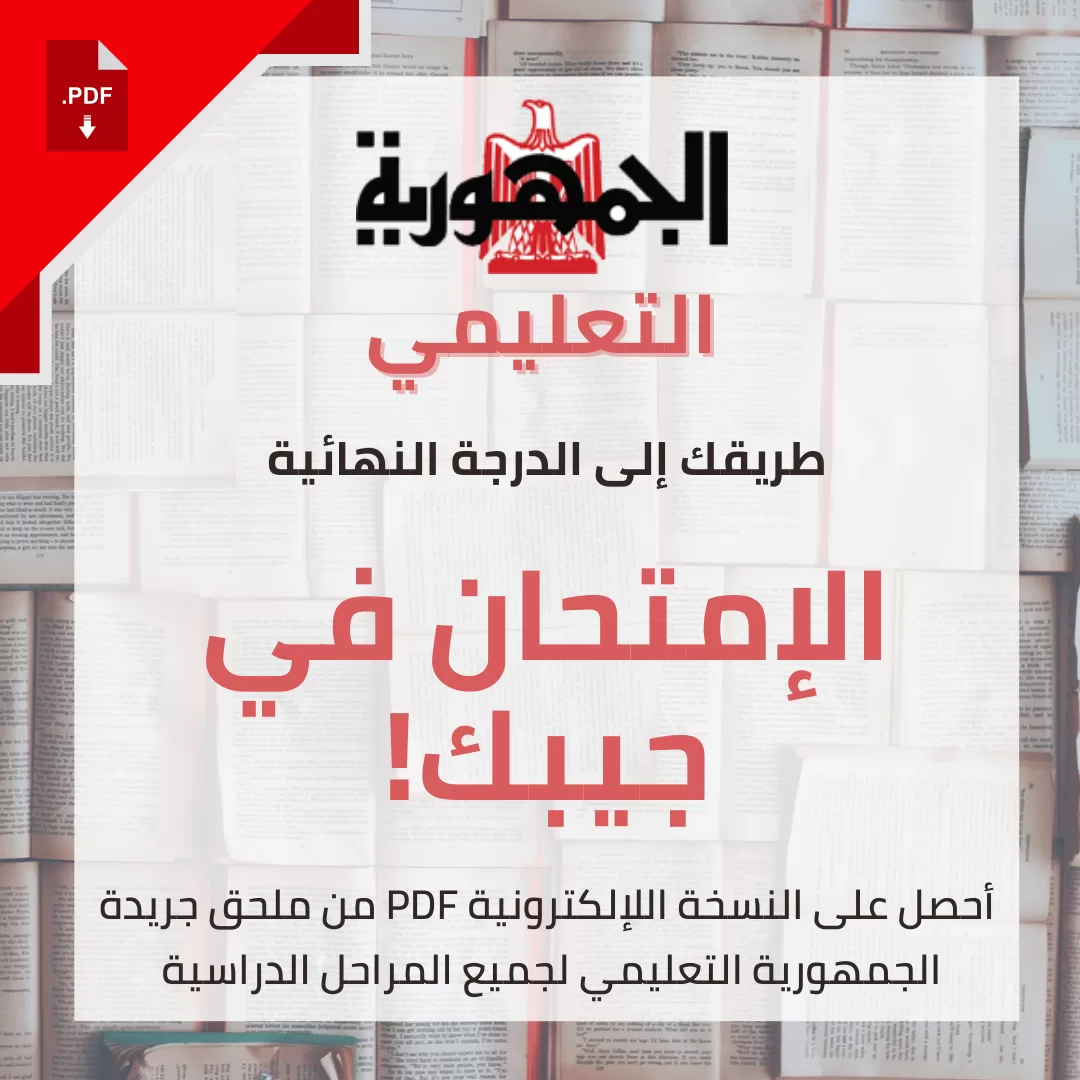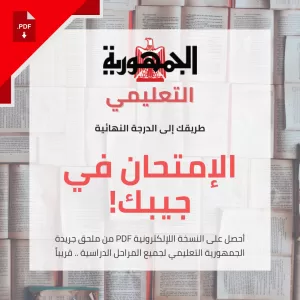الإرادة السياسية والخطوات الإيجابية.. السبب فى النجاح
اللحظة الحالية.. فرصة ذهبية لعلاج المشاكل المتراكمة
تحديد مسارجديد يقلل التعرض للصدمات الخارجية
إنخفاض معدلات التضخم.. العدالة الاجتماعية..
جذب الاستثمارات..إجراءات جيدة
التحديات رغم تعقيداتها ليست مستعصية
على الحل بفضل الإدارة الرشيدة





الأزمة الاقتصادية التى ألمت بمصر فى السنوات الأخيرة لم تكن وليدة لحظة عابرة أو نتيجة مباشرة للظروف السياسية المحلية التى أعقبت يناير 2011، بالرغم من التأثير السلبى لهذه الأحداث على مؤشرات الاقتصاد الكلي. كما أنها لا ترجع فقط إلى ما شهده العالم من أزمات مالية وصراعات جيوسياسية واضطرابات اقتصادية عالمية خلال السنوات الأخيرة، بل كانت انعكاس لتراكم طويل الأمد من التشوهات الهيكلية العميقة فى الاقتصاد المصري، تراكمت على مدى عقود من السياسات الاقتصادية المتباينة، والتحولات المتسارعة التى افتقدت فى كثير من الأحيان إلى الرؤية الشاملة والاستدامة. وهو ما استدعى القيادة السياسية فى عام 2016 لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة ولكنها ضرورية بغرض إصلاح هيكلى لهذه التشوهات التى عانى منها الاقتصاد المصرى طويلا، ولم يتخذ أى رئيس مصرى قبله قرارات أو إجراءات حاسمة لمواجهتها والقضاء على الاختلالات بغرض دفع عجلة الاقتصاد للأمام.
فجذور الأزمة الاقتصادية بدأت تنمو منذ ستينيات القرن الماضي، حين خاضت مصر تجارب اقتصادية متعددة، بدأت بنموذج الاقتصاد الموجّه الذى ارتكز على التأميم الواسع لعدة قطاعات حيوية وعلى رأسها قطاعى الصناعة والزراعة، حيث تبنت الدولة نموذج اقتصادى يرتكز على توجيه عجلة الإنتاج، وتخطيط التنمية، لا سيما فى هذين القطاعين، وكان ذلك جزءًا من مشروع قومى يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى والتنمية الشاملة. واتسمت هذه الفترة بسيطرة الدولة على أدوات الإنتاج، وتوسيع دور القطاع العام بصورة كبيرة على حساب الخاص.
ثم جاءت نكسة 1967 لتغير الكثير من الفكر والتطبيق الاقتصادي، وبدأ نموذج الاقتصاد الموجه يتآكل تدريجيًا بعد حرب أكتوبر 1973، حيث اتجهت الدولة نحو نموذج الانفتاح الاقتصادي، الذى كان أساسه هو توسيع دور القطاع الخاص على حساب القطاع العام، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، والانخراط فى الأسواق العالمية، وتقليص دور الدولة فى توجيه النشاط الاقتصادى بصفة عامة. وفى العقود التالية، خاصة خلال الثمانينيات والتسعينيات، اتبعت مصر توصيات المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى عبر حزم من الإصلاحات التى ركّزت على التحرير الاقتصادي، والخصخصة، وتقليص حجم القطاع العام.
وعلى الرغم من أن هذه التحولات قد نجحت أحياناً فى تحقيق معدلات نمو معقولة، وخصوصا فى السنوات الأولى من الألفية الحالية، ولكن بسبب التحديات الاقتصادية الهيكلية المتراكمة فى الاقتصاد لم يشعر المواطن العادى بعوائد النمو، وكان أبرز هذه التحديات، ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم معدلات الفقر، واتساع الفجوة بين الفئات الاجتماعية نتيجة لانتشار الفساد الإدارى وغياب العدالة فى توزيع الموارد.
وكان من أبرز المشكلات الهيكلية فى الاقتصاد منظومة الدعم المشوهة والتى لعبت دورًا سلبيًا فى تفاقم الأوضاع، فالدعم هو فى الأصل وسيلة لتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل، ولكن تطبيقه بصورة عينية على بعض السلع الأساسية، خصوصًا الخبز والطاقة، أسفر عن نتائج كارثية. فبدلًا من أن يصل الدعم إلى الفئات التى تستحقه، استفادت منه فئات أخرى ميسورة الحال، بل وتم استغلاله أيضاً من قبل بعض الفئات فى أنشطة غير قانونية كالتجارة فى السلع المدعومة للتربح وتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما أدى إلى زيادة أعباء الموازنة العامة وإضعاف قدرة الدولة على توجيه الإنفاق العام نحو مجالات ترتبط بتحقيق التنمية المستدامة مثل التعليم والصحة.
أما عن أهم التحديات والمشاكل الهيكلية المتراكمة والمتداخلة فى الاقتصاد المصرى قبل 2011 فكان أهمها اعتماد الاقتصاد المصرى بشكل أساسى على مصادر ريعية غير منتجة فى توليد الدخل القومى وتوفير العملة الصعبة مثل إيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، مما جعل الاقتصاد هشًا ومعرّضًا للاهتزاز عند حدوث أى صدمات خارجية، وهو ما حدث بالفعل فى 2020 عندما تعرض العالم لجائحة كورونا وآثارها الاقتصادية المدمرة. والمشكلة الثانية كانت فى ضعف منظومة الإنتاج، سواء فى القطاع الصناعى أو الزراعي، فى ظل غياب تنوع اقتصادى يخلق فرص عمل حقيقية ويؤدى إلى التشغيل والتصدير ويرفع من معدلات الإنتاج المحلي. وبسبب مشكلة ضعف الإنتاج فقد حدث عجز مزمن فى الميزان التجاري، بسبب الاستيراد الكثيف لتغطية احتياجات المجتمع وذلك على حساب الإنتاج المحلي، ما ساهم فى تآكل الاحتياطى النقدي. كما أدى ذلك إلى ارتفاع الدين العام المحلى والخارجي، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على الموازنة العامة للدولة والحدّ من قدرتها على الإنفاق التنموى فى قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة. المشكلة الثالثة كانت فى تردّى الأداء الإدارى وانتشار الفساد فى القطاع الحكومي، حيث ظل هذا القطاع غير قادر على تنفيذ سياسات إصلاح حقيقية طوال أكثر من خمسين عاماً، وهو ما أدى إلى اتساع رقعة القطاع غير الرسمى دون القدرة على تنظيمه أو دمجه فى الاقتصاد الرسمي، وهو ما زاد من أعباء الأسرة المصرية. أما المشكلة الرابعة فكانت فى التآكل المستمر فى حجم الطبقة الوسطى نتيجة التضخم وتدنى الأجور الحقيقية، وهو ما فاقم من معدلات الفقر.
خلال هذه الفترة ارتفعت حدة المطالب الفئوية من مختلف القطاعات المهنية والاجتماعية والتى رأت فى هذه الظروف فرصة سانحة للضغط على الحكومة من أجل تحسين أوضاعها، بغض النظر عن قدراتها المالية أو أولويات المرحلة. وقد زاد من تفاقم الأزمة أن الجهاز الإدارى للدولة، الذى كان يعانى أصلًا من الترهل الشديد، شهد توسعًا كبيرًا ليصل عدد العاملين فيه إلى ما يزيد على 7 ملايين موظف. فى المقابل، كانت التقديرات الموضوعية تشير إلى أن ما تحتاجه الإدارة العامة فعليًا لا يتجاوز مليون موظف، وهو ما ضاعف من حجم الإنفاق الحكومى على الأجور والمزايا دون عائد إنتاجى حقيقى.
وصاحب هذه الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة تراجع دور القطاع الخاص بشكل حاد، وهو القطاع الذى كان يُعوّل عليه فى دعم النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، وهذا التراجع كان أسبابه الرئيسية هى عدم الاستقرار الأمنى والسياسى التى سادت البلاد، وعدم وضوح الرؤية السياسية، وهو ما جعل المناخ الاستثمارى فى مجمله غير جاذب، بل وطارد للاستثمار أيضاً، ودفع المستثمرين المحليين والأجانب إلى عدم المخاطرة وقتها حتى لو اضطروا إلى الخروج من السوق المصري، وبالفعل خرج معظمهم لأسواق دول أخرى تاركاً الدولة المصرية وحدها تقود الاقتصاد من أجل استمرار عجلة الإنتاج.
إن تراكم كل هذه العوامل، الاقتصادية منها والأمنية والسياسية، أدى إلى أن يكون الاقتصاد المصرى بحلول عام 2014 عبئًا مثقلًا بالأزمات المتراكمة التى تحتاج إلى إصلاح جذرى وليس مجرد حلول مؤقتة غير جذرية تعودت عليها الحكومات المتعاقبة قبل 2011. وقد أدركت القيادة السياسية، منذ توليها زمام الأمور فى 2014، خطورة هذا الوضع وتعقيداته، فانطلقت فى تبنى برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بالتوازى مع خوض معركة شرسة ضد الإرهاب لإعادة الأمن والاستقرار، وبدء مسيرة إعادة بناء الدولة من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تحديث البنية التحتية، وخلق فرص عمل، وتحفيز الاقتصاد، ووضع مصر على مسار التنمية المستدامة.
2016 وطريق الإصلاح الاقتصادى
فى ظل هذه التعقيدات فى المشهد السياسى والأمنى والاقتصادى خلال السنوات التالية يناير 2011 ثورة يونيو 2013، كانت الدولة المصرية أمام واقع مرير وتحديات جسيمة، وهو ما فرض ضرورة تبنى رؤية استراتيجية شاملة لإعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار. ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى 2014، بادرت القيادة السياسية إلى وضع خطة تنموية طويلة المدى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، منطلقة من إيمان راسخ بأن تجاوز الأزمات المزمنة والمشاكل الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى يتطلب معالجة جذرية لها وليس إجراءات أو مسكنات مؤقتة. وفى هذا الإطار تم إطلاق «رؤية مصر 2030»، التى أُعلن عنها الرئيس رسميًا فى فبراير 2016، باعتبارها الإطار الحاكم لاستراتيجية التنمية المستدامة فى البلاد. وقد ركزت رؤية القيادة السياسية على أبعاد التنمية الثلاثة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، مؤكدة أن تحقيق نمو اقتصادى حقيقى ومستدام لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية والتعامل مع المشكلات البيئية وجاءت خطة التنمية المستدامة 2030 فى وقت كانت فيه المؤشرات الاقتصادية تنذر بالخطر. فقد أدت الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة إلى ارتفاعات غير مسبوقة فى معدلات التضخم، وانخفاض شديد فى قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب تدهور ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار، وتراجع الإنتاج المحلي، فضلًا عن انسحاب القطاع الخاص من أداء دوره الحيوى فى دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وهو ما اضطر الدولة إلى التدخل لتحمّل تبعات الاختلالات الهيكلية التى تفاقمت بفعل تلك الاضطرابات. فقامت الدولة بتنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى فى عدة قطاعات على رأسها قطاع التشييد والبناء وذلك لعدة أسباب منها ملء الفراغ الذى تركه القطاع الخاص فى استيعاب العمالة وتخفيض حجم البطالة، وأيضا لتهيئة بيئة استثمارية مناسبة، فلا يمكن الحديث عن استثمارات مع وجود بنية تحتية متهالكة أو غير مناسبة للتطورات الحديثة فى بيئة الأعمال، والتى أصبح جزء كبير منها يحتاج إلى بنية تحتية رقمية على أعلى مستوي.
ومن منطلق إدراك الدولة لصعوبة الوضع الاقتصادى وخطورته، بدأت الحكومة فى التشاور مع صندوق النقد الدولي، بهدف وضع برنامج إصلاحى شامل يستهدف تحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى والتعامل مع التشوهات الهيكلية العميقة. وقد تُوِّجت هذه الجهود بتوقيع اتفاق رسمى مع صندوق النقد الدولى فى عام 2016، تم بموجبه إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالي، الذى تضمن مجموعة من الإجراءات والسياسات الصعبة، تم تنفيذها على مراحل زمنية مدروسة بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة المالية. وكان أحد أهم المحاور التى تناولها البرنامج إصلاح منظومة الدعم، إذ تم الانتقال التدريجى من نظام الدعم العيني، الذى عانى لسنوات من سوء التوزيع والهدر، إلى نظام الدعم النقدى بشكل جزئى وهو النظام الأكثر كفاءة وعدالة، وذلك من خلال برامج حماية اجتماعية موجهة مثل «تكافل وكرامة».
كما شمل البرنامج إصلاحات نقدية ومالية كبري، أبرزها تحرير سعر الصرف، وتحرير أسعار الطاقة تدريجيًا، وإدخال ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح بيئة الأعمال. وقد ساهمت هذه الإصلاحات فى احتواء التضخم، وتحقيق استقرار نسبى فى سعر العملة، وتحسين مؤشرات الموازنة العامة، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى على المستويين المحلى والدولي. فقد بدأت نتائج هذه الإصلاحات تظهر تدريجيًا اعتبارًا من عام 2017، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى من نحو 4 ٪ إلى أكثر من 5.5 ٪، ووصل احتياطى النقد الأجنبى إلى أعلى مستوياته فى تاريخ البلاد، وانخفضت معدلات البطالة إلى أقل من 9 ٪، بعد أن كانت تفوق ذلك بكثير فى أعقاب 2011. كما شهدت معدلات التضخم انخفاضًا ملحوظًا، وتراجعت مستويات الدين العام تدريجيًا، ما أسهم فى تحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتنشيط حركة التجارة، إلى جانب تعافى قطاع السياحة الذى يعد ركيزة مهمة للدخل القومي، وأصبحت مصر فى عام 2019 أكثر الدول الإفريقية فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكبر دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى الفترة من 2016-2019 هو قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود خلال أزمة جائحة كورونا فى عام 2020، وهى الأزمة التى تسببت فى تراجع اقتصادى عالمى غير مسبوق. فعلى الرغم من تداعيات الجائحة، استطاعت مصر أن تحقق معدلات نمو إيجابية فى وقت سجلت فيه دول كبرى مثل الصين والولايات المتحدة نموًا سلبيًا. وهذا الأداء المتميز خلال كارثة عالمية كان سببه الرئيسى هو الأسس القوية التى أرساها برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتى وفرت أرضية صلبة مكنت الدولة من امتصاص هذه الصدمة العالمية الكبيرة.
وبالرغم من أن آثار الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها بوضوح منذ 2017 وحتى أواخر عام 2019، إلا أن مسيرة التعافى لم تكن محصنة من التأثيرات الخارجية بسبب الاختلالات الهيكلية المتراكمة عبر سنين طويلة والتى أدت إلى أن يكون الاقتصاد المصرى هو اقتصاد استهلاكى وليس انتاجيا، يعتمد فى سد احتياجاته الأساسية على الاستيراد وليس الإنتاج المحلي، حيث جاءت جائحة كورونا فى نهاية 2019، لتليها مباشرة صراعات جيوسياسية واضطرابات اقتصادية عالمية مثل الحرب فى أوكرانيا فى 2022 وفى غزة فى 2023، وهى الصراعات التى أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، مما شكّل تحديات قوية عطلت مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى بدأت فى 2016.
آثار الصدمات العالمية
وقد بدأت التحديات الجديدة مع تفشى جائحة كوفيد-19 فى نهايات عام 2019، والتى شكّلت نقطة تحول عالمية، حيث أدت إلى شلل شبه كامل فى سلاسل الإمداد العالمية نتيجة توقف الإنتاج وحركة التجارة الدولية، وهو ما خلق حالة من الركود الاقتصادى الشامل لم يشهدها العالم منذ أزمة الكساد الكبير عام 1929 ومع توقف الطلب والاستهلاك فى مرحلة الإغلاق، ثم عودتهما المفاجئة بقوة فى عام 2021، ارتفعت الأسعار عالميًا بوتيرة غير مسبوقة، مما تسبب فى ظاهرة الركود التضخمي، أى تزامن ارتفاع الأسعار مع تباطؤ الإنتاج والنمو. وقد انعكست هذه الظاهرة بقوة على الدول المستوردة للسلع والخدمات.
ثم جاءت الأزمة الروسية – الأوكرانية فى بداية عام 2022 لتضيف بعدًا أكثر خطورة، حيث تعتمد مصر بشكل رئيسى على استيراد الحبوب، وخصوصاً القمح، من روسيا وأوكرانيا، وفى 7 أكتوبر 2023، تفجرت الأزمة الناتجة عن الحرب فى غزة، فدخلت مصر فى دوامة جديدة من التحديات ذات الطابع السياسى والاقتصادى والإنساني. فقد تأثرت حركة السياحة مجددًا، كما تراجعت إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر الدخل القومي، بسبب الهجمات الحوثية على السفن فى البحر الأحمر، ما أدى إلى انخفاض تجاوز 70 ٪ فى الإيرادات السنوية للقناة خلال عام 2024، ومثّل ضربة قاسية للاحتياطى من العملات الأجنبية.
وفى ظل هذه الأزمات المتلاحقة، استقبلت مصر أعدادًا ضخمة من اللاجئين والنازحين قُدرت بأكثر من 10 ملايين وافد، قادمين من دول عربية تعانى من صراعات وحروب ممتدة مثل سوريا، واليمن، وليبيا، والسودان. وعلى الرغم من الأعباء الاقتصادية الهائلة المترتبة على استضافة هذا العدد الكبير، فإن الدولة التزمت بموقفها الإنسانى والقومي، واستمرت فى استقبال من لجأ إليها طلبًا للأمان، رافضة التخلى عن مسؤوليتها الأخلاقية تجاه الأشقاء العرب. وقد أدى هذا الضغط السكانى المفاجئ إلى زيادة غير مسبوقة فى الطلب على السلع والخدمات، مما ساهم فى تضخيم الأزمة التضخمية القائمة بالفعل، حيث تجاوزت معدلات التضخم فى بعض الأشهر حاجز 40 ٪، مما أسفر عن ارتفاع جنونى فى أسعار المواد الأساسية، وتآكل متسارع فى مستوى المعيشة.
وعلى مستوى السياسة النقدية، شهدت السوق المصرية اضطرابات حادة فى سعر صرف الجنيه، حيث تجاوز الدولار حاجز الـ50 جنيهًا فى السوق الرسمية، بينما قفز إلى نحو 70 جنيهًا فى السوق الموازية خلال عام 2023، مما استدعى تدخلات متكررة من البنك المركزى لضبط السوق، من خلال أربع عمليات تعويم للعملة المحلية بين 2022 و2024، إلى جانب رفع أسعار الفائدة بأكثر من 1600 نقطة أساس، فى محاولة للسيطرة على التضخم وكبح جماح المضاربات فى العملة، مع جذب رءوس الأموال الأجنبية للداخل. ومع استقرار الوضع الاقتصادى فى 2025 وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا، بدأ البنك المركزى فى خفض سعر الفائدة لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وفى ظل هذا السياق شديد الصعوبة، جاءت بوادر انفراجة فى عام 2024 عبر توقيع اتفاق استثمارى ضخم بين مصر والإمارات لتطوير منطقة «رأس الحكمة» الساحلية، بقيمة بلغت 35 مليار دولار، وهو ما أسهم فى تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، وتحسين الاحتياطى النقدي، ووقف تدهور العملة، ومنع انزلاق الدولة إلى هاوية أزمة اقتصادية أعمق. كما ترافقت هذه الخطوة مع مراجعة لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، أسفرت عن رفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما عزز من مصداقية الدولة لدى المؤسسات المالية العالمية. ونتيجة لهذه الإجراءات، تم تحسين التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسات مثل «فيتش»، التى رفعت تصنيف مصر من B- إليB، فى مؤشر إيجابى على تحسن القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، رغم استمرار التحديات البنيوية. وقد انعكس هذا التحسن فى التصنيف على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وانخفاض نسبى فى تكلفة الاقتراض الخارجي، ما ساعد على تخفيف أعباء خدمة الدين العام، ودعم الجنيه المصري، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الدولة.
لكن ورغم كل هذه الإجراءات الإيجابية، فإنها تظل استجابات مؤقتة لأزمات طارئة، ونحتاج بشدة إلى العودة لمسيرة الإصلاح التى أوقفتها الصدمات الخارجية، مسيرة إصلاح بغرض علاج التشوهات العميقة والمتراكمة فى بنية الاقتصاد.
نحو خارطة طريق للإصلاح
لا يمكن تصور مستقبل مصر الاقتصادى الذى نتمناه جميعا ما لم يتم تبنى إصلاحات اقتصادية جذرية وشاملة، تنفذ برؤية منهجية لا تكتفى بمعالجة الأعراض الظاهرة للأزمة، بل تنفذ إلى أعماق الأسباب البنيوية التى أنتجتها. والقيادة السياسية الحكيمة والواعية تعى ذلك منذ البداية، ولولا تداعيات الأزمات العالمية وتأثيراتها السلبية على برامج الإصلاح التى تبنتها القيادة السياسية لكانت مصر الآن فى وضع اقتصادى متميز للغاية.
ومن مناقشاتى مع خبراء وأساتذة الاقتصاد، يتضح لى جلياً أن هناك اقتراحات متميزة لبناء نموذج اقتصادى مصرى جديد، أكثر تنوعًا، وأقوى قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وأعمق ارتباطًا بالتنمية العادلة والمتوازنة. وهذا النموذج يعتمد على عدة محاور أهمها ثلاثة محاور أساسية، وأول هذه المحاور هو تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع مصادر الدخل، حيث إن أحد أبرز أوجه ضعف الاقتصاد المصرى خلال العقود الماضية هو الاعتماد المفرط على مصادر دخل ريعية، مثل قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، وهى قطاعات شديدة التأثر .
أما المحور الثانى فى النموذج المقترح فهو العمل على إصلاح مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، فالاستثمار، سواء المحلى أو الأجنبي، هو قاطرة النمو، وبدونه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية أو مستدامة. ولذا، فإن إعادة بناء ثقة المستثمرين يجب أن تنطلق من إصلاح شامل لمناخ الأعمال.
ويجب التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تسهيل الحصول على التمويل، وإنشاء حاضنات أعمال، وبرامج تدريب على ريادة الأعمال، فريادة الأعمال هى قاطرة التنمية فى العديد من الدول المتقدمة. كذلك يجب العمل على تطوير البنية التحتية الذكية بالتركيز على النقل الحديث، والموانئ المتخصصة، واللوجستيات، وربطها بتكنولوجيا الأجيال الحديثة، وخدمات الإنترنت فائق السرعة، لتهيئة بنية تحتية رقمية جاذبة للاستثمارات التكنولوجية والصناعية. وكذلك من المهم إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وفق معايير دولية، مثل منطقة قناة السويس والتى بدأت فيها الحكومة المصرية منذ سنوات.
أما المحور الثالث فهو استمرار العمل على إصلاح النظام المالى والمصرفى وتعزيز الشمول المالى فى إطار مسيرة الإصلاح الذى بدأته مصر فى 2016، فلا يمكن للاقتصاد أن يتطور دون نظام مالى قوى قادر على توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية، وتوفير أدوات تمويل متنوعة، مع ضمان الشفافية والاستقرار. فلابد أن نستمر فى سياسة تعزيز استقلالية البنك المركزي، وتحديث أدواته الرقابية، لضمان استقرار السياسات النقدية، والحد من التضخم، والتحكم فى أسعار الصرف. ولابد أن تتضمن سياسات البنك المركزى تحفيز البنوك على تمويل المشروعات التنموية، لا سيما الصناعية والزراعية، وتوفير ائتمان ميسر للمشروعات الصغيرة، والتقليل من استخدام موارد البنوك فى تمويل الدين العام.
إن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري، رغم تعقيداتها وتشابك أسبابها، ليست مستعصية على الحل وذلك بسبب وجود إرادة سياسية واضحة ورشيدة، وخطوات إيجابية تم اتخاذها بالفعل من 2016 وعطلتها صدمات عالمية خارجة عن إرادة الجميع، وهناك رؤية اقتصادية بعيدة المدي، وإدارة رشيدة للموارد تقوم على الشفافية، والحوكمة الرشيدة، والمساءلة. والمطلوب اليوم هو تقديم بناء نموذج اقتصادى شامل يقوم على الإنتاج والتوزيع العادل للثروة، ويضمن التكامل بين أدوار الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. فاللحظة الراهنة هى فرصة ذهبية لعلاج المشاكل الاقتصادية المتراكمة، ووضع الاقتصاد المصرى على مسار جديد أقل عرضه للصدمات الخارجية وأكثر استدامة وتوازنًا.