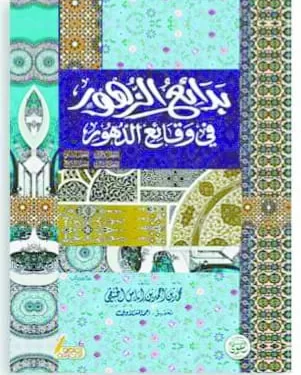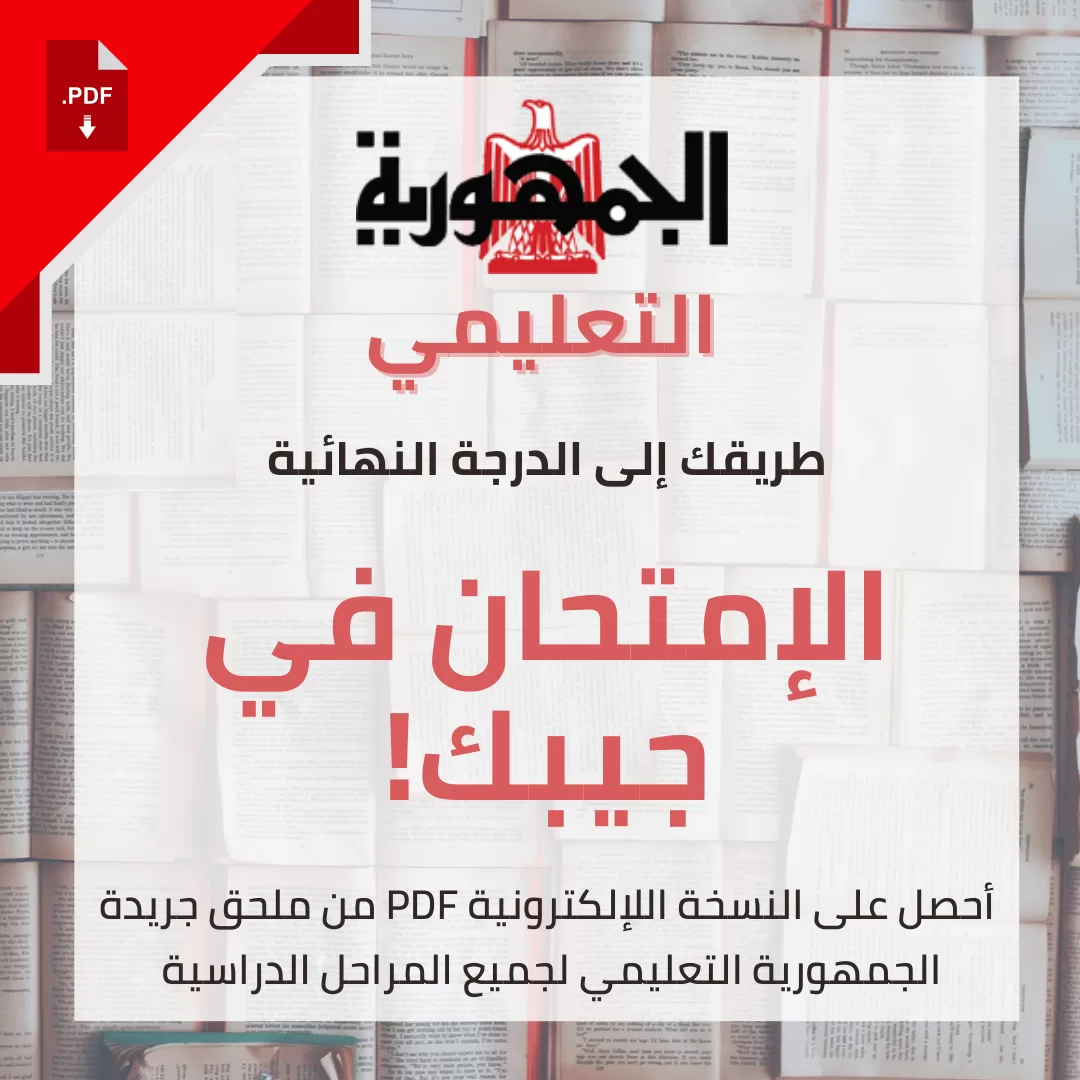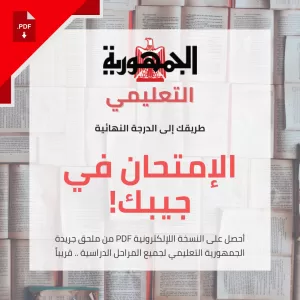التداخل المعرفى أصبح سمة أساسية من سمات الثقافة والآداب والعلوم والفنون المعاصرة، فمثلا علم الكيمياء حقل علمى له خصوصيته، وفى نفس الوقت له حضوره فى علوم الطب والصيدلة والصناعة وترميم الآثار، وقد نقل الناقد «جريماس» مصطلح التشاكل من علم الكيمياء اٍلى ميدان النقد الأدبي، والدراسات الثقافية هي: حقل معرفى يتداخل مع معارف متعددة منها الآداب والفنون والسياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع، وتهتم الدراسات الثقافية بفهم الظاهرة الثقافية (قيم، أفكار، مفاهيم، معتقدات، سلوك( كمنتج اجتماعى معقَّد، وتدرس آليات اٍنتاج الثقافة وتوزيعها واستهلاكها، وتراعى عند تحليلها للظاهرة الثقافية العِرْق والجنس والمعتقد والبيئة والتاريخ .
أهم ما يمكنه أن تقدمه الدراسات الثقافية للأدب كما أدَّعى هو دراسة وتفكيك المقولات الخاصة بتلقِّى الأدب وتوزيعه واستهلاكه كمنتج ثقافى شديد الخصوصية، وبخصوص أشير بشكل موجز اٍلى استعانتى بالدراسات الثقافية مع النقد والتنظير الأدبى فى كتابى «الشعر العامى العربى وقضايا الشكل والتدوين والمصطلح» عند تحليلى لمقولة: «أن شعر العامية يًكتب خصيصا للبسطاء وأن شعر الفصحى للنخبة»، وقد تتبعت جذور تلك المقولة فى تاريخ الأدب والثقافة فلم أجد لها وجودا فى كتابات شعراء ومًنظرى الشعر العامى فى العصور الوسطى منذ نشأة الزجل فى الأندلس والمواليا فى العراق، فلم ترد هذه المقولة فى مقدمة ديوان ابن قزمان القرطبي، أو فى كتاب «العاطل الحالى والمُرْخص الغالي» لصفّى الدين الحٍلى أو «رفع الشك والمين فى تحرير الفنين» لعبدالوهاب بن يوسف البنواني، وغيرهم، ولو أن الشعر العامى كان مُوَجَّها للبسطاء دون المثقفين ما كان كبار مؤرخى العصور الوسطى أمثال: ابن اٍياس فى موسوعة «بدائع الزهور فى وقائع الدهور»، وابن تغرى بردى فى موسوعة «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» أوردا فى مؤلفاتهم نصوصا من الشعر العامى مثلما أوردا نصوصا من شعر الفصحى كشواهد على الوقائع التاريخية.
اٍن مقولة ارتباط شعر العامية بالبسطاء وارتباط شعر الفصحى بالمثقفين تم تداولها منذ بداية القرن العشرين الميلادى كما أزعم، لأسباب تتعلق بالاحتفاء بالعربية الفصحى فى مواجهة لغة وثقافة المحتل، وأن الفصحى لغة خاصة باٍنتاج آدب وثقافة الصفوة، وبخصوص العامية والفصحى فاٍن اللغة العربية وفقا لعالم اللغة «شارل فيرجسون» لغة مزدوجة لها شقان: شق فصيح رسمى مًقعّد، وشق دراج عامـــي، ولا صراع بينهما، وفى فترة المَدّ القومى واليسارى فى الخمسينات والستينات تلونت مقولة أن شعر العامية هو فن البسطاء بصبغة أيدلوجية تخص التعبير عن «البروليتاريا» طبقات الشعب الكادحة، اٍذا هذه المقولة بالأساس لا تتعلق باٍنتاج الأدب بل بتلقيه تلقِ مًنحاز لخدمة فكرة أو أيدولجيا خارج الآدب، وكل نص أو نوع أدبى ينتج شروط تلقيه من داخله وليس من خارجه، وشعر العامية مثله مثل أى فن يُوجَّه للجميع وليس لفئة اجتماعية محددة.
ومثال آخر: اتهام الشعر فى العصر المملوكى فى بعض الدراسات الأدبية بأنه شعر ضعيف المستوي، ومن هذه الدراسات كتاب «مطالعات فى الشعر المملوكى والعثماني» للناقد بكرى أمين شيخ الذى استشهد فيه بنماذج من الشعر الهندسى على أنها من العصر المملوكي، دون أن يذكر اسم شاعر واحد من أسماء الشعراء الذين كتبوا تلك النماذج؟، أو يذكر المرجع الذى نقل منه تلك الشواهد الشعرية؟، وأزعم أن اتهام شعر العصر المملوكى بهذا الصفات دون تدقيق يعبّر عن القراءة الاسقاطية الموجودة فى الثقافة العربية كظاهرة ثقافية، فالقراءة الاسقاطية لا تتعلق بالشعر فقط بل بكل مناحى الثقافة وهي: أن يكون لدى الإنسان رأى مسبق عن ظاهرة حياتية أو ثقافية، ويسعى إلى إسقاط رأيه على الظاهرة وإثبات صحته بكل الطرق.
محمد على عزب ــ شاعر وناقد