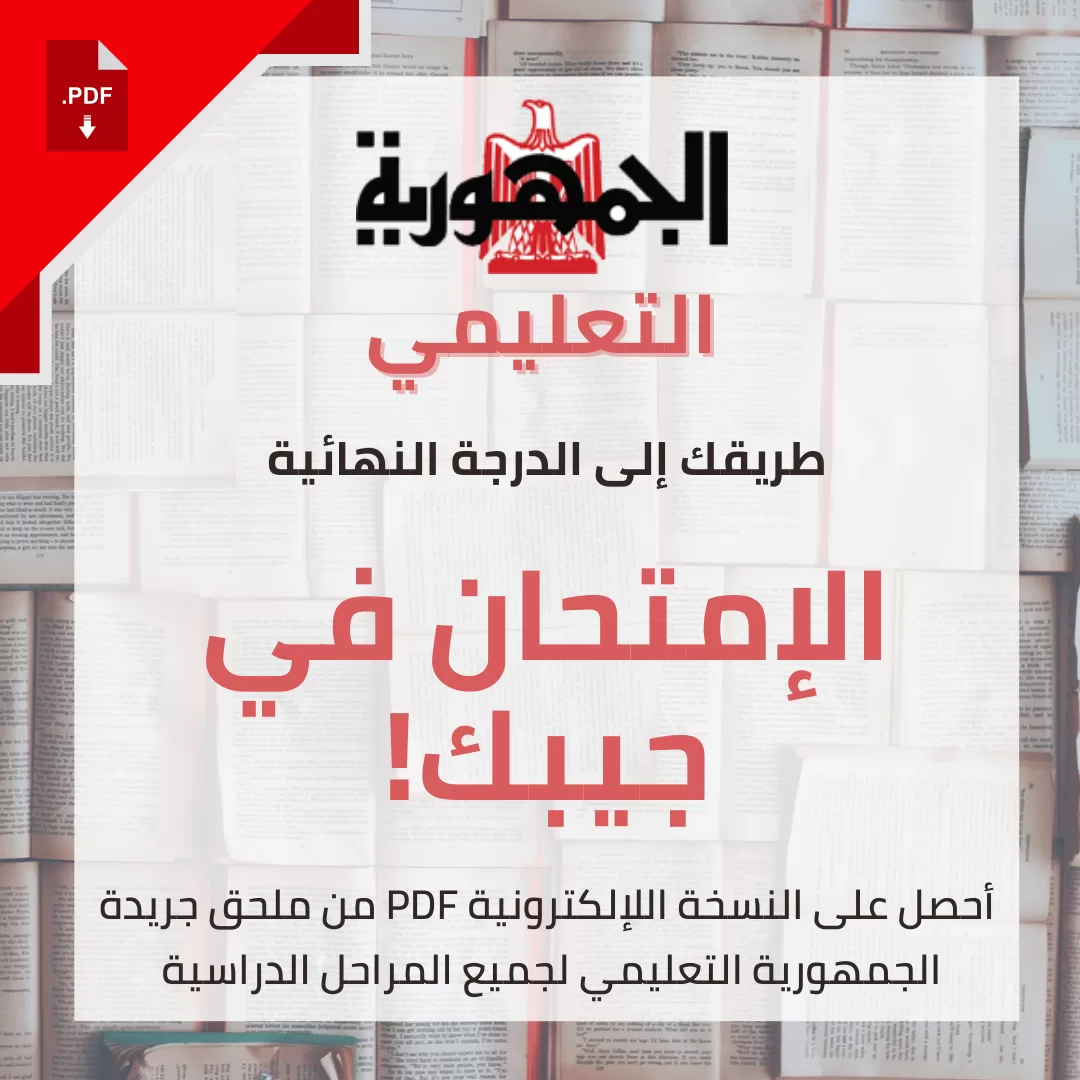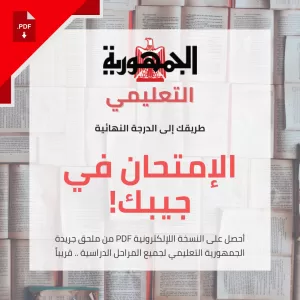قراءة في كتاب محمد وردي
د. فادي سعيد دقناش
كاتب وباحث في علم الاجتماع.
يُعتبر العلَّامة الشيخ عبد الله بن بيَّه مِن الشخصيات الفاعلة أو المؤثّرة في القرن الحادي والعشرين، في عصر شهد تحولات كبيرة على المستوى الفكري والمعرفي هو عصر “الحداثة السائلة”؛ بتوصيف زيجمونت باومان، الذي تحطَّمت على أعتابه الأيديولوجيات القديمة، وحلَّت مكانها مفاهيم عولمية جديدة؛ بتداعياتها الثقافية المختلفة، التي فرضت على الثقافات الهشة خطاباً جديداً بوجهين متناقضين: إمَّا التطرف والانعزال بحجة الخصوصية الثقافية والمؤامرة الكونية؟ وإمَّا الاعتدال والتلاقي والحوار. وقد شكَّلت أفكار الشيخ ابن بيه الوجه الثاني الأصدق تعبيراً عن الفطرة السوية والأكثر تسامحاً وانفتاحا على الثقافات الأخرى.
بِثقة الحكيم المُستشرف للمستقبل اختار الشيخ ابن بيَّه وجهته في المكان والزمان المناسبين، وسط عالم عربي/إسلامي يسوده العنف والاحتراب الذي تغذّيه خطابات تقليدية وتأويلات قروسطية لا تتناسب مع مستجدات العصر وتعقيدات الواقع، حيث رأى ضرورة الحوار وتعزيز المشتركات الإنسانية؛ كمدخل عقلاني للتخفيف من غلواء الاختلاف وإرساء ثقافة التسامح، وترسيخ خطاب السلم المستدام، ليس في المجتمعات العربية والإسلامية فحسب، وإنما على امتداد البيت الإنساني. ولذلك جاء تأسيس “منتدى أبوظبي للسلم” في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ كشرفة دولية جامعة لقيم الخير والجمال؛ باعتبارها جسوراً تصل بين الثقافات بأحسن ما يكون عليه التواصل بين مختلف المجتمعات البشرية في زمن “العولمة”.
“الأنسنة والتجديد في خطاب بن بيّه”
“الأنسنة والتجديد في خطاب الشيخ عبد الله بن بيَّه”، كتاب محمد وردي، الذي صدر حديثاً عن دار “هماليل” للنشر، أبو ظبي، 2023، الذي يجيب من خلاله على أسئلة إشكالية، طالما كانت محور جدل بين عدد كبير من العلماء والمفكرين، مفككاً خطاب الشيخ ابن بيَّه، ومحللاً، ومفسراً للمعنى وللدلالات المفاهيمية الفكرية والفلسفية الكامنة في الخطاب، المؤسس على ما يمكن أن نسميه “استراتيجيا القوة الناعمة”، التي طالما اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في تعاطيها البراغماتي مع الآخر، الذي أسَّسه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه).
يختزل العنوان بما يتضمنه من كلمتَيْن دالَّتين؛ جوهر خطاب الشيخ ابن بيَّه: “الأنسنة” و”التجديد”. تأتي “الأنسنة” بالمقام الأول، وهي من فعل “أنسن” المشتق من كلمة “إنسان”، ذلك “العاقل” الذي ميّزه الله بالعقل عن غيره من المخلوقات، فتأتي الأنسنة كنتاج لعقل الإنسان ورديفة للحداثة أو المدنيَّة التي تُفضي أيضاً إلى الكلمة الثانية: “التجديد” أي تجديد في الفكر والعمل. وبمقدار ما يتمدَّن المرء يستطيع أن يستشرف إنسانيَّته بشكل أفضل، حيث لا خيار أمام البشرية إلاَّ بأنسنتها أو بعقلنتها عن طريق الحوار والاستماع والنقاش، الذي يجب أن ينعكس على الخطاب الإنساني المعاصر من خلال التجديد في الخطاب الديني كما المعرفي، في عصر تراكمت فيه المفاهيم الفكرية والفلسفية العقيمة.
يتوزَّع الكتاب على تمهيد وفصلين: الأنسنة ومخرجات القلق الكوني، والتجديد في خطاب العلامة الشيخ عبد الله بن بيَّه، يتناول فيها الباحث أبرز المفاهيم الدالة في الخطاب، وفق مقاربة دلالية فلسفية.

يعتبر الباحث بأنَّ المُنطلق الأساس للأنسنة التي ينشدها الشيخ ابن بيَّه تكمن في إعادة النظر بالطبيعة البشرية، التي تختزلها ثلاثية “القوى الحيوية”: الغريزة والعقل والروح: فالغريزة هي “الوسيلة التي تغذي حياة الجماعة حياة الذوات المنفصلة”، والعقل هو ما “يتمايز به الإنسان عن غيره من الكائنات”، والروح هي الترياق لاستخفاف العقل إذا جنح للقسوة والكراهية لأنَّها تجعل الغلبة للعواطف التي تنبع من الغريزة فتعقلنها”. وهكذا فإنَّ “الغريزة تهبنا القوة، والعقل يهبنا وسيلة توجيه القوة إلى الغايات المنشودة، وهكذا تغدو الروح بما تمثّله من عواطف ومشاعر تختزل الأنسنة من حيث أنَّها ملكة الفكر والخيال التي تجعل منَّا بشراً وتجعل حياتنا أكثر ثراءً، فتساهم في صناعة “الخير العام” المتمثّل بالإبداع الأخلاقي والخير الإنساني وثقافة الخير والجمال.
المفاهيم الدالة للخطاب:
يرى الكاتب أنَّ خطاب الشيخ ابن بيَّه يُحيل إلى “فلسفة إنسانية كونيَّة متكاملة تتركَّز على منزلقات الحداثة أو مشكلات الإنسان المعاصر في الشرق كما في الغرب”، وهذه المشكلات لا يُمكن حلّها إلاَّ من خلال “أعمال تستهدف نفع الأنفس البشرية” وهي “حقوق الله” أو قواعد “الخير العام” التي تعتبر مقصداً شرعياً، ومقتضىً أخلاقياً منتظمة في خمس: الحرية، تعزيز السلم المجتمعي، العمران، الإغناء والتكريم، الإشراك في المجال العام.
يتوقف الكاتب عند جملة من المفاهيم الدالة في الخطاب، منها:
– “الخير العام”:
حيث يرى الكاتب أنه “ينتظم في إطار الواجب الأخلاقي المغروس في أعماق الذات الإنسانية”، ويتقاطع مع هذا المفهوم عدد من القيم؛ كالإنصاف والعدل والرحمة والحكمة والمصلحة والتضامن والإحسان والإيثار. ويعتبر أن “ثلاثية القوى الحيوية”، هي “رادارات هادية” تهدي الإنسان إلى ما نسمّيه “الواجب أو الضمير الأخلاقي”، بثَّها الله في الإنسان، وبفضلها يستطيع أن يقترب من غاية وجوده أو غاية خلقه، ومن شروطها أن تكون متكاملة متناغمة ومتناسقة فهي من يحكم جوهر الأخلاق ويؤسس للخير العام، وسماتها التجدد الدائم.
– “الأخوة الإنسانية”:
تشغل هذه الفكرة حيزاً كبيراً في البنية الدلالية الناظمة لخطاب الشيخ وهي تختزل جوهر مشروعه الفكري “المؤنسن”، ويتلاقى هذا المفهوم مع مفهوم “الخير العام” الذي “يتجاوز المبدأ المحايد لحقوق الإنسان، المتمثّل في المساواة وعدم الاكتراث بالاختلاف إلى الإيجابية في التعامل التي تُشعِر الآخر بدفء المحبَّة والأخوة”. ويعرض الكاتب مرتكزات خطاب الشيخ ابن بيَّة في تأسيس ما يسميها “عمارة الأخوة الإنسانية” من خلال وثيقة “ميثاق حلف فضول عالمي جديد… يقوم على تشجيع مبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة ويدعو إلى التسامح والسلم والرحمة والتضامن. هذا المفهوم يتجاوز الحداثة المعاصرة على مستوى البعد القانوني البارد في موضوعة الحقوق، وذلك من خلال ربط مفهوم “الأخوة الإنسانية” بقيم الفضيلة، التي تبث فيها دفء المحبة وترتقي بالتضامن إلى مرتبة الإيثار. وهي ترتقي من ضيق الهويات الثقافية والولاءات الفئوية المتحيزة إلى فضاء الانتماء الإنساني الفسيح.
– “الكرامة الإنسانية”:
تجري مقاربتها في الخطاب من خلال وعي أكمل وفهم أشمل بالذات الإنسانية المتفردة، ما يجعل تأسيسها في النفوس قبل النصوص أمراً ممكناً، فـ”كرامة الإنسان قبل كرامة الإيمان… والإسلام يقدّم بسمو الكرامة الإنسانية بوصفها أول مشترك إنساني، لأنَّ البشر جميعاً على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم ومعتقداتهم كرَّمهم الله عز وجل بنفحة من روحه في أبيهم آدم عليه السلام”.
– “المشتركات الإنسانية”:
تشرعن في الخطاب العلاقة مع الآخر، انطلاقاً من حقيقة الجذع المشترك للبشرية (أبينا آدم)، فأصل البشرية واحد. مع إمكانية تطوير هذه المشتركات ورفدها بأبعاد كونية جديدة تجمع ما بين القوانين وفلسفة الحق والعدلة وبين قيم الإنصاف والتضامن وبذل السلام للعالم والمواطنة الشاملة التي تؤسس عمارة الأخوة الإنسانية على مداميك المحبة.
يشدّد الخطاب على ضرورة مراجعة المنظومات القيمية الكونية باعتبار أنَّ “الأخلاق الدينية ما تزال قادرة على أن ترشد العالم إلى سبيل الخلاص من مشكلاته العضالية، من خلال تقديم مفهوم جديد للإنسانية، يتجاوز المبدأ المحايد لحقوق الإنسان إلى إيجابية قيم المحبة والأخوة”. وهذا يُحيلنا إلى عدد من المفاهيم التي تتلاقى مع خطاب يُحاكي روح العصرنة حاضراً ومستقبلاً يُمكن تلخيصها بأربع قيم: بذل السلام للعالم، الإنصاف، التضامن، المواطنة الشاملة.
– “مفهوم السلم”:
يعتبر الشيخ ابن بيَّه أنَّ “السلام فريضة باعتباره مقصداً أعلى من مقاصد الشريعة الإسلامية، وأنَّ له أولوية على الحقوق الثابتة والمزعومة، المادية أو المعنوية، الفردية أو الجماعية، الدينية أو الدنيوية، لأنَّ لا ثبوت ولا ثبات إلا بها ففقدان السلم هو فقدان لكل الحقوق بما فيها الحق في الوجود… والسلم مبدأ أساسي في الإسلام وكافة الأديان”.
ويذهب الخطاب ببعد إنساني عقلاني إيماني إلى تقديم السلم على مقاصد الشريعة لأنَّ غاية المقاصد لا تتحقق إلا في إطار السلم الذي يؤسس لثقافة “الحب والسعادة” باعتبارهما خاصتين تنفرد بهما الذات الإنسانية، وتختزلان جوهر “الأنسنة” حيث تقدمان الروح بأجمل تجلياتها وأنبل دلالاتها. فمفهوم السلم كغاية ذاتية سامية تتكامل مع مفهوم “الخير العام” ومع مفهوم “الأخوة الإنسانية” التي يقتضي غرسها في النفوس قبل النصوص. وهو بدوره يقتضي تأسيس ثقافة “الخير العام” في النفوس دون تغافلها في النصوص في إطار الواجب الأخلاقي. ويحيل “بذل السلام للعالم” في الخطاب إلى ضرورة إنسانية حاقة تحفظ الأصل وتصون الجوهر في “الخيرية الوجودية الأولى” القائمة في أصل الخلق من دون سببيات ضرورية أو حتميات طبيعية.
– “الإنصاف”:
هو ضرورة ذاتية فردية منطقية عقلانية، خلاصتها أن تعامل الناس جميعاً كما تحب أن يعاملوك، بغض النظر عن هُويّاتهم الثقافية. فهو – من حيث المبدأ – حق معنوي ينطلق من فهم إسلامي عميق، ولكنَّه يتماهى مع فلسفة الأنسنة بكل قيمها المعاصرة. مقياسه الذات الإنسانية وتطلّعاتها وفهمها لقيم الخير والجمال، وبذلك هو واجب شرعي يرقى إلى مستوى “فرض عين لا كفاية” قبل أن يكون واجباً قانونياً تشرعنه الدساتير الوضعية.
– “التضامن”:
عملاً بفلسفة الخير العام تأتي فلسفة التضامن التي تجمع حولها “روح ركاب السفينة”. فالتضامن “هو مرتبة عليا تسمو على مجرّد الاعتراف إلى التعارف. وبه يتم تجاوز ضيق الذوات إلى فسحة المشترك، وينتقل من تشرذم الأقليات والهويات الحرجة إلى وحدة الأكثرية الجامعة، مجتمع الإنسانية الكبرى” أي الإنسانية المتآخية في السراء والضراء.
– “المواطنة”:
يعتبر الخطاب أنَّ أهم مقومين من مقومات المواطنة هما: الاعتراف بالتعددية وإقرار الحرية الدينية، والثاني المساواة في الواجبات والحقوق حيث “ترتقي المواطنة إلى المؤاخاة وتنتقل من الوجود المشترك إلى الوجدان المشترك”، وهي بذلك شراكة تعاقدية كما لخصَّتها “صحيفة المدينة” مع التأكيد على الاسترشاد بالتجارب الإنسانية قديمها وحديثها دون تجاهل ما خلصت إليه الحداثة الفكرية.
ويركز الخطاب على مفهوم “المواطنة الشاملة” وإمكانية الارتقاء به من الإطار القانوني والحقوقي إلى الفضاء الإنساني الأرحب، الذي يُمكن أن يتأسس على “الوجدان المشترك”، أي على القيم الكونية المشتركة أو الجامعة في الوعي البشري. والخطاب يريد من مفاهيم قيم “المواطنة الشاملة” أن تقوم على أسس عملية، وأن تترسخ في الوجدان الكوني لأنها تجمع بين مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات وبين قيم الحرية المسؤولة وقبول التعددية واحترام الاختلافات بكل المعاني الحقوقية والقانونية وبين المثل الأخلاقية والدينية.
– “التجديد”:
يؤشر الخطاب إلى منحاه الفلسفي الإسلامي العقلاني المعاصر، الذي ينهل من معين الدين والموروث الثقافي العربي/الإسلامي والإنساني عموماً، من هنا وجوب تنزيل المعارف الجديدة في التأويل والاستنباط؛ بالتناسب الذي يقتضي التجديد في التفسير ومسالك التأويل والتطبيق على العصر الحاضر، مع الاحتفاظ لكل عصر بلغته وبيئته الزمانية والمكانية باعتبارها مفاهيم وقيم متجددة بالتوازي مع تجدد إشكالات الواقع وتنوّع البيئات الثقافية. والخطاب رغم منطلقاته التأسيسة الإسلامية لا يغفل ما انتهت إليه الحداثة الإنسانية الراهنة ويتماهى معها بعقلانية إسلامية رشيدة من حيث التكامل والبناء عليها معرفياً. إنَّ بنية التجديد في الخطب لا تقطع مع موروثه الثقافي، وبخاصة الديني منه، بقدر ما تبني عليه إضافته الجديدة أو تشييد عمارته الإبداعية في التجديد، القائمة على محاكاة الواقع في كل ما يستجدّ بحياة الناس واستشراف المستقبل أو المتوقع على مدى تحولات الأمكنة وتقلبات الأزمنة باعتبار ما تحيلنا إليه مقاصد الشريعة انطلاقاً من كونها تعبيراً عن حاجات الإنسان في العاجلة والآجلة.
– “التسامح”:
يقدّم الخطاب أهم مرتكزات قيم ومجالات ثقافة التسامح في الإسلام، ومنها الرؤية الإسلامية من الآخر “فالآخر ليس عدواً ولا خصماً”، وموقف الإسلام من الاختلاف والتعددية “انطلاقاً من أنَّ التعدد سنَّة كونية وفطرة بشرية”، ومكانة الحوار في الإسلام، “فالحوار واجب ديني وضرورة إنسانية وهو مفتاح لحلّ مشاكل العالم”.
لا يسعنا في هذه القراءة تناول سائر المفاهيم الدالة للخطاب التي قام بتشريحها وتحليلها محمد وردي، كالتفاعل البناء، والطاعة، والجهاد، والديمقراطية، والحداثة، والعولمة، وعلاقات المواطنة بالحداثة وبالمجتمع والدولة.. إلاَّ أنَّ مضمونها يدعو إلى ضرورة التفكُّر والتفكير بطريقة جديدة لا تتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل تتواءَم معها وتتعاطى مع مشكلات العصر المختلفة المتشابكة وفق منطق فقه الواقع والتوقُّع.
الخطاب فلسفي ديني يُحاكي الخصوصية الإسلامية دون التقوقع داخلها بل يتجاوزها إلى بعدها الكوني الشمولي باعتبار أنَّ القيم الإسلامية هي “قيم كونية إنسانية تتلاقى مع الجميع ضمن مقاربة قائمة على المواءمة أو التلاؤم باليسر لا بالعسر، والتقريب للأذهان بالمنطق والبيان والبرهان والعنوان”.