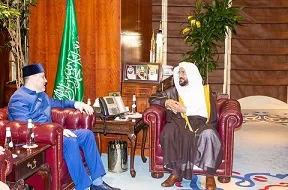جمال فتحي
- ما يجمع بين الأديان والثقافات من قيم مشتركة أكبر بكثير مما يفرقها
- مقولة التجديد في خطاب الشيخ عبدالله بن بيه تؤسس لمفهوم التنوير العقلاني
لقد قطع الإنسان على الأرض شوطا كبيرا من الصراع مع الطبيعة ثم مع ذاته ومع الآخر قبل أن نصل إلى اللحظة الزمنية التي نحياها بتعقيداتها كافة وبتداخلاتها المربكة وربما لعبت الأديان والمعتقدات في بعض المراحل دورا في نشر السلام والمحبة بين الناس لكنها تحولت في تلقي بعضهم وتفسيراتهم لنصوصها وتعاطيهم مع أوامرها ونواهيها إلى ساحة واسعة للتكفير ومن ثم الكراهية والإقصاء والقتل أحيانا،
لكننا على ذلك لا ننكر أدوار فلاسفة وعلماء و فقهاء مجددين مدوا أياديهم للبشرية في لحظات حالكة الظلمة بفهم وحكمة محاولين جذبها إلى مسارات أكثر سلما و أمنا وطمأنينة بعيدا عن مسارات الشقاء والتعاسة والصراع ومن هؤلاء الشيخ المحفوظ بن بيه الذي قدم خلال العقود الماضية جهدا علميا وبحثيا يليق بالتأمل والنظر..
حيث قدم مجموعة كبيرة من الأطروحات والأبحاث المعتبرة وسار على درب تجديد الخطاب الديني خطوات واسعة وعلى عدة مستويات راعى فيها ” واجب الوقت” ونظر بشجاعة في ” فقه الواقع” و” فقه المقاصد” ناظرا إلى نصوص الشريعة باعتبارها نصا واحدا في نظامها الاستدلالي والاستنباطي، وبدا أن رؤية الشيخ بن بيه في مجمل أطروحاته يجمعها نسق واضح ومتكامل وأنه اتخذ مسارا لافتا ومنهجا معتبرا في ذلك،..
على أن رؤية التجديد في خطاب العلامة الشيخ عبدالله بن بيه مؤسسة على رؤية حداثية مائزة وعميقة، ونظر فلسفي شامل في مراميه التنويرية، وشحنة روحية وإيمانية وقادة؛ سواء من حيث الدواعي أو المقتضيات، أو من حيث الأدوات العلمية (المنهجية في البحث) التي تجمع بين معطيات المعرفة في العلوم الإنسانية والعلوم القرآنية والمأثور النبوي الشريف على السواء. وهو فهم مؤسس على الموروث الإنساني في خلاصة التجربة البشرية، وعلى “مرجعيات الكتاب والسنة وأصول الفقه؛ باعتبار أن أصول الفقه، تمثل أفضل منهج اخترعته العبقرية الإسلامية للتعامل مع نصوص الوحي الإلهي، وهو منهج خالد؛ لأنه يستمد ينبوعه ومادته من نصوص الوحي ومن لغة القرآن المحفوظ. وأصول الفقه التي تعتبر مركزية في علوم الشرع؛ لما لها من وظيفة إنتاج الأدوات المثمرة للأحكام من جهة، وضبط النظر والفكر من جهة أخرى، أصبحت الوسيط بين الوحي والفهم البشري، والوسيلة للتعامل معه” *(1)

“فتاوى فكرية”.. أولى إشراقات التجديد
ولعل أولى إشراقات التجديد في ذلك الخطاب تعود إلى كتاب “فتاوى فكرية” عام 2000م، التي عالج فيها موضوعات بعيدة عن مباحث الشريعة الإسلامية، وتندرج في إطار “واجب الوقت”، ولا تزال حتى اللحظة الراهنة تثير العديد من السجالات على مستويات متباينة ومختلفة؛ بل مستحكمة الاختلاف، مثل موضوعات “الحوار”، و”الديمقراطية”، و”حقوقِ الإنسان”، و”القيمِ الإنسانية المشتركة”، وغيرها من الموضوعات السجالية.
أما التجديد في أصول الفقه في الخطاب لدى شيخنا المحفوظ بن بيه، فيمكن رصده في بحوث مثل: “إثارات تجديدية”، و”تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع”، و”صناعة الفتوى وفقه الأقليات”، و”أمالي الدلالات”، و”مشاهد من المقاصد”، حيث يقدم في النص الأخير (حسب بعض القراءات) أربع وثلاثين مسألة من مسائل الأصول التي يُستنجد فيها بالمقاصد، أبرزها الشيخ الجليل لأول مرة، أي لم يسبقه إليها – في ظني- أحد من علماء المسلمين.
وأود هنا في هذه المقالة التوقف أمام ملامح التجديد من خلال خمسة تجليات، حسبما ينص الخطاب:
1- تجديد ما اندثر من الأحكام في حياة الناس.
2- تجديد بإنشاء طرائق من شأنها أن تخدم الدين، ومنه (من سنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة) حسب تفسير الإمام النووي، لا بمعنى أحيا كما فسره بعضهم. قلت (أي الشيخ يقول): ولا يبعد أن يكون إنشاء منهج في أصول الفقه من هذه السنن.
3- تجديد يتعلق بمستجدات حياة الناس؛ لوصلها بحبال الدين، وإيجاد الحلول المناسبة، واقتراح الصيغ الملائمة (…).
4- تجديد هو اختراع وإبداع وليس ابتداعاً، ومنه ما أحدث السلف من تدوين الدواوين والجمع للتراويح وإحداث السجون. وقد يكون منه ما أحدث الخلف من الاجتماع للذكر وتلاوة القرآن على خلاف حققناه في كتابنا “مشاهد من المقاصد”. ومن هذه القبيل الأحكام التي يحدثها الحكام لزجر أهل الفساد، والنظم التي يقترحها العصر لدرء الاستبداد.
5- وأخيراً؛ وهذا محل جهد المجتهدين، واستنباط المستنبطين، تجديد يتعلق: بالاجتهاد في الأحكام إنشاءً في قضايا لم يسبق فيها نظر للعلماء. أو قضايا سبق فيها نظر للعلماء وظهر ما يعارضه؛ إما لضعف مستند الأول طبقاً للبرهان أو تغير زمان أو اجتهاد في كيفية تطبيق الأحكام، ويمكن اعتبار أصول الفقه الإطار الناظم له” *(2)
ما يعني أن الخطاب يُحكم ضبط موضوع التجديد على أربعة مستويات: تجديد فقه المقاصد، وتجديد يراعي “واجب الوقت”، وتجديد نقدي يختزل فاعلية الإنسان في التكليف. وتجديد إيماني على مستوى النظر بمستجدات الحياة أو ما يسمى “فقه الواقع”

وتتضمن عملية التجديد اثنتي عشرة خطوة:
نظرة شمولية تعتبر الشريعة كلها بمنزلة النص الواحد في نظام الاستدلال والاستنباط، عرض النصوص على اللغة، الجمع بين النصوص التي يوحي ظاهرها بالتعارض، الموازنة بين الجزئي والكلي، عرض الخطاب الآمر “التكليف” على بيئة التطبيق “خطاب الوضع”، مراجعة سياقات النصوص، اعتبار العلاقة بين الأوامر والنواهي ومنظومة المصالح والمفاسد، مراعاة التطور الزماني والواقع الإنساني، النظر في المآلات والعواقب، ملاحظة موارد الخطاب طبقاً للوظائف النبوية، استحضار البعد الإنساني والانتماء إلى الكون، استغلال الإمكان المتاح في الشريعة.
أما الجهد المائز في تجديد الخطاب فيظهر في تحقيق المناط، الذي هو في “بعض توجهاته تغليب لكلي قد يخفى؛ في مقابل جزئي قد يكون أكثر ظهوراً بالنسبة للمتعاطي، وقد يكون موازنة بين مصلحة ومفسدة أو بين مصلحتين أو مفسدتين، مما يوصف بـ” أخف الضررين” أو “أصلح المصلحتين”، أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. تلك الموازنات تدخل في تحقيق المناط. *(3)
(تفاوت الباحثين والعلاقة بالنصوص)
ولا شك أن كل ما فات يستدعي دراية وخبرة طويلة في الاستقراء والإحاطة بالنصوص ومعرفة عميقة باللغة. ولذلك يعتقد الشيخ ابن بيه “أن الخلاف بين أعضاء المجامع الفقهية في جملة من المسائل يرجع إلى تفاوت بين الباحثين في قضية التصور والتشخيص أكثر مما يرجع إلى اختلاف في فهم النصوص الفقهية. إذاً فالخلاف هو خلاف في علاقة المسألة بتلك النصوص؛ تبعا للزاوية التي ينظر إليها الفقيه من خلالها، أو اختلاف في شهادة وهو: أن يكون موضوع الحكم يحتمل حالين، فيفتي المفتي بناء على أحد الحالين مستبعداً الوصف الاخر، كما يقول البناني” *(4) ويعتبر الخطاب أن الواقع هو الأرضية بالتعبير المعاصر لتحقيق المناط. “والواقع هو الإنسان فرداً ومجتمعاً. ولهذا فإن المناط لا يتحقق إلا بالإنسان، ومن خلال الإنسان نفسه فهو المحقق الأول والأخير لأنه الفاعل والمحل.* (5) وبهذا يقطع الخطاب بحقيقة أن العناية بالإنسان إنما هي جوهر ومقصود الدين.
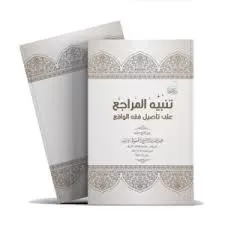
( منهجية التجديد)
تقوم منهجية التجديد في الخطاب “على تذليل جملة من العقبات، وإصلاح عدد من الأخلال التي تعترض تجديد الخطاب الإسلامي وترسيخ مفاهيم السلم:
الخلل الأول:
منهج الاجتزاء (بمعنى أن من يُفتي أو يقضي، لا يمكنه الاعتماد على أية واحدة أو حديث واحد دون الإلمام بالمتن القرآني والمأثور النبوي مجملاً. ذلك لأن) “نصوص الشريعة هي بمنزلة نص واحد في نظام الاستدلال والاستنباط، فمن لم يُحِطْ بها علماً ولم يجمع أطرافها، لم يسعه أن يفقه معانيها”.
الخلل الثاني:
فك الارتباط بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. خطاب الوضع، هو: “الأسباب والشروط والموانع والرخص والعزائم. وهو ناظم للعلاقة بين خطاب التكليف بأصنافه: طلبُ إيقاع، وطلبُ امتناع، وبين الواقع بسلاسته وإكراهاته. وبعبارة أخرى، خطاب الوضع هو البيئة الأصولية لإنزال الحكم، وهو الذي يحوط خطاب التكليف ويكلأه، ولهذا كان خطاب الوضع بالمرصاد لخطاب التكليف، ليُقيد إطلاقه، ويخصص عمومه، فقيام الأسباب لا يكفي دون انتفاء الموانع.”
الخلل الثالث:
فك الارتباط بين الأوامر والنواهي ومنظومة المصالح والمفاسد. (بمعنى أنه ليس من الصواب العمل بالأوامر والنواهي بعيداً عن جلب المصالح ودرء المفاسد. فالأوامر والنواهي هي “من جهة اللفظ متساوية في دلالة الاقتضاء”، ولكن لا يُعلم منها “التفرقة بين ما هو أمر وجوب أو ندب، وما هو منها تحريم أو كراهة، وإنْ عُلم منها بعض؛ فالأكثر منها غير معلوم”. وإنما يحصل ذلك “باتباع المعاني، والنظر في المصالح، وفي أي مرتبة تقع، بالاستقراء المعنوي)
الخلل الرابع:
إغفال السياق وأثره على مفهوم الجهاد، (الشرعي بوجهيه، الدفع، وهو رد العدوان، والطلب، وهو حماية حرية الاعتقاد، وهو بوجهيه أدنى مرتبة، بمقتضى المأثور النبوي بعد غزوة تبوك: “عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر”، أي جهاد هوى النفس والسلوك والعمل).
الخلل الخامس:
التصور التاريخي السطحي. (بمعنى أن اجتزاء التاريخ ليس صائباً ولا يحقق غاية مؤكدة؛ باعتبار أن “فترات التاريخ ما بين ظهور وضمور، عنفوان وشيخوخة، انتصارات وانكسارات”، وبالتالي لا يمكن التعامل معها باجتزاء)
وبهذا المعنى يقدم الخطاب سردية تركيبية جديدة في الدين تقومُ على ثلاثة مقومات، اثنتان منهما قرآنيتان، والثالثة من يقينيات الشريعة بحسب علماء الأصول. الأولى: أن القيمة العليا في علاقة الله سبحانه الرحمن الرحيم ببني البشر هي قيمةُ الرحمة. وهذا ظاهرٌ وواضحٌ في مثل قوله تعالى: “ورحمتي وسِعت كلَّ شيء”.* (6)، والثانية: هي مقولة التعارف باعتباره الفلسفة القرآنية لعلائق البشر بعضهم ببعض؛ بمقتضى قوله تعالى “يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتَعارفوا” *(7)
والثالثة: هي مقاصد الشريعة، لتكتملُ بها منظومةُ السردية الدينية الجديدة أو التركيبية. وهي سردية غير مسبوقة على مستوى التجديد الذي يحاكي العصرنة بكل قيمها العقلانية والإيمانية، الأخلاقية والدينية، في مختلف مراحل التجديد على مر التاريخ الإسلامي، التي يرصد دارسيها ست موجاتٍ في التفكير الديني من أجل الملاءمة والتطوير، ولكن مراميها التحديثية لم تكتمل، من حيث قدرتها على تشكيل نسق عقلاني/إيماني علمي أصولي فاعل في الوعي الإسلامي عموماً. وهو ما أدى إلى ما نشاهده من تداعيات على مستوى العنف والتطرف والإرهاب والاحتراب مع العالم وترتيب تلك الموجات كالتالي:
.
“الموجة الأولى: حركة الجامعة الإسلامية، التي أطلقها السلطان عبد الحميد، وكانت لها بعض الأفكار والممارسات المعتبرة تحديثية.
الموجة الثانية: حركة محمد عبده وتياره التي تصدت لمشكلات وتحديات مثل العلاقة بالغرب، والقول بالدولة المدنية.
الموجة الثالثة: أثارها المفكر الهندي المسلم محمد إقبال في كتابه “تجديد التفكير الديني في الإسلام”.
الموجة الرابعة: حاولت التوفيق بين الموروث الفقهي الإسلامي والقوانين المدنية الغربية.
الموجة الخامسة: يمثلها مشروع المفكر الجزائري مالك بن نبي لفهم مسألة الحضارة والنهوض والانحطاط في العالم الإسلامي.
الموجة السادسة: أما الموجة السادسة فتتعلق بدور فكرة مقاصد الشريعة في البناء والتجديد. وبحسب مفكري وفقهاء المقاصد، وفي مقدمتهم اليوم العلاّمة ابن بيه أننا نملك قيماً ومبادئ نحن مُلزَمون بها في ديننا، ومُلتزمون بها تجاه العالم، ومن ضمن توجهاتها التفكير بعلاقاتٍ أُخرى بالعالم غير علاقات الحرب والصراع، تقوم على التعاون والمشاركة والتصالح بين المسلمين وبين بني البشر ومع نظام العالم”، كما يقول الدكتور رضوان السيد. * (8) وهذا ما يقوم به ويقدمه بصور متجددة خطاب الشيخ عبدالله بن بيه حسبما نعتقد.
وفي الختام يمكن القول: إن مقولة التجديد في خطاب العلامة الشيخ عبدالله بن بيه تتأسس من خلال التأصيل والتأويل ومنظومتي التعليل والتنزيل الصحيح؛ بضوء الاستقراء الثقافي (عربياً وإسلامياً وعالمياً)، والمقارنة بين خصائص أو خلاصات التجارب الثقافية التاريخية، وبخاصة ثقافات الأديان عموماً، وما اكتسبه أتباعها من خبرات وراكموه من تجارب. وبذلك يبت الخطاب بالبرهان الساطع والدليل القاطع: أن ما يجمع بين الأديان والثقافات من قيم مشتركة أكبر بكثير مما يفرقها، وأنها ستكون أكثر فاعلية وأنفع خيرياً حين تتعاون وتتكافل بالمعروف. وهي مقولة عقلانية وازنة تسد ذرائع الغلو والتطرف وتقطع الطريق على الفكر المنحرف أو العقل المأزوم، وفي الوقت عينه تؤسس لمفهوم التنوير العقلاني؛ بمقتضى التجديد في الخطاب الإسلامي على كل مستويات الأنسنة عربياً وإسلامياً وعالميا.
***
هوامش:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– راجع: “إثارات تجديدية في حقول الأصول”، ص 159- 160 / لـ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه”
2– المرجع السابق، ص14- 15
3– نفسه، ص -119
4- نفسه، ص- 120- 121
5– نفسه، ص -122-123.
6- الأعراف: 165
7– الحجرات: 13
8- راجع : رضوان السيد، “نحو حلف فضولٍ جديد – سلامة الأديان والأوطان وسلام العالم” منشور في مجلة “تعايش” العدد الرابع، 2019